كاتب الموضوع :
atik akhouaji
المنتدى :
سلاسل روايات مصرية للجيب

أعتذر للأحبة عن التأخير في نشر تتمة المقالات ، لالتزاماتي في العمل التي لا تترك لي فارغا من الوقت
كبيرا، وها أنا ذا، أنشر البقية من المقالات وكلي أمل في أن أكون عند حسن ظن الجميع
الفصل السابع
* على الرغم من انشغالي بثلاث سلاسل، واظبت على مواعيد العيادة.
* أصبحت مدير العيادة، وغضب بعض الزملاء، لأنني اتخذت مساراً بعيداً عن الطب.
* أيقظني والدي فى الصباح الباكر، ليخبرني أن المطبعة قد احترقت.
مع منتصف عام 1986م، ولدت السلسلة الجديدة (زهور)، وكانت سلسلة رومانسية، ذات طابع خاص جداً… وأيضاً كان السبب هو المترجمات..
ففي تلك الفترة، كانت هناك روايات عاطفية منتشرة في الأسواق، وتحقق رواجاً كبيراً بين الشباب، على الرغم من أنها مترجمات، تحوي كل ما يخالف تقاليدنا، وديننا ومجتمعنا..
لذا، فقد راودتني فكرة إصدار سلسلة نظيفة، تتحدث عن الحب كعاطفة سامية، وشعور لا ينبغي تلويثه، ولقد شاركني الأستاذ حمدي رغبتي هذه، حتى أنه بعد أن قرأ القصة الأولى، وضع شعاراً للسلسلة يقول: إنها" السلسلة الرومانسية الوحيدة، التى لا يخجل الأب أو الأم من وجودها بالمنزل" وكان الشعار جديداً، وقوياً، ومعبراً للغاية..
وفي الصفحة الأولى، من القصة الأولى، كتبت إهداءً لابنى (شريف)، الذى توافق مولده مع مولدها..
كل هذا وأرقام التوزيع ما زالت أدنى من المتوقَّع، والأستاذ حمدي يصرّ على المواصلة، وأنا أواصل الكتابة بالفعل، فى ثلاث سلاسل في آن واحد، وكلمة صديقي رجل الأمن ترن في أذني.. "النجاح مابيجيش بالسهل"..
وفى طنطا، استقريت مع زوجتي (ميرفت)، وابني شريف، وبدأت رحلة أسبوعية، منها إلى القاهرة، التى أصبحت مقر عملى الوحيد، بعد استقالتي من وزارة الصحة، واكتفائي بالعمل في عيادة تخصصية صغيرة، تملكها جمعية (السيد البدوى) فى طنطا..
وعلى الرغم من انشغالي بكتابة ثلاث سلاسل قصصية، ظللت شديد الالتزام بمواعيد العيادة، ومتابعة المرضى، وممارسة الجزء المتبقي لي من مهنة الطب، حتى فوجئت ذات يوم باللواء (الخولى)، المشرف على العيادة، يطلب مني مقابلته، ثم يسند إلىَّ إدارتها كاملة..
وكانت مفاجأة بالنسبة لي بالفعل، إذ أنني، وعلى الرغم من ممارستي للمهنة، كنت أبعد زملائى عن فكرة الإدارة،بحكم طبيعتي وضيق وقتي، ولقد حاولت شرح هذا الأمر له، إلا أنه استخدم معي أسلوب الأبوة، الذى أضعف أمامه دوما، حتى استسلمت للفكرة، وخضعت للأمر، وأصبحت بالفعل مدير العيادة التخصصية، التابعة للجمعية..
ولولا خشيتي من إساءة تفسير كلماتي، لشرحت كم المشكلات والمتاعب، التى واجهتني فى ذلك المنصب، على الرغم من بساطة المكان، ومدى ما فوجئت به، من إهدار وسوء استغلال المال العام، وبلطجة بعض القائمين عليه، حتى أن الأمر احتاج إلى معركة عنيفة تحت السطح؛ لإعادة توزيع الأدوار، والسيطرة على الموقف، مما جعلني أتساءل، لو أن هذا ما يحدث فى عيادة صغيرة، تتبع جمعية خيرية، لا تستهدف الربح، فما الذي يحدث فى الشركات والمصالح الكبرى؟!..
وعلى الجانب الآخر، ظهرت حالة من الغضب عند بعض الزملاء، الذين رأوا أنهم أحق مني بالمنصب، الذى لا يساوي منطوقه فعلياً، باعتبار أننى قد اتخذت الكتابة والأدب مساراً لحياتي ومستقبلي، فى حين ليس لديهم سوى الطب وحده..
وكان علىَّ أن أتجاوز كل هذا، وأتفادى الصدام المباشر إلى أقصى حد، حتى لا أخسر بعض زملاء المهنة، أو أصدقاء الدراسة..
ولكن العيادة بدأت، ولأوَّل مرة فى تحقيق أرباح ضئيلة، كانت كافية لنقلها إلى خانة الربح، بجنيهات لا تشبع ولا تغنى، ولكنها جعلت أعضاء الجمعية يتصوَّرون أنني إداري ناجح، مما دفعهم إلى إسناد منصب المدير، في عيادة أخرى بالشارع نفسه، إلىَّ أيضاً..
وأصبحت المشكلة مشكلتين..
كل هذا وأنا أواصل القراءة بمنتهى النهم، في كتب الجاسوسية والمخابرات، على أمل بلوغ مرحلة، يرضى فيها أستاذي وصديقي رجل الأمن، عما أكتبه اقتباساً من شخصيته المبهرة..
وقبل أن أبلغ مرحلة الإرهاق واليأس التامين، علمت من أحد أصدقائى في المؤسسة، أن أرقام التوزيع آخذة فى الارتفاع، على نحو مرض، وأن الروايات قد بدأت تلقى رواجاً مفاجئاً..
وكان أسعد خبر سمعته، في حياتي كلها، حتى أنني كدت أطير فرحاً، وأنا أنقله إلى صديقى رجل الأمن، الذى ابتسم بهدوئه المعهود، وقال: "كل شئ وله أوان.. ده درس عشان تتعلم الصبر.."..
وتعلمت الصبر، وذقت طعم النجاح لأول مرة، ونمت قرير العين، ليوقظنى أبى فى الصباح الباكر، وهو يحمل جريدة الأهرام، متسائلاً: "المؤسسة اللى بتطبع كتبك اسمها إيه"..
لم أفهم سر السؤال المبكر هذا، ولكنني أجبته وأنا أفرك عينيَّ إرهاقاً، فوضع الصفحة الأولى للأهرام أمامي، وهو يقول فى ضيق: "مكتوب إنها اتحرقت إمبارح"..
وسقط قلبي بين قدميَ..
بمنتهى العنف.
الفصل الثامن
* سبعون فى المائة من خسائر الحريق، كانت بسبب أخطاء رجال الإطفاء..
* أحد الزملاء، أخبرني أن احتراق المطبعة يعني فشلي في عالم الأدب..
* قاومت حالة الإحباط داخلي، بوضع أسس سلسلة رابعة..
في أول قطار، هرعت إلى القاهرة، وكل ذرة في كياني ترتجف، من فرط هلعي لما أصاب المطبعة، وراح عقلي يحاول رسم صورة تخيلية لما حدث، كما لو أنني لا أطيق صبراً على الوصول إلى المطبعة، ورؤية الأمور بعينىّي..
وعندما وصلت، بدا لي الأمر عجيباً إلى حد ما؛ فباستثناء بعض اللون الأسود، في الطابق العلوي، لم يكن هناك أثر خارجي لحجم الحريق، الذي تحدثت عنه الصحف، والذي بلغت خسائره، كما ذكرت جريدة الأهرام حوالي مليون جنيه، وهو مبلغ باهظ، بمقاييس تلك الفترة، من منتصف ثمانينات القرن العشرين..
والتقيت بالأستاذ حمدي، وهو يتفقد الخسائر بنفسه، وطلبت منه أن يعتبرني جندياً تحت قيادته، حتى يتم تجاوز الأزمة، ولكن العجيب أنه كان متماسكاً، ويتمتع بروح معنوية ممتازة، على الرغم مما حدث، وخاصة عندما اصطحبني إلى مكتبه، وراح يروى لي ما حدث، على نحو جعلني أدرك حتمية ألا أثق فى أية أخبار تنشرها الصحف الحكومية.. حتى أخبار الحوادث..
فوفقاً لما نشر، هرعت إلى المكان، فور اندلاع الحريق تسع عربات إطفاء، وبصحبتها العميد فلان، واللواء علان، والعقيد ترتان، وأن الجميع بذلوا كل جهدهم، للسيطرة على الحريق، ولكن رواية كل شهود العيان كانت مختلفة..
ومضحكة..
ومؤسفة أيضاً..
فلا أحد رأى أى لواء، أو عميد، أو عقيد، بل عدد من صغار الضباط، والجنود المرتبكين، الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع مطبعة تحترق، وتحوي ورق طباعة وأحبار، من كل صنف ولون..
فعربات الإطفاء التسع حضرت بالفعل، ولكن ليس للتعاون، وإنما لأن ثمان منها كانت مضخاتها معطلة، أو كانت خالية من المياه (شوف التهريج)، لذا فقد تولت العربة التاسعة وحدها إطفاء الحريق..
حاول أن تحسب معي الوقت الذى استغرقه وصول كل عربة، وكشف عدم صلاحيتها، لتعرف كم بلغت الخسائر.. بسبب رجال الإطفاء!!..
الأسوأ أن السيارة التاسعة استخدمت خراطيم المياه، لإطفاء حريق المطبعة، مما أدى إلى إتلاف أطنان من الورق، فى الطوابق التي لم تكن تتعرض للحريق، وكأن رجال الإطفاء لم يدرسوا أو يمتلكوا وسيلة أخرى، مثل البودرة أو المواد الرغوية للإطفاء!!..
وبحساب الخسائر، تبين أن ما يزيد عن السبعين فى المائة منها كان بسبب أخطاء شرطة الإطفاء، فى التعامل مع الموقف!!..
الشئ الوحيد الذي أحزن الأستاذ حمدي حينذاك، كان احتراق ماكينة طباعة جديدة، لم تستخدم بعد، تم استيرادها خصيصاً لروايات مصرية للجيب، إذ كانت من الجيل الأول، القادر على طباعة الألوان الأربعة في مرحلة واحدة..
ولقد جرت عدة محاولات لإصلاح تلك الماكينة، إلا أنها باءت كلها بالفشل..
المهم أن المطبعة قد تجاوزت مأساة الحريق..
أما أنا، فلم يكن من السهل أن أتجاوزه أبداً..
ففي الليلة نفسها، وعندما ذهبت إلى تلك العيادة الخيرية، فوجئت بموقف لم أهضمه قط حتى يومنا هذا!!..
فعلى نحو مباغت، زارني زميل لم تكن تربطني به صداقة ما، ليخبرني بكل تشف أنه قد قرأ خبر احتراق المطبعة، ثم ارتدى ثوب الناصح، وهو يؤكِّد لي خطأ قراري بالاستقالة، واحتراف الأدب، وأنه من الصواب، بعد احتراق المطبعة، أن أقر بالخطأ، وأسعى للتراجع عن استقالتي، باعتبار أن مغامرتي قد فشلت، واحترقت، وأثبتت أنني شخص أحمق..
يومها استمعت إليه فى صمت، ودون تعليق واحد، وأنا أشعر نحوه بمزيج من الشفقة والمرارة، حتى انتهى من حديثه، فأخبرته أننى سأفكر فيما قال، مما جعله ينصرف مرتاحاً، وإن لم ينس أن يمنحني نظرة تشف أخيرة، قبل أن يغادر العيادة..
وخرجت من العيادة، بعد انتهاء ساعات العمل، وأنا أزمع التوجه لزيارة صديقي وأستاذي رجل الأمن، إلا أنني تراجعت عن هذا، على بُعد أمتار قليلة من منزله، عندما شعرت أنه من العار أن يراني، بكل ما يملأ نفسي. من حزن وإحباط، وعدت إلى منزلي، وجلست فى حجرة مكتبي، أعيد دراسة الموقف كله، وأستعيد كل كلمة سمعتها، وكل تناقض حدث، مع تفاؤل الأستاذ حمدى، وشماتة زميل الدراسة..
ثم فجأة، قفزت إلى ذهنى فكرة، لا تتناسب أبداً مع الموقف؛ فقد قرَّرت مقاومة حالة الإحباط داخلى، بوضع أسس سلسلة جديدة.
سلسلة مختلفة تمام الاختلاف.
الفصل التاسع
* أول مبلغ كبير أقبضه من رواياتي، سقط من سيارتي سهواً..
* أصبحت بالنسبة للقراء، أربع شخصيات مختلفة، مع تنوع إصداراتي..
* كنت أنشر خطابات تذمنى؛ ليتعلَّم القراء المعنى الحقيقي للديمقراطية.
حريق المطبعة، وموقف زميلي الشامت، جعلاني أشعر برغبة شديدة في التعبير عما يجول في نفسي على الورق، وفي أن تكون هناك مطبوعة، يمكنني أن أفرغ فيها مشاعري، وخواطري، وفلسفتي، وكل وسائل التعبير الأخرى، التى لا تنطوي تحت إحدى الخانات، التي تمثلها سلاسلي الثلاث، المخابرات والخيال العلمي، والرومانسية..
ففي أعماقي، كانت هناك كومة من الأفكار، تتشوق للخروج، في هيئة قصص قصيرة، ودراسات، وخواطر، وغيرها، لذا فقد جاءت السلسلة الجديدة، معبرة عن كل هذا، حتى أنني لم أجد لها عنواناً فى البداية، ثم لم ألبث، بعد أن أعيتني الحيرة، أن أطلقت عليها اسم (كوكتيل)..
ومع مولد (كوكتيل)، تفجَّرت داخلي طاقات لم أتصوَّر وجودها قط، ففيها كتبت كل ما يحلو لي، حتى أصبحت، وما زالت واحتي، التى أجد فيها راحتي واستقراري، وأخاطب عبرها القراء، أو أصدقاء الورق كما أسميهم، والتى وضعت لها سياسة خاصة جداً، منذ نهاية الثمانينات، وهى حتمية نشر رسائل القراء بمنتهى الديمقراطية والحياد، حتى أنني كنت أنشر رسائل تهاجمني، وتتهمني بأنني أسوأ كاتب فى الكون، أو بأن أعمالي أتفه من أن تقرأ، حتى يتعلم القارئ معنى الحرية والديمقراطية، وأنها ليست ديمقراطية المدح فحسب..
وعلى الرغم من أن توزيع (كوكتيل) لم يبلغ حداً يستحق الفخر فى حينها، إلا أن صدورها توافق مع زيادة مفاجئة فى أرقام توزيع السلاسل الأخرى، وفى دخلي السنوى بالتالى..
والمدهش أنني صرت بالنسبة للقراء أربعة شخصيات مختلفة، فبعضهم يعتبرنى كاتباً للخيال العلمي، والبعض الآخر يتابع روايات الجاسوسية، ويسألنى ما إذا كنت رجل مخابرات!.. أما البعض الثالث، وهو من الجنس اللطيف لحسن الحظ، فقد أصبح يتعامل معي باعتبارى رومانسياً، ولست مجرَّد كاتب لروايات رومانسية!..
ويبدو أنني أيضاً كنت أعتبر نفسي كذلك، إذ كنت أتحوَّل إلى شخصية أخرى، مع كل رواية أكتبها، وأعيشها حتى النخاع..
ومع نهاية فصل الصيف، بلغني من المؤسسة أجمل خبر سمعته، في حياتي كلها، وهو أن الروايات قد حققت رقماً قياسياً فى التوزيع، وأصبحت مطلوبة في كل أنحاء المعمورة، وأن هناك مبلغ ألفيناتي، ينتظرني في المطبعة..
ولأوَّل مرة في حياتي، سافرت إلى القاهرة بسيارتي، التي كنت أخشى قيادتها على الطرق السريعة، ووصلت إلى المطبعة وكلي لهفة، لمعرفة الرقم الذي سأحصل عليه، بعد نجاح التوزيع..
وفي قسم الحسابات، تم خصم كل المبالغ التى تقاضيتها خلال العام، ليتبقى لي في النهاية حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه تقريباً، كانت تعتبر مبلغاً كبيراً، بمقاييس تلك الفترة، ووضع رئيس الحسابات المبلغ فى مظروف، وسلمني إياه، وغادرت المؤسسة وأنا فى قمة السعادة..
وأمام الباب، استوقفني أحد عمال المطبعة، ليسألني عن بعض الأعراض المرضية التى يعانيها، ومع انشغالى بالحديث معه، وضعت المظروف على سقف السيارة، ثم نسيت هذا، واستقليت سيارتي، وانطلقت بها، عائداً إلى طنطا..
وبينما أعبر ميدان العباسية، تذكَّرت الأمر فجأة، فأصابنى الهلع، وتوقفت فى منتصف الطريق، وأوقفت المرور تماماً، وتجاهلت السباب واللعنات من حولي، وأنا أخرج لإلقاء نظرة على سقف السيارة، قبل أن أشعر بقبضة باردة كالثلج تعتصر صدري..
فلقد اختفى المظروف والنقود..
تماماً..
الفصل العاشر
* بلغت دقات قلبي ألف دقة في الدقيقة، عندما شاهدت مظروفاً، أمام هندسة عين شمس.
* أخبرت صديقي رجل الأمن بالقصة، فقال: إنه ينبغي أن يعلمنى هذا درساً.
* أيقظوني في الصباح، ليخبروني أن الناشر يبحث عني، بسبب خطأ فى حساب مستحقاتي.
لست أذكر أنني قد شعرت في حياتى كلها بالإحباط، مثلما شعرت به فى تلك اللحظة، التى كشفت فيها ضياع أول مبلغ (كاش) أقبضته من كتبى، فخلال السنوات التي مضت، منذ بدء تعاوني مع المؤسسة وحتى تلك اللحظات المحبطة، كنت أستهلك معظم الدخل في مصروفات المنزل، بعد أن استقلت من وزارة الصحة، وكنت قد حصلت على قرض من المؤسسة، لشراء أول سيارة في حياتي، وكل دخلي من الكتب كان يسدِّد التزاماتي، حتى أصبح هناك فائض لأول مرة..
وها أنذا أفقده بإهمال سخيف..
فى البداية، راودتني فكرة الاستسلام للقدر، والعودة إلى طنطا خالي الوفاض، إلا أن طبيعتي الرافضة للهزيمة والاستسلام، سرعان ما انتصرت على الموقف، ودفعتني لاتخاذ قرار مخالف تماماً..
قرار بأن أعود أدراجي، وأتخذ نفس المسار، لعلني أعثر على المظروف.. وعلى أول مكسب كبير فى حياتي..
كانت الاحتمالات تقترب من الصفر، وعلى الرغم من هذا فقد انطلقت بالسيارة (132 أزرق ميتالك)، عائداً إلى المطبعة، التى لم أتوقف عندها؛ لأن الخجل قد منعني من الإشارة إلى ضياع النقود مني، أو حتى السؤال عنها، أو لأن اسمي كان مكتوباً على المظروف بوضوح، وكلى ثقة في أنهم سيعيدونه إليَّ، إذا ما عثر عليه أحدهم، وواصلت طريقي، متخذاً نفس مسار انصرافي السابقة..
وفي تلك اللحظات، حاولت استنفار عقليتي البوليسية، واستنتاج أن المظروف قد سقط فى أول ملف، بفعل القصور الذاتي، أو أنني قد حاولت إيهام نفسي بهذا، إلا أنه لم يكن هناك..
وفي روح يغمرها اليأس، واصلت طريقي، متجهاً إلى هندسة عين شمس، التي تقع خلف المؤسسة تماماً، وبدأت أقتنع بأنني قد فقدت النقود بالفعل، و…
وفجأة، لمحته..
مظروفاً أبيض، ملقى عند قاعدة الرصيف، وطلبة الكلية يغادرنها، ويعبرون فوقه بلا مبالاة، دون أن يلتفت مخلوق واحد إليه..
وخفق قلبى بعنف… بل بمنتهى العنف..
أمن الممكن أن يكون هو نفسه مظروفى، الذي يحوي أول مكسب؟!..
وبقلب يدق ألف دقة فى الدقيقة (وهذا الكلام ليس للأطباء)، ملت بالسيارة نحو الرصيف، وأوقفتها إلى جوار ذلك المظروف بالضبط ثم ملت لأفتح باب السيارة الأيمن، وتطلعت إليه..
وقفزت دقات قلبي من ألف إلى مليون..
فربما لا تصدقون، كما لم أصدق أنا، ولكنه كان مظروفي بالفعل.. عليه اسمي فى وضوح، وداخله المبلغ كاملاً، لم ينقصه جنيه واحد..
ولدقيقة أو يزيد، جلست داخل السيارة صامتاً، لا أصدق ما حدث، وأدركت عندئذ فقط، أن المال الحلال بالفعل لا يضيع أبداً..
وعندما أدرت محرك سيارتي، كانت أصابعي ترتجف من فرط الانفعال، حتى أنني قدتها بسرعة عشرين كيلو متر فى الساعة، حتى خرجت من القاهرة، وخلفي موجات من السباب والشتائم، بسبب تعطيل الطريق..
ولأوَّل مرة في حياتي، شعرت أن الطريق إلى طنطا طويل.. طويل جداً؛ من شدة لهفتي على الوصول، ومشاركة زوجتي قصة ضياع النقود وعودتها..
ولكن فور وصولي إلى طنطا، وجدت نفسى أتجه أوَّلاً إلى أستاذي وصديقي رجل الأمن، دون ميعاد سابق لأول مرة، ولم يكد يستقبلني، حتى رويت له القصة كاملة..
وبابتسامة حانية هادئة، وصبر عهدته فيه دوماً، استمع إلىَّ جيداً، حتى انتهيت من روايتى، وانتظرت منه أن يشاركني فرحتي في استعادة النقود، إلا أنه ظلّ صامتاً بضع لحظات، قبل أن يميل نحوي، قائلاً فى جدية واهتمام: "المفروض ده يعلمك درس".
سألته فى دهشة : "درس إيه ؟!..".
أجابني فى جدية شديدة: "ما تخليش الأمور الفرعية تشتت انتباهك عن الأمور الرئيسية، مهما كانت الأسباب".
لم يرق لي موقفه فى البداية، ويبدو أن هذا قد بدا واضحاً على ملامحي؛ لأنه ابتسم قائلاً: "وما تغضبش من كلمة الحق كمان"..
وكان هذا أهم درس تلقيته في حياتي كلها، وما زلت أعمل به، حتى يومنا هذا..
المهم أنني قد عدت إلى زوجتي، وأخبرتها بالأمر، وقررنا أن نستغل جزءاً من المبلغ في رحلة صيفية، تغسل عناء عمل الشتاء كله..
وفي الصباح التالي، اصطحبنا (شريف) وشقيقته (ريهام)، التى ولدت بعده بعام واحد، إلى المعمورة، فى شقة أهدانا مفتاحها الأستاذ حمدى أيضاً، وقضينا ليلتنا الأولى هناك، نخطط لما سنفعله بباقي المبلغ، ونمنا قريري العين..
وفي الصباح التالي، استيقظت على رنين جرس الباب، ووجدت حارس العمارة أمامي، يخبرني أن الأستاذ حمدي يبحث عني؛ لأنه هناك خطأ في حساب مستحقاتي المالية..
وقفزت دقات قلبي مرة أخرى إلى الألف..
أو يزيد.
الفصل الحادي عشر
* كنت أخشى انخفاض مستحقاتي، ففوجئت بأنها قد تضاعفت.
* شعرت برجفة، عندما أخبرني أستاذي رجل الأمن، أنني أصبحت أشبه رجال المخابرات.
* مع اقتراح الناشر، وجدت نفسي مذعوراً، من فكرة الانتقال إلى القاهرة.
* * *
في إحباط شديد، وقفت في سنترال المعمورة، انتظر دوري للاتصال بالقاهرة، ومعرفة مقدار ذلك الخطأ فى الحسابات، بعد أن وضعت خطط بالفعل؛ لإنفاق ضعف المبلغ على الأقل، في الفترة التالية..
كان منزلنا ينقصه الكثير، وكنت أحلم باستكمال النواقص، بوساطة ذلك المبلغ، وخاصة لعمل حجرة نوم للأطفال، فى الحجرة التي بقيت خالية لدينا؛ لأنني لم أملك أيامها ما يكفى لفرشها..
ولقد استمر انتظار دوري في المكالمة نصف ساعة كاملة، بدت لي أشبه بدهر كامل، وأنا أحسب وأعد، وأتساءل: ترى كم سيتبقى من الثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه؟!… ألف أم خمسمائة، بعد ضبط الحسابات..
وأخيراً، تحدثت مع الأستاذ (حمدي)، وسألته في حذر عن ذلك الخطأ في حساب مستحقاتي، وهنا فوجئت بالرجل يعتذر في شدة وحرارة، وهو يخبرني أن هناك بالفعل خطأ في الحسابات؛ لأنني أستحق سبعة آلاف ومائة جنيه، وليس ثلاثة آلاف وسبعمائة..
ولم أدر لحظتها ماذا أقول؟!.. لقد انعقد لساني في حلقي، وأنا أتساءل في أعمق أعماقي: أيمكن أن يكون هناك مخلوق واحد، بكل هذا الشرف والنزاهة؟!..
الرجل يبحث عني بكل الوسائل الممكنة، ليخبرني أنه يدين لي بنقود؟!..
وفي هذا الزمن؟!..
وبكل احترام وتقدير، شكرت الأستاذ (حمدي) على اهتمامه، وأخبرته أننى سآخذ باقي المبلغ، عند عودتي إلى القاهرة، إلا أنه أصر بشدة، على أن يرسل لي باقى الحساب في الإسكندرية؛ لأنه لا يحب أن يكون مديوناً لأحد، على حد قوله!!..
ومنذ تلك الواقعة، اختلف موقفى مع المؤسسة وصاحبها، على نحو مدهش، إذ بدأت أتعامل مع المكان باعتباره منزلى الثاني، واعتبرت نفسى ابناً له، وجزءاً لا يتجزأ منه..
ومع كل هذا، ظللت أقرأ كتب الجاسوسية والمخابرات بمنتهى النهم والشراهة، وتضاعفت لقاءاتى مع صديقي وأستاذي وملهمي رجل الأمن، الذي تحوَّل إلى المصدر الرئيسي لمعلوماتي وخبراتي، عن ذلك العالم الغامض المثير، وأصبحت لقاءاتنا دروساً في كيفية التعامل معه، حتى أن أستاذي قد توقف ذات مرة عن الحديث فجأة، وابتسم، قائلاً: "تعرف.. لو استمرينا على كده ست شهور كمان، حتبقى أخدت دورة مخابرات.."..
قالها، وضحك، ولكنني لم أضحك، وإنما انبهرت، وشعرت برجفة تسرى في كل خلية من خلاياي، لمجرد تصور الفكرة..
وعبارته هذه، جعلتني أقبل على هذا العالم أكثر وأكثر.. وبدا التطوّر واضحاً، فى روايات (رجل المستحيل) نفسها، إذ بدأت بالفعل تتخذ منحنى جديداً، أكثر حرفية ودقة، ويبدو أن القارئ نفسه قد أدرك هذا، إذ أن أرقام المبيعات راحت ترتفع، وترتفع..
ومع ارتفاعها، تزايد نهمي أكثر، وتضخمت مكتبة الجاسوسية التي أملكها، حتى كادت تحتل نصف جدار كامل، في حجرة مكتبي الصغيرة فى طنطا، حيث منزلي الذى صار يضيق بالكتب، والموسوعات، و…
"مش عايز بقى تتنقل مصر؟!.."..
ألقى علىَّ الأستاذ (حمدي) السؤال فى اهتمام، ونحن نناقش خريطة مبيعات الروايات، فشعرت بالقلق، وأنا أقول: "بصراحة.. خايف.."..
وهنا بدا الحماس فى صوت الأستاذ (حمدي) وملامحه، وهو يشرح لي مزايا الانتقال إلى القاهرة، حيث منابع الثقافة، والمعرفة، وامتيازات القرب من مراكز صناعة القرار..
كل هذا كنت أدركه جيداً، إلا أن فكرة ترك مدينتي، التي نشأت وترعرعت فيها، وقضيت في ربوعها طفولتي وصباي وشبابي، كان أمراً يصيبني بالقلق والذعر، وقراراً كنت أؤجله، وأؤجله، خشية مواجهته..
ولكن الأستاذ (حمدي) جعلني أواجهه، على نحو لم يحدث من قبل، وبأسلوب لا يمكن مقاومته..
لقد أعطاني شقة فى (القاهرة)..
ومع وجود الشقة، بدأت أقنع زوجتي بفكرة الانتقال، والهجرة إلى العاصمة، وهي تواجهني بنفس مخاوفي، وتقارعني الحجة بالحجة، ثم انتهينا إلى أن أمنحها فرصة للتفكير، قبل أن تتخذ قرارها فى هذا الشأن..
ونمنا وقد ارتحنا للقرار، لأستيقظ على صرخات زوجتى الملتاعة..
ففى منزلنا، حدثت كارثة..
مؤلمة.
الفصل الثاني عشر
* فقدنا طفلتنا، قبل عيد ميلادها الأوَّل، فقرَّرت الامتناع عن التدخين إلى الأبد.
* زارني صديقي رجل الأمن، للعزاء في ابنتي، ولم يتعرفه أحد.
* انتقلنا إلى القاهرة، فشعرنا بالحيرة، والارتباك، والخوف، والضياع.
* * *
فقدنا ابنتنا…
كنا نستعد للاحتفال بعيد مولدها الأول، عندما استيقظت أمها، وذهبت لتتفقدها فى الصباح، فوجدتها هادئة، ساكنة في مهدها، وقد انتقلت روحها إلى بارئها..
وكانت صدمة لها، ولي، وللعائلة كلها، وبخاصة لابننا الأكبر شريف، الذي استيقظ مذعوراً، على صرخات أمه الملتاعة، التي انتزع الموت منها صغيرتها كعادته، دون سابق إنذار..
وبسرعة، اكتظ منزلنا بأفراد العائلة، والمعزين، والأصدقاء من كل الاتجاهات، وأصيب شريف بالفزع أكثر، مع البكاء والنحيب والانهيارات، وشعرت لحظتها، على الرغم من الحزن الذي يعتصر كياني، بأنني مسئول عن حماية زوجتي وابني من ذلك الموقف العصيب، لذا، فقد اصطحبت شريف إلى حجرته، ووضعته أمام التليفزيون، وأدرت له أحد أفلام الرسوم المتحركة التي يعشقها..
وهنا فوجئت بعاصفة من الغضب والسخط، باعتبار أنني رجل عديم الذوق والدم؛ لأنني أشغل التليفزيون، فى مثل هذه الظروف، ولكنني تجاهلت كل هذا، كعادتي أيضاً، وأوليت اهتمامي إلى زوجتي؛ لأحميها من الانهيار..
كانت فترة لن أنساها أبداً، وبخاصة تلك اللحظة، التى حملت فيها صغيرتي بين ذراعي، لأودعها مثواها الأخير..
في تلك الأيام، كنت قد امتنعت عن التدخين، بعد فترة من الإقبال النهم عليه، إذ كنت أدخن خمس علب سجائر يومياً، وكأننى أنتقم من الأيام التي توقفت فيها عن التدخين، لضيق ذات اليد، ومع وفاة ابنتنا، حاول الكل تعزيتى بسيجارة، فى عادة مصرية أعجز عن فهمها حتى الآن، إلا أننى أصريت على عدم العودة للتدخين، على الرغم من الموقف، وقلت لنفسي أن هذا من أجل ابنتي الراحلة، وليس من أجلي..
وقد كان، ولم أدخن سيجارة واحدة، من يومها، وحتى يومنا هذا، عبر ما يقرب من سبعة عشر عاماً كاملة.. وأيضاً من أجلها..
وفي مساء يوم الوفاة، زارني صديقي رجل الأمن معزياً، وشدّ على يدي في قوة، وهو يتطلَّع إلى عينيَّ مباشرة، وقال بجدية بالغة: "شد حيلك.. الشدائد تصنع الرجال.." ويومها لم يتعرفه أحد..
جاء، وجلس مع أسرتي وأصدقائي وأقاربي، وتحدث لنصف الساعة مع والدي، وعندما انصرف، جاء الكل يسألنى: "مين ده؟!.."..
وأخبرتهم أنه صديق قديم، ربطتنى به الظروف، ولم أخبرهم بالطبع عن مهنته، ولكن والدي - رحمه الله - قال في رصانة: "راجل محترم، وله هيبته.."..
وبعد انصراف الجميع، أدركت أن دوري ينحصر في التسرية عن زوجتي، التي ظلت تبكي طوال الوقت تقريباً، حتى أخبرتها أنها إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه ربما حرمنا من ابنة، ليمنحنا ابنتين..
والمدهش أن هذا ما حدث بالفعل، فقبل انتقالنا إلى القاهرة، حملت زوجتي، وأنجبت بالفعل طفلة، أطلقت عليها نفس اسم الطفلة الراحلة (ريهام).. وكانت نظريتى في هذا هي أن تشعر زوجتي بتعويض عن ابنتها المفقودة، وأن تنسى مع الابنة الجديدة أحزان القديمة..
وبعد مولد ريهام، قررنا اتخاذ الخطوة، التى طال انتظارها، ألا وهى الانتقال إلى العاصمة..
وانتقلنا إلى شقتنا الجديدة فى القاهرة، لنبدأ مرحلة جديدة من حياتنا..
كانت الشقة أنيقة للغاية، وأفضل كثيراً من شقتنا فى طنطا، وعلى الرغم من هذا فقد شعرنا فيها بالحيرة، والتوتر، وبلمحة من الضياع..
كل شئ حولنا كان غريباً، لم نألفه بعد.. الجيران، والأماكن، والمحال التجارية..
كل شئ كنا نتعامل معه بمنتهى الحذر، وخطوة بخطوة، عبر حياة مرتبكة، خاصة وأننا كنا قد قررنا بدء الشقة الجديدة بأثاث جديد، ولم نكن قد شيدنا المطبخ بعد..
ولكن كل شئ لم يلبث أن هدأ واستقر، وبدأنا نألف المكان، والجيران، والمنطقة، ورحت أعمل بنشاط أكثر، وحماس أكثر، ولكن انتقالنا إلى القاهرة أبعدني عن صديقي رجل الأمن، فاقتصرت علاقتنا على الاتصالات الهاتفية، والزيارات الخاطفة، كل حين وآخر..
وفي وقت واحد، رحت أعد شقتي، ومكتبي، الذى أعطاني إياه أيضاً الأستاذ (حمدى)، الذي أحتاج إلى جريدة كاملة، لسرد ما قدمه لي طوال عشرين عاماً كاملة..
وكان من الطبيعي، والحال هكذا، أن أشعر بالاستقرار، وأن أقرأ أكثر، وأكتب أكثر، وأن أفكِّر أيضاً فى عمل جديد..
عمل يختلف عما سبقه تمام الاختلاف.
الفصل الثالث عشر
* مقالي الأوَّل عن الجاسوسية، رفضه الأستاذ (عبد الوهاب مطاوع)؛ لأنه لا يصلح صحفياً..
* عقدت جلسات عمل مع (سمير الإسكندراني)، لصياغة عمليته المخابراتية فى كتاب..
* سكرتيرة مجلة الشباب اتصلت بي مرتجفة، وهي تقول: "المخابرات عايزاك"..
* * *
مع استقرارنا في (القاهرة)، واعتيادي نمط الحياة الجديد، بدأت تراودني بشدة فكرة القيام بعمل جديد.. عمل يختلف تماماً عن كل ما أقوم به بالفعل..
كنت أيامها أكتب بعض القصص المصوَّرة، فى مجلة (باسم) السعودية، ومقالات محدودة متنوعة، فى مجلة (الشرق الأوسط)، التى تتبع المؤسسة نفسها، وأعمال أخرى متفرقة، في صحافة عربية، محدودة القارئ، تمنحنى استقراراً مادياً، ولكنها لا تشبعني أدبياً أو صحفياً، وكنت أتمنى الدخول في عالم الصحافة المصرية، باعتبارها الباب الملكي للنجاح والانتشار صحفياً..
وبينما أبحث عن تلك الفكرة الجديدة، فوجئت باتصال تليفوني من الأستاذ (سيد عزمي)، من مجلة (الشباب)، أكثر مطبوعات مؤسسة (الأهرام) انتشاراً، يخبرني فيه أن اسمي قد طرح، فى اجتماع خاص بتطوير المجلة، وأن الأستاذ (عبد الوهاب مطاوع) يرغب فى مقابلتي..
ولم أصدق نفسي، فالكتابة في مطبوعة كهذه، كان يفوق أكبر أحلامي، حتى أنني لم أجرؤ على التفكير فيه، أثناء وضع خططي المستقبلية..
وفي حماس شديد، ورهبة لم أشعر بمثلها إلا مع الأستاذ (حمدي)، ذهبت لمقابلة الأستاذ (عبد الوهاب)، الذي أدمن قراءة مقالاته، واستقبلني الرجل بابتسامة هادئة، وبترحاب واضح، وطلب مني كتابة صفحتين شهريتين عن الجاسوسية، فى مجلة (الشباب)..
ويمكن القول بأنني قد خرجت من مكتبه (رقصاً) إلى منزلي، وقضيت ليلتي كلها أضع أسس وقواعد الصفحتين، وكل الأساليب التى يمكن أن أقدمها بها.. وبعد ثلاثة أيام فحسب، كنت أهرع إلى صديقي رجل الأمن، وأطلب رأيه فى العمل، الذي يعد أول أعمالي عن الجاسوسية فى الصحافة المصرية..
وقرأ أستاذي المقال في هدوء، ثم أعاده إلىَّ، قائلاً: "ممتاز، بس مش عارف ينفع صحفياً وللا لأ.."..
وبكل الحماس، رحت أؤكِّد له أن العمل يصلح صحفياً بالدرجة الأولى، وأنه يقوم بتعريف المخابرات، وتحديد أنواعها، وأنواع الجواسيس، و…
وابتسم أستاذي، وهو يقول: "يبقى على بركة الله"..
وفى الليلة نفسها، كنت أقدم المقال للأستاذ (عبد الوهاب)، الذى قرأه فى سرعة، ثم قال فى هدوء، ودون مواربة: "كويس.. بس ما يصلحش صحفياً.."..
وكانت صدمة شديدة، جعلتني أصمت تماماً، وأستمع إلى الأستاذ (عبد الوهاب)، وهو يشرح لي الفارق بين الأسلوب الأدبي، والأسلوب الصحفي، ويضع في أعماقي اللبنة الأولى، لصحفي وليد، ينشأ في قلب طبيب سابق، وأديب تحت التأسيس..
وكتبت المقال مرة ثانية، وأعلن الأستاذ (عبد الوهاب) قبوله له، وصدر بالفعل، كبداية لسلسلة مقالات لم تنقطع، حتى يومنا هذا..
ومع مقالاتي عن عالم الجاسوسية، ازداد ارتباطي بأستاذي رجل الأمن أكثر وأكثر، ورحت أتزوَّد منه بالمعلومات، التي كانت وما زالت تبهرني، وأيضاً حتى يومنا هذا..
وخلال عام أو يزيد، تضخَّمت مكتبتي، الخاصة بكتب الجاسوسية والمخابرات، باللغتين، العربية والإنجليزية، وأصبحت لقاءاتي مع أستاذي شبه منتظمة، في نفس الوقت الذى طلب مني فيه الأستاذ (عبد الوهاب مطاوع) الاتصال بالفنان (سمير الإسكندراني)، الذى يرغب في تحويل عملية الجاسوسية، التي قام بها فى الستينات، إلى كتاب يحوي كل التفاصيل..
واتصلت بسمير الإسكندراني بالفعل، وبدأنا نعقد جلسات عمل، ليسجل بصوته تفاصيل عمليته المثيرة، و…
وفجأة، وبينما كنت أزور والدتي فى (طنطا)، فوجئت بالآنسة (آمال)، سكرتيرة مجلة (الشباب) تتصل بي، وصوتها يرتجف بشدة، وهي تقول مضطربة: "المخابرات اتصلت، وعايزاك.."..
وكانت مفاجأة..
قوية.
|







 جديد مواضيع قسم سلاسل روايات مصرية للجيب
جديد مواضيع قسم سلاسل روايات مصرية للجيب







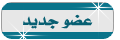







 العرض العادي
العرض العادي



