كاتب الموضوع :
محمد شلبي
المنتدى :
ارشيف خاص بالقصص غير المكتمله
 الفصل الأول
الفصل الأول
الفصل الأول
مدينة القدس.. عام 1901 ميلادية.
في باحة المسجد الأقصى وعلى بساطه الأخضر جلس الشيخ أيوب المقدسي وقد تحلق حوله رهط من الرجال مع من تحلقوا من طلاب علمه الكثيرين ينصتون للشيخ الوقور بإرهاف من على رؤوسهم الطير.
كانت صلاة العصر قد فرغت لتوها, وكعادة الشيخ أيوب جلس يحادث تلامذته ويلقنهم من علوم الدين على مختلف فروعها من حديث وفقه وشريعة وغيرها, كما كان يفعل عصر كل يوم وحتى مغيب الشمس, بصوته الهاديء وقسماته الوديعة ولحيته التي خالطها الشيب وتلك الابتسامة التي لا تفارق شفتيه. بيد أنه بدا في هذا المساء على غير ما عهدوه, فقد كان متهدج الصوت مضطرب النظرات تحمل أنفاسه بين الفينة والأخرى زفرات ملئها التوتر المشوب باللهفة والشوق وكأنه على موعد مع حبيب طال الشوق إليه وانتظاره.
مع مطلع عام 1860 ميلادية وفي بيت المقدس كان مولد الشيخ أيوب وبين أشجار الزيتون الوارفة, التي ملئت أرجاء المدينة فأضفت عليها من الجمال ما زادها رونقاً, كانت نشأته حتى بلغ من الشباب مطلعه. ولأن والده كان رجلا ورعا تقيا حالت ظروف الحياة القاسية بينه وبين حلمه في أن يصبح رجل دين يدعو إلي سبيل ربه فقد نذر ولده الوحيد للعلم وجعله وقفا على الدعوة لدين الإسلام, فما أن بلغ أيوب السادسة من عمره حتى دفع به والده إلي أحد مشايخ المدينة البارزين ليحفظ على يديه كتاب ربه ويتعلم كيف يتلوه حق تلاوته.
ولقد كان الفتى الصغير ذكيا ذا عقل متقد وشغف للعلم جعله يقبل عليه بنهم من لا يشبع, ولم يكن في تلك الأيام أسعد من والده على وجه البسيطة وهو يرى طفله الصغير يضرب في طرقات العلم بخطوات سريعة ثابتة وواثقة إلي الحد الذي جعل شيخه ومعلمه يتنبأ له بمستقبل باهر يضعه في مصاف الأئمة العظام.
عشر سنوات قضاها الفتي في كنف شيخه وأستاذه عبد السلام الأحمد فارتبط به إرتباطا وثيقا وكأنه جنين تشبث بحبله السُري..كان أشد ما جذبه لهذا الشيخ الوقور وأكثر ما أثار أعجابه في شخصيته الفريدة الرائعة هو علمه الواسع مع تواضعه الجم.
ذات يوم أمتدحه وأثنى على أتساع مداركه وتشعب معارفه فأطرق الشيخ برأسه وكست وجهه حمرة لم يستطع الفتى أن يفسرها وقتها, أهي حمرة الخجل؟ أم أنه الغضب قد أخذ بمجامع الرجل الوقور الطويل الصمت والتأمل؟.. ذلك أن الشيخ عبد السلام كان من ذلك النوع من الرجال الذي يرى في المديح باب للتملق ومسلكا من مسالك الغرور إلي النفس, وما أكثر من ملك عليهم الكبر ذواتهم لكثرة ما صب من مدح في مسامعهم.
أوجس الفتي في نفسه خيفة أن يعتريه غضب معلمه وأباه الروحي فسأله بصوت متعثر ينضح بالتوتر
"ماذا بك يا شيخي؟!"
رفع إليه شيخه رأسه ورمقه بنظرة ثاقبة أحس معها أيوب وكأنه عصفور قد بلله القطر فانتفض..ثم ما لبث أن جاءه صوت الشيخ كعادته جهورا عميقا وإن كان يحمل هذه المرة من الحدة ما لم يخفى على مسامعه
" أعلم يا ولدي أن العالم مهما بلغ من العلم إنما يحمل من بحور المعارف قدر ما يحمل الطائر في منقاره من ماء البحر, فالله عز وجل يقول في محكم آياته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا,ومن سلك مسالك العلم أفنى فيها عمره وما قطع منها سوى خطوات قليلة, وأن العالم الحق من ظن في نفسه الجهل ذلك أن ظنه هذا دافعه لأن يسعى حثيثا خلف تحصيل المعرفة,وأن من أعتقد في نفسه أنه قد بلغ سنام العلم قعد عن طلبه وأصابه من الكِبر ما يرميه في مصاف الجُهل, وإني إنما أريدك أن تسعى وتلهث خلف المعارف, فلا تفرحن يوما بمدح جاهل ولا تحزنن لنقد عاقل ولا تجعل شيئا يحول بينك وبين مطلبك إلا الموت."
كانت كلمات الشيخ تقطر من فمه كالدر النفيس فبقيت عالقة بذهن أيوب لا تبارحه.. بقيت هناك في ركن قصي من عقله فما أمتدت إليها يد النسيان وما أستطاع أن يمحوها تعاقب الليل والنهار.
هو لا يزال يتذكر تلك الليلة البعيدة وكأنها الأمس القريب.. في تلك الليلة كان الشيخ عبد السلام يتأهب لسفر طويل أعتاد عليه في مثل هذا الوقت من كل عام وبقى على تلك العادة لم يقطعها حتى وافته المنية.. ذلك أنه ولشهر كامل كانت رحلته السنوية إلي قلب الدولة العثمانية الأستانة حيث كان يقضي أياما هناك مع صديق له يدعى كاظم باشا .
هكذا أخبره شيخه كما أخبره أيضاً بأن صديقه هذا يعمل في بلاط الخليفة العثماني وأنه قد تعرف عليه منذ سنوات حين أرسله السلطان الراحل عبد المجيد الثاني في مهمة هنا ببيت المقدس.
في تلك الليلة كان على أيوب أن يودع شيخه وأستاذه بقلب يكاد ينفطر كمداً فلكم كانت تلك الأيام التي يغيب فيها شيخه عنه ثقيلة على عقله ووجدانه ولكم كان يشعر بالوحدة والفراغ يكادا يذهبا بروحه.. كان دائما ما يساوره الإحساس بأن المدينة بل والعالم بأسره قد خلا من حوله فكان يعكف على حساب الأيام والليالي منتظراً عودة شيخه من رحلته.
غير أن الشيخ عبد السلام وفي رحلته الأخيرة تلك لم يعد.. أو ..
أو أنه عاد جسداً بلا روح.
وما كان الفتى يعلم أن وداعه لشيخه في تلك الليلة هو الوداع الأخير.
...................................
في أواخر عام 1876 م كانت أخر رحلات الشيخ عبد السلام إلي الأستانة.. ولم يكن هناك ثمة ما يذكره بأول مرة تقع عيناه فيها على هذه الدرة النفيسة سوى ذلك الأنبهار الذي طالما أستحوذ عليه وكان القاسم المشترك بين جميع سفراته إلي هناك.
بميناء على ضفاف البسفور رست به السفينة.
كان رصيف الميناء على صغره يضج بالحياة وبأكتاف متزاحمة ووجوه أختلط فيها السرور بالحزن .. فذاك الباسم قد جاء في أنتظار صديق أو قريب طالت غيبته وثار القلب شوقا لرؤيته.. وتلك المتجهمة الباكية لابد أنها زوجة أو أم في وداع زوجها أو ولدها الذي سوف تحمله الأمواج عما قريب نحو المجهول.. أقدام غادية وأخرى آتية.. أبتسامات لقاء وعبرات وداع.. أصوات مختلطة بألسنة متباينة.. فذاك يصيح بالتركية في خادمه أن يسرع بحمل حقائبه.. وهذان الصديقان قد أرتمي كل منهما بأحضان الأخر وقد لُفظت حرارة اللقاء على لسانهما بالعربية.. وتلك المرأة تقلب عينيها بحثا عن شخص تعرفه وهي تتأفف بلغة أوروبية..وذلك الشاب الحاد الملامح لابد أنه إيراني فقد كان ينادي علي أحد الحمالين بالفارسية و....
والشيخ عبد السلام هناك عند حافة السفينة قد ولى وجهه شطر تلك الأمواج المتلاطمة من البشر يرقب رصيف الميناء بشرود وإنبهار كادا ينسياه أن السفينة قد دخلت بوغاز الميناء وأن الرفاق على متنها شرعوا في مغادرتها.
رباه!!!!...
كم هي رائعة الحسن تلك المدينة!!..كأنها قطعة من الفردوس..كأنها عروس ليلة زفافها.. وكأن البسفور جبينها الوضاء كاللجين المذاب.
كل شيء فيها يسحر الناظر ويأسر الألباب!!.. مساجدها المهيبة.. قصورها الراقية..حدائقها الغناء..أسواقها.. محلاتها.. طرقاتها.
طرقاتها؟!!
إن كل خطوة في تلك الطرقات هي أقتفاء للتاريخ والحضارة .
منذ أن كانت لبنة خضراء في جدار الحضارة سرت النبؤة بأنها ستلعب دورا فارقا في تاريخ العالم.. كانت وكأنها ذلك النوع من العباقرة الذي يلفت الأنظار لموهبته وهو بعد ناعم الظفر.. قال عنها نابليون بونابرت الأول فيما قيل عنها من زعماء العالم ومشاهيره
" لو كان العالم كله دولة واحدة لكانت أستنبول عاصمتها."
فمتي كانت البداية ؟!.. ومتي كللت ببهاءها مفرق الأرض؟
"أختلف المؤرخون حول تحديد التاريخ الفعلي الذي أشرقت فيه شمس الأستانة على العالم وإن كان الراجح في الرأي بينهم أن مدينة بيزنطة – أول ما أطلق عليها من الأسماء – قد ظهرت للوجود عام 660 ق.م. على يد (بيزاس) ملك الميغاريون وذلك على الجانب الأوروبي من البسفور وما لبثت أن تطورت حتى صارت من أحصن المدن آنذاك.. وما زالت على حالها هذا حتى عام 196 م. إذ لحق بها الدمار والخراب في ذلك العام بعد أن أعلن عليها الحرب الإمبراطور الروماني (سبتيموس سفيروس) ووقعت تحت حصاره.. غير أن العناية الألهية شاءت أن تنتشلها مما لحق بها من دمار وخراب فكان ذلك علي يد البطريرك (ساويرس الأنطاكي) فأعاد إليها ما كان لها من مجد وإزدهار."
راح الشيخ عبد السلام يستمع بشغف شديد لقبطان السفينة التى كانت تحمله إلي أستنبول وقد جمعهما على ظهر السفينة السمر في ليلة هادئة ناعمة النسيم وقد حبس أنفاسه لا لإنبهاره فحسب بل ربما مخافة من أن تقطع تلك الأنفاس اللاهثة على القبطان حبل الحديث الذي راح يسترسل من فمه بحماسة الضارب لآباط الأمور.
" في عام 324 م. وبعد أن ألحق الإمبراطور الروماني (قسطنطين الأول) الهزيمة الساحقة بعدوه اللدود الإمبراطور ( فاليريوس ليسينيوس) بمعركة أسكودار جذب موقع المدينة الساحر نظره وشغفه فاستحالت بعد ست سنوات من المعركة أي في عام 330 م. إلي العاصمة الجديدة للإمبراطورية الرومانية وتحول اسمها إلي القسطنطينية – أي مدينة قسطنطين – وظلت علي حالها من القوة والإزدهار حتي عام 395 م. حين فارق الحياة الإمبرطور الروماني (ثيودوسيوس الأول) وتقسمت إمبراطوريته من بعده فباتت القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية البيزنطية التي جعلت من المدينة مركزا عالميا للتجارة بل ومركزا روحيا ودينيا للمسيحيين الروميين الأرثوذوكس الذين ملئوا أرجائها بأفخم الكنائس وأعظمها على الأطلاق آنذاك ككتدرائية آيا صوفيا التي تحولت فيما بعد مع الفتح الإسلامي إلي مسجد."
" يا الله!!..لكأنني أشاهد التاريخ يمثل حيا أمامي."
هكذا هتف الشيخ عبد السلام باللغة التركية العثمانية التي كان يجيدها تماما ًبعد أن توقف القبطان برهة يشعل فيها غليونه الذي لم يكن يفارق شفتاه قط.
" أكمل .. أكمل يا صديقي."
نفث القبطان دخان غليونه في الهواء قبل أن يستكمل حديثه وهو يطالع البحر الجاثي أمامهما هادئا ومهيبا والأفق المظلم الممتد أمامهما كأنه كهف عميق فاغر فاه ومتأهبا لأن يبتلع السفينة إلي المجهول.
كان حديث القبطان مشوقاً قد جذب مسامع الشيخ عبد السلام فأرهف السمع وأمعن الأنصات وهو يستمع إلي قصة فتح الإسلام للقسطنطينية عام 1453 على يد القائد العثماني محمد الثاني الفاتح الذي أعاد إليها شروقها ورونقها بعد أن سمح لسكانها من المسيحيين الفاريين بالعودة إليها وأطلاقه لسراح من كان قد تم سجنهم من الجنود والسياسيين ليعيشوا بكل حرية في أحضان إسلامبول – هكذا أطلق عليها السلطان محمد الفاتح وهي كلمة تركية تعني مدينة الإسلام أو تخت الإسلام – بل وجعل منها مدينة متعددة الثقافات بما شملتهم من مسلمين ومسيحيين ويهود.
ولأن السلطان محمد الثاني أراد لمدينته أن تكون أجمل عواصم العالم فقد شيد فيها من القصور والحمامات والحدائق العامة والأسواق والمعاهد والخانات وغيرها من الأبنية ما جعل من بهاءها مضرباً للأمثال فكان من أشهر ما خلفه السلطان في المدينة قصر الباب العالي ومسجد أبي أيوب الأنصاري الذان كانا وما زالا شاهدان على عظمة الفن المعماري الإسلامي.
ومنذ ذلك الحين الذي ظلل فيه الحكم الإسلامي سماءها حملت من الأسماء ما لم يحمله غيرها من المدائن من حيث الكثرة والعدد فهي الأستانة – عتبة السلطان – وهي الباب العالي.. ودار السعادة..ومقام العرش والدار العالية.. ثم هي أستنبول وهو أسم مشتق من الكلمة اليونانية أستنبولين أي " إلي المدينة".
كانت تلك الليلة التي دار فيها ذلك الحديث حول تاريخ الأستانة هي السابقة على بلوغ الرحلة نهايتها ودخول السفينة إلي الميناء ولقد أخبر الشيخ صاحبه الذي أسره بمعرفته الواسعة وتمني لو طال بهما الحوار إلي غير نهاية.. أخبره أن ثمة حالة من الذهول دائما ما تأخذه بعيدا عما حوله ومن حوله في كل مرة تقع فيها عيناه علي هذه المدينة الساحرة وكأنها مرته الأولي التي يخطو فيها على أرضها.
والحق أن كلام الشيخ لم يجد تصديقا من صاحبه ذلك أن الإنسان إذا ما أختلف علي مكان ما أو مدينة من المدائن وأعتاد إرتيادها فإنه ومن الطبيعي أن يألفها.. حقا أن الإنسان قد يرتبط عاطفيا ووجدانيا بهذه المدينة أو تلك على نحو قد يصل إلي حد العشق وربما الهوس ولكن أن يصاب بتلك الحالة التي يتحدث عنها الشيخ من الذهول والإنبهار كلما وطأها بقدمه وكأنها المرة الأولي التي يتعرف فيها عليها؟!!!.. هذا ما كان مستغربا من أمر الشيخ وما دفع القبطان إلي الإعتقاد بأن كلام صاحبه إنما هو ضرب من المبالغة أو ربما هو نوع من المجاملة الحميدة له كتركي ولد ونشأ بها.
ولإن كان القبطان لم يمل إلي تصديق الشيخ عبد السلام فيما قاله عن عشقه لإستنبول وهوسه بها بيد أنه سرعان ما داخله شعور بأن هذا الشيخ الوقور الجالس أمامه يحادثه ربما كان صادقا فيما ذهب إليه بشكل أو بأخر.. ولعل ما دفعه إلي تغير موقفه على هذا النحو هو ذلك الحزن والوجوم الذي بدا جليا على وجه الشيخ عبد السلام حين قال له مستكملا حديثه حول تاريخ الأستانه.
" غير أنه وفي يوم 14 سبتمبر لعام 1509 م. حدثت الفاجعة التي أشتهرت فيما بعد بفاجعة يوم القيامة الصغير.. إذ أنه وفي ذلك اليوم ضرب المدينة زلازل شديد قضى على أرواح الكثير من أهلها وخلف وراءه الكثير من الجرحى والعشرات من المباني والمعالم التي هدمت وبقيت على حالها من الخراب حتي أمر السلطان (بايزيد الثاني ) في عام 1510 بإعادة إعمار وبناء ما تهدم من الأبنية والمعالم مستخدما لذلك ما يزيد عن الثمانين ألف من العمال والبنائين."
فرغ القبطان من حديثه محولا ناظريه نحو الشيخ فوجده واجما قد طأطأ رأسه يحملق في أرض السفينة الخشبية بنظرات تحمل من الأسى أكثر مما تحمل من غيره فابتسم بإشفاق وندت منه زفره وهو يتأهب للنهوض فانتزعت حركته المفاجأة الشيخ من شروده.
نظر الشيخ إلي صاحبه الذي كان الأن يقف أمامه متأهبا للإنصراف وسأله بصوت هامس
" إلي إين يا صديقي؟"
ضحك القبطان وهو يمد يده مصافحا الشيخ
" إلي العمل أيها الشيخ الكريم.. أنسيت أنني المسئول عن هذه السفينة؟."
" ولكن لا زال لدينا متسع من الوقت فلم لا تزيدني من حديثك حول الأستانة؟"
" إننا سوف نصل إلي الميناء غدا مع المساء إن شاء الله ولابد لي من إنهاء بعد الأعمال قبل أن يحل الغد."
" الأمر ما ترى إذن."
كان ذلك أخر ما دار من حوار بين الصديقان في تلك الليلة قبل أن يفترقا وقد خلف كل منهما في وجدان صاحبه من مشاعر الإعجاب والود ما أنبت في قلبيهما ألام الوداع في مساء اليوم التالي حين رست السفينة معلنة بلوغ الرحلة نهايتها.
كان الشيخ عبد السلام لا يزال على وقفته عند حافة السفينة يراقب من حوله وما حوله وقد داخله شيء من التوتر والقلق ذلك أنه راح يطوف بناظريه أرجاء الميناء بحثا عن وجه صديقه ومضيفه كاظم باشا دون جدوى.
على بعد خطوات منه وخلفه مباشرة كان القبطان واقفا يرمقه بنظرات باسمة وإن خالطها شيء من الأسى لوشك مفارقته ذلك الشيخ الجليل الذي سحره بهدوءه ووداعته وتواضعه الجم مع ما هو عليه من واسع العلم.. على أنه لم يطل تأمله لصاحبه المنشغل بمراقبة الميناء إذ شق طريقه بين جموع الراكبين المتدافعين في سبيلهم لمغادرة السفينة حتى بلغ موضع الشيخ فربت على كتفه بود ظاهر
" حمدا لله على السلامة يا شيخ عبد السلام."
أنتبه الشيخ على صوت صاحبه فالتفت إليه وأجاب باسما
"سلمك الله من كل شر يا صديقي."
" أتنوي مغادرة السفينة أم أنك قررت قضاء رحلتك علي متنها؟"
ضحك الشيخ مجيبا
" هذا يعتمد على قرارك أنت بالبقاء على متنها من عدمه."
ابتسم القبطان لمجاملة الشيخ
" لا تنسي يا عزيزي أن لي زوجة وولدا لم أرهما منذ شهرين كاملين.. غير أني أرجو أن تتيح لنا الأقدار لقاءا آخر عما قريب."
"إذن فهو الوداع على أمل اللقاء..ولكن حقائبي........"
قاطعه القبطان
" لقد أمرت أحد البحارة بمعاونتك على حمل حقائبك حتي تغادر الميناء."
" بورك فيك يا صديقي العزيز."
هبط الشيخ من السفينة وقد تبعه بحار شاب حاملا حقيبته حتي إذا ما باتا خارج الميناء شكر له الشيخ صنيعه وأذن له بالإنصراف.
كانت الحيرة قد ملكت عليه أمره إذ أنه وفي جميع زياراته السابقة على تلك الزيارة قد تعود من كاظم باشا أن يجده أول المستقبلين له غير أنه لا يراه هذه المرة فأوجس في نفسة خيفة أن يكون قد أصاب صاحبه ضرا أو نزلت به نازلة فعربد القلق في فؤاده وأعمل الفكر فيما عليه أن يصنع فلم يجد بدا من أن يستأجر عربة تحمله إلي حيث دار ضيافة كاظم باشا.
وبينا الشيخ في شروده يبحث عن مخرج لما هو فيه من مأزق إذ مرت به عربة مغطاة يجرها زوج من الخيول ما لبثت أن توقفت على بعد خطوات منه على نحو مفاجيء.. وما كادت تستقر مكانها حتى أطل من نافذتها الضيقة رأسا عرف الشيخ فيه وجه كمال جلبي رئيس الخدم بدار الضيافة.
زفر الشيخ بقوة ليتخلص من ذلك التوتر والقلق الذي كان يتملكه وأحس براحة عارمة تداخله وهو يتطلع إلي وجه كمال الباسم الذي أسرع بالهبوط وقد تبعه شاب طويل القامة قوي البنيان حليق الرأس واللحية.
دون أن ينبث الشاب القوي ببنت شفة وبخطوات من يعلم دقائق واجبه حمل حقيبة الشيخ وأودعها العربة وظل واقفا عند بابها يراقب في صمت ما يدور بين رئيسه وذلك الشيخ الوقور الذي كان يراه للمرة الأولي.
كان كمال في تلك اللحظة يحتضن الشيخ بحميمية وهو يقول بشبه صياح فرِح
" حمدا لله على سلامتك يا شيخ عبد السلام."
سأله الشيخ متلهفا دون أن يلتفت لعبارته السالفة
" أين كاظم باشا؟.. أرجو ألا يكون مكروها قد أصابه."
ضحك كمال وأجاب مطمئنا الشيخ
" بل أصابه الخير كله."
كان كاظم باشا علوي من ذلك النوع الذي لا يخشى في الحق لومة لائم.. هكذا عهده الشيخ عبد السلام منذ أن عرفه.. ولقد كانت تلك المزية السر خلف دنوه من السلطان الراحل عبد المجيد حتى بات مستشاره الأثير.
ولذلك قصة عجيبة أنتشرت بين رفاقه المقربين.. أما تلك القصة فمفادها أنه ومنذ سنوات تولى كاظم باشا منصبه كقاضٍ شرعي بإحدي محاكم الأستانه, ولقد حدث ذات يوم أن نُظرت أمامه قضية ذاع خبرها في أرجاء الأستانة آنذاك فلقد عُثر في دار رجل سوداني الأصل كان يعمل حمالا على جثة رجل مقتول ولم يكن هناك من قرينة لتبرئة ذلك المتهم الذي لم يتفوه سوى بجملة واحدة كانت هي إجابته على كل سؤال يسأله له القاضي
" إني لا أعلم صاحب هذه الجثة والله يشهد على أني من دمه بريء."
لم يكن أمام كاظم القاضي في ذلك الوقت إلا أن يحكم بضرب عنق الحمال على ما أقترف من جرم حتى إذا ما جاء يوم القصاص إذا برجل تركي يقتحم على القاضي مجلسه وهو يصيح
" سيدي القاضي.. سيدي القاضي.. إن ذلك الحمال المسكين بريء من دم المقتول هذا."
تعجب كاظم لإقتحام الرجل مجلسه على هذا النحو ولقوله الذي كان يحمل نبرة ثقة ويقين فسأله عن برهان ما يقول.
طأطأ الرجل رأسه خجلا وهو يقول
" لأني أنا من قتله يا سيدي.. لقد كان بيني وبينه شيء من خلاف تطور إلي إشتباك وعراك إنتهي بقتلي له وكان بيت ذلك الحمال الأقرب إلي فهداني شيطاني إلي ان أتسلل إليه وألقي فيه بالجثة درءا للشبهة عني.. وها أنا ذا قد جئت تائبا أريد أن أريح ضميري وأن لا أكرر جرمي بقتل ذلك الحمال المسكين."
كان تلك هي القضية التي ذاعت بين الناس في المدينة وتناقلتها الألسن لا لغرابتها بل لغرابة ما نطق به كاظم من حكم إذا حكم بتبرئة الحمال والعفو عن القاتل التائب.
فلما أن علم السلطان عبد المجيد بما حدث وما كان في تلك القضية أرسل من فوره إلي شيخ الإسلام يطلب مثوله أمامه في القصر الشاهاني وبصحبته ذلك القاضى صاحب أغرب ما سمع من حكم.
"كيف تعفو عن قاتل أعترف بذنبه وبما أقترفت يداه؟!"
هكذا سأله السلطان عبد المجيد وقد تفردت بهما وبصحبتهما شيخ الإسلام قاعة العرش في قصر دولمة بهجت السلطاني.
أجاب كاظم بثبات من يعرف الحق ولا يحيد عنه
" عذراً شاهانتكم.. إن الله سبحانه وتعالي يقول أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.. ولقد قتل هذا الرجل نفسا وأحيا غيرها فهذه بتلك وحسابه إلي الله."
تعجب السلطان عبد المجيد لقول كاظم والتفت إلي شيخ الإسلام يسأله رأيه عما سمع
" ماذا يقول شيخ الإسلام فيما سمع الأن؟"
أجاب الشيخ باسماً
" إني يا مولاي لا أري غضاضة فيما حكم به القاضي كاظم.. بل لعلي أري في حكمه سهم الحكمة الذي أصاب به كبد العدل."
كانت تلك القصة الغريبة وذلك الحكم الأغرب هو مثار إعجاب السلطان عبد المجيد بكاظم الذي أحتل مكانة خاصة في قلبه فقربه منه وجعله مستشارا له وخلع عليه لقب باشا.
ولقد ظل كاظم باشا سنوات يعمل مستشارا لدي السلطان العثماني حتى لحق به ما يلحق بالناس وأخترمه الموت فتولى من بعده أمور العرش شقيقه السلطان عبد العزيز والذي كان علي خلاف شبه دائم مع كاظم باشا.
ولطالما عارض كاظم باشا سياسة السلطان عبد العزيز التى كادت تودي بالإمبراطورية كلها وتجعل منها أثرا بعد عين.. لطالما وقف حجر عثرة ضد تلاعبه بمقدرات الإمبراطورية وثرواتها التي راح ينفقها ببزخ ألصق به لقب عبد العزيز المبذر حتي لقد بلغت ديون الإمبراطورية الخارجية في عهده 250 مليون ليرة.. فلما ضاق عليه صدر السلطان ونفذ صبره أمر بطرده من القصر السلطاني وإمعانا في التنكيل به ومخافة من أن يلتف حوله رجال القصر فيثيرون البلبلة والزعزعة في أركانه أمر بإلقاء القبض عليه وأودعه السجن.
مكث كاظم باشا في السجن مدة لا يلتفت إليه أحد حتى تآمر رجال القصر على سلطانهم عبد العزيز فأنتزعوه من فوق العرش ليجلسوا مكانه السلطان مراد الخامس الأخ الأكبر للسلطان عبد الحميد والذي لم يدم على العرش سوى قرابة الثلاثة أشهر كانت كافية لأن يعمل رفاق كاظم باشا على إخرجه من محبسه قبل أن يصاب السلطان الجديد بالجنون ويطرد خارج قصر دولمة بهجت ليدخله أخوه عبد الحميد الثاني سلطانا للدولة العثمانية.
" ولما سمع مولانا السلطان عبد الحميد الثاني حفظه الله ما كان من أمر سيدي كاظم باشا وما وقع عليه من ظلم مبين من عمه عبد العزيز أرسل إلي قصر سيدي صباح اليوم رسوله يدعوه للتوجه لقصر دولمة بهجت ومقابلة شاهانته."
كان كمال يحادث الشيخ مفسراً له لغز إختفاء سيده وعدم أستقباله للضيف في الميناء هذا المساء وقد تهللت قسماته بالبشرى.. بينما راحت الجياد تلتهم الأرض إلتهاما وكأنها تسابق الريح إلي دار الضيافة وهي تجر خلفها العربة المغطاة حيث أستقر الشيخ وإلي جواره رئيس الخدم بينما قبالته جلس الخادم الشاب وقد أحتفظ بصمته دون أن يحرك ساكنا وكأنه تمثال قُد من صخر وأكتفي بالتشاغل عنهما بمراقبة الطريق من نافذة العربة الضيقة.
تسائل الشيخ متعجباً
"ومن أوقف السلطان علي نبأ كاظم باشا."
" لقد حدث منذ يومين أن جلس إلي السلطان عبد الحميد شاكر باشا الدفتردار وهو صديق مقرب لسيدي كاظم باشا."
" أجل .. إني أعرفه جيداً فلقد قابلته غير مرة بدار الضيافة.. أليس هو ذلك الأشقر طويل القامة ذو الشارب الكث."
ابتسم كمال جلبي مجيباٍ
" أحسنت.. إنه هو.. وهو أيضا من فاتح السلطان أدام الله حكمه في أمر سيدي كاظم باشا فتأثر شاهانته أيما تأثر بما سمع وأرسل في أستدعاء سيدي هذا الصباح فانطلق إليه ملبيا غير مبطيء بعد أن عهد إلي شرف إستقبالكم وحملني رسالة إعتذار إذ ربما يضطر لقضاء ليلته بالقصر السلطاني."
تنهد كمال كأنما قد أزاح عن صدره حملا ثقيلا قبل أن يستطرد
" هذا ما كان من أمر سيدي وما حبسه عن استقبال شخصكم الكريم اليوم."
ضحك الشيخ حتى بدت نواجزه وقال متهللا
" هذه والله خير بشرى."
ما أن فرغ الشيخ من عبارته حتى وقعت عيناه من النافذة على مسجد آيا صوفيا وكان على بعد أمتار قليلة منهم فاستأذن كمال في أن يعرجوا إلي المسجد فقد دنا موعد صلاة العشاء وقد حدثته نفسه أن يصلى لله شكرا على ما سمع من طيب الأخبار عن صاحبه قبل أن يرتفع الأذان بالصلاة.
أومأ كمال برأسه ملبياً وطلب من الخادم الشاب أن يأمر السائق بالتوقف قائلاً
" مر السائق فاليتوقف عند المسجد يا جعفر."
أنتبه الشيخ لوجود الشاب وكان قد جرفه الحديث بعيداً فنسيه تماما وللمرة الأولي منذ أن وقعت عليه عيناه أتاه صوت جعفر الخشن وهو يصيح بالسائق الذي كان يقود الجياد بالخارج أن يتوقف عند مسجد آيا صوفيا.
هذا كل ما كان من أمر الشيخ عبد السلام الأحمد منذ أن وطأ بقدمه أرض أستنبول وحتى هذه الساعة التي دلف فيها المسجد وبجواره رئيس الخدم كمال يتبعهما الخادم الغامض جعفر.. وحتي لا نثقل على الشيخ أرى من اللياقة أن نتركه الأن لصلاته ولنبحر بعيدا إلي غير هذا الموضع لنري ما سيكون من أحداث أخرى.
|







 جديد مواضيع قسم ارشيف خاص بالقصص غير المكتمله
جديد مواضيع قسم ارشيف خاص بالقصص غير المكتمله




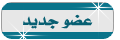











 العرض العادي
العرض العادي



