كاتب الموضوع :
Lovely Rose
المنتدى :
الادباء والكتاب العرب

الفصل السادس
لعرسك لبست بدلتي السوداء.
مدهش هذا اللون. يمكن أن يلبس للأفراح.. وللمآتم!
لماذا اخترت اللون الأسود؟
ربما لأنني يوم أحببتك أصبحت صوفياً، وأصبحتِ أنتِ مذهبي وطريقتي. وربما لأنه لون صمتي.
لكل لون لغته. قرأت يوما أن الأسود صدمة للصبر.
قرأت أيضاً أنه لون يحمل نقيضه. ثم سمعت مرة مصمم أزياء شهيراً، يجيب عن سر لبسه الدائم للأسود قال:
"إنه لون يضع حاجزاً بيني وبين الآخرين".
ويمكن أن أقول لك اليوم الكثير عن ذلك اللون. ولكني سأكتفي بقول مصمم الأزياء هذا.
فقد كنت في ذلك اليوم أريد أن أضع حاجزاً بيني وبين كل الذين سألتقي بهم، كل ذلك الذباب الذي جاء ليحط على مائدة فرحك.
وربما كنت أريد أن أضع حاجزاً بيني وبينك أيضاً.
لبست طقمي الأسود، لأواجه بصمت ثوبك الأبيض، المرشوش باللآلئ والزهور، والذي يقال إنه أعدّ لك خصيصاً في دار أزياء فرنسية..
هل يمكن لرسام أن يختار لونه بحياد؟
وكنت أنيقاً. فللحزن أناقته أيضاً. أكّدت لي المرآة ذلك. ونظرة حسان، الذي استعاد فجأة ثقته بي، وقال بلهجة جزائرية أحبها، وهو يتأملني: "هكذا نحبك آ خالد.. إهلكهم..!".
نظرت إليه.. كدت أقول له شياً.. ولكني صمتّ.
عند الباب المشرع للسيارات، وأفواج القادمين، استقبلني سي الشريف بالأحضان..
- أهلاً سي خالد.. أهلاً.. زارتنا البركة.. يعطيك الصحة اللي جيت.. راك فرحتني اليوم.
اختصرت ذلك الموقف العجيب مرة أخرى في كلمة. قلت:
- كل شيء مبروك..
وضعت قناع الفرح على وجهي. وحاولت أن أحتفظ به طوال تلك السهرة.
يمتلئ البيت زغاريد. ويمتلئ صدري بدخان السجائر التي أحرقها وتحرقني. يمتلئ قلبي حزناً. ويتعلم وجهي تلقائياً الابتسامات الكاذبة. فأضحك مع الآخرين. أجالس من أعرف ومن لا أعرف. أتحدث في الذي أدري والذي لا أدري. حتى لا أخلو بك لحظة واحدة.. حتى لا أفاجئك داخلي.. فأنهار.
أسلّم على العريس الذي يقبّلني بشوق صديق قديم لم يلتق به منذ مدة:
- هاك جيت للجزائر آ سيدي.. كان موش هاذا العرس.. ما كناش شفناك!
أحاول أن أنسى أنني أتحدث لزوجك، لرجل يتحدث إليّ مجاملة على عجل، وهو يفكر ربما في اللحظة التي سينفرد فيها بك في آخر الليل..
أتأمل سيجاره الذي اختاره أطول للمناسبة.. بدلته الزرقاء الحريرية التي يلبسها _أو تلبسه_ بأناقة من تعوّد على الحرير. أحاول ألا أتوقف عند جسده. أحاول ألا أتذكر. أتلهّى بالنظر إلى وجوه الحاضرين.
وتطلّين..
تدخلين في موكب نسائي، يحترف البهجة والفرح، كما أحترف أنا الرسم والحزن.
أراك لأول مرة، بعد كل أشهر الغيبة تلك، تمرين قريبة وبعيدة، كنجمة هاربة. تسيرين.. مثقلة الأثواب والخطى، وسط الزغاريد ودقّات البندير. وأغنية تستفزّ ذاكرتي، وتعود بي طفلاً أركض في بيوت قسنطينة القديمة. في مواكب نسائية أخرى.. خلف عروس أخرى.. لم أكن أعرف عنها شيئاً يومذاك.
آه كم كنت أحب تلك الأغاني التي كانت تزفّ بها العرائس، والتي كانت تطربني دون أن أفهمها. وإذا بها اليوم تبكيني!
"شرّعي الباب يا أم العروس.." يقال إن العرائس يبكين دائماً عند سماع هذه الأغنية.
تراك بكيت يومها؟
كانت عيناك بعيدتين.. يفصلني عنهما ضباب دمعي وحشد الحضور. فعدلت عن السؤال.
اكتفيت بتأمّلك، في دورك الأخير.
ها أنت ذي تتقدّمين كأميرة أسطورية، مغرية شهية، محاطة بنظرات الانبهار والإعجاب.. مرتبكة.. مربكة، بسيطة.. مكابرة.
ها أنت ذي، يشتهيك كل رجل في سرّه كالعادة.. تحسدك كل النساء حولك كالعادة..
وها أنذا _ كالعادة_ أواصل ذهولي أمامك.
وها هوذا "الفرقاني".. كالعادة.. يغنّي لأصحاب النجوم والكراسي الأمامية.
يصبح صوته أجمل، وكمنجته أقوى عندما يزفّ الوجهاء وأصحاب القرار والنجوم الكثيرة.
تعلو أصوات الآلات الموسيقية.. ويرتفع غناء الجوقة في صوتٍ واحد لترحب بالعريس:
"يا ديني ما أحلالي عِرسو.. بالعوادة..
الله لا يقطعلو عادة..
وانخاف عليه.. خمسة. والخميس عليه"
تعلو الزغاريد.. وتتساقط الأوراق النقدية.
ما أقوى الحناجر المشتراة. وما أكرم الأيدي التي تدفع كما تقبض على عجل!
ها هم هنا..
كانوا هنا جميعهم.. كالعادة.
أصحاب البطون المنتفخة.. والسجائر الكوبية.. والبدلات التي تلبس على أكثر من وجه.
أصحاب كل عهد وكل زمن.. أصحاب الحقائب الدبلوماسية، أصحاب المهمات المشبوهة، أصحاب السعادة وأصحاب التعاسة، وأصحاب الماضي المجهول.
ها هم هنا..
وزراء سابقون.. ومشاريع وزراء. سرّاق سابقون.. ومشاريع سرّاق. مديرون وصوليون.. ووصوليون يبحثون عن إدارة. مخبرون سابقون.. وعسكر متنكّرون في ثياب وزارية.
ها هم هنا..
أصحاب النظريات الثورية، والكسب السريع. أصحاب العقول الفارغة، والفيلات الشاهقة، والمجالس التي يتحدث فيها المفرد بصيغة الجمع.
ها هم هنا.. مجتمعون دائماً كأسماك القرش. ملتفون دائماً حول الولائم المشبوهة..
أعرفهم وأتجاهل معظمهم "ما تقول أنا.. حتى يموت كبار الحارة!"
أعرفهم وأشفق عليهم.
ما أتعسهم في غناهم وفي فقرهم. في علمهم وفي جهلهم. في صعودهم السريع.. وفي انحدارهم المفجع!
ما أتعسهم، في ذلك اليوم الذي لن يمدّ فيه أحد يده حتى لمصافحتهم.
في انتظار ذلك.. هذا العرس عرسهم. فليأكلوا وليطربوا. وليرشقوا الوراق النقدية. وليستمعوا للفرقاني يردد كما في كل عرس قسنطيني أغنية "صالح باي".
تلك التي مازالت منذ قرنين تُغنّى للعبرة، لتذكّر أهل هذه المدينة بفجيعة (صالح باي) وخدعة الحكم والجاه الذي لا يدوم لأحد..
والتي أصبحت تُغنّى اليوم بحكم العادة للطرب دون أن تستوقف كلماتها أحداً..
كانوا سلاطين ووزراء *** ماتوا وقبلنا عزاهمْ
نالوا من المال كُثرةْ *** لا عزّهم.. لا غناهُمْ
قالوا العرب قالوا *** ما نعطيوْ صالح ولا مالُو.."
أتذكر وأنا أستمع لهذه الكلمات، أغنية عصرية أخرى وصلتني كلماتها من مذياع بموسيقى راقصة.. تتغزّل بصالح آخر "صالح.. يا صالح.. وعينيك عجبوني..".
إيه يا قسنطينة، لكل زمن "صالحه".. ولكن ليس كل "صالح" باياً.. وليس كل حاكم صالحاً!
ها هوذا الوطن الآخر أخيراً أمامي.. أهذا هو الوطن حقاً؟
في كل مجلس وجه أعرف عنه الكثير. فأجلس أتأمّلهم، وأستمع لهم يشكون ويتذمّرون.
لا أحد سعيد منهم حسب ما يبدو.
المدهش أنهم هم دائماً الذين يبادرونك بالشكوى، وبنقد الأوضاع.. وشتم الوطن.
عجيبة هذه الظاهرة!
كأنهم لم يركضوا جميعاً خلف مناصبهم زحفاً على كل شيء. كأنهم ليسوا جزءاً من قذارة الوطن. كأنهم ليسوا سبباً في ما حلّ به من كوارث..
أسلِّم على (سي مصطفى). لقد أصبح وزيراً منذ ذلك اليوم الذي زارني فيه ليشتري مني لوحة. ورفضت أن أبيعه إياها.
لقد نجحت تكهّنات (سي الشريف) إذن، فقد راهن على حصان رابح..
أسأله مجاملة:
- واش راك سي مصطفى؟
فيبدأ دون مقدمات بالشكوى:
- رانا غارقين في المشاكل.. على بالك..!
تحضرني وقتها، مصادفة، مقولة لديغول: "ليس من حق وزير أن يشكو.. فلا أحد أجبره على أن يكون وزيراً!".
أحتفظ بها لنفسي وأقول له فقط..
- إيه.. على بالي..
نعم.. كنت (على بالي..) بتلك المبالغ الهائلة التي تقاضاها في كندا كعمولة لتجديد معدّات إحدى الشركات الوطنية الكبرى. ولكنني كنت أخجل أن أقول له ذلك، لأنني أدري أن الذين سبقوه إلى ذلك المنصب.. لم يفعلوا أحسن منه.
اكتفيت فقط بالاستماع إليه وهو يشكو، بطريقة تثير شفقة أي مواطن مسكين..
بينما كان حسان مشغولاً عني بالحديث مع صديق قديم.. كان أستاذاً للعربية.. قبل أن يصبح فجأة.. سفيراً في دولة عربية!
كيف حدث ذلك؟
يقال إنه ردّ دين.. وقضية "تركة" وصداقة قديمة تجمع ذلك الأستاذ بوالد إحدى الشخصيات.. وأنها ليست "الحالة الدبلوماسية" الوحيدة!
مثل (سي حسين) الذي أعرفه جيداً والذي كان مدير إحدى المؤسسات الثقافية، يوم كنت أنا مديراً للنشر. وإذا به بين ليلة وضحاها يعيّن سفيراً في الخارج.. بعدما طلعت رائحته في الداخل. فتكفلوا بلفّه بضعة أشهر وبعثه إلى الخارج مع كل التشريفات الدبلوماسية خلف علم الجزائر!
ها هوذا اليوم هنا.. في جوّه الطبيعي.
لقد استدعي إثر قضية احتيال وتلاعب بأموال الدولة في الخارج، ليعاد دون ضجيج إلى وظيفة حزبية.. ولكن على كرسي جانبي هذه المرة.
هنالك دائماً في هذه الحالات.. سلة مهملات شرفيّة!
في مجلس آخر، مازال أحدهم ينظّر ويتحدث وكأنه مفكّر الثورة وكل ما سيليها من ثورات. وإحدى ثورات هذا الشخص.. أنه وصل إلى الصفوف الأمامية في ظروف مشبوهة، بعدما تفرّغ لتقديم طالباته إلى مسؤول عجوز مولع بالفتيات الصغيرات..
هذا هو الوطن..
وها هو عرسك الذي دعوتني إليه. إنه "السيرك عمّار".. سيرك لا مكان فيه إلا للمهرّجين، ولمن يحترفون الألعاب البهلوانية.. والقفز على المراحل.. والقفز على الرقاب.. والقفز على القِيَم.
سيرك يضحك فيه حفنة على ذقون الناس، ويروّض فيه شعب بأكمله على الغباء.
فكم كان ناصر محقاً عندما لم يحضر هذا الكرنفال!
كنت أدري بحدسٍ ما أنه لن يحضر.. ولكن أين هو الآن.؟
تراه مازال يصلي في ذلك المسجد.. لكي لا يلتقي بهم. وهل تغيّر صلاته.. أو يغيّر سكري شيئاً؟
آه يا ناصر! كفّ عن الصلاة يا ابني. لقد أصبحوا يصلّون أيضاً ويلبسون ثياب التقوى. كفّ عن الصلاة.. وتعال نفكّر قليلاً. فأثناء ذلك ها هوذا الذباب يحطّ على كل شيء، والجراد يلتهم هذه الوليمة.
كلما تقدم الليل، تقدم الحزن بي، وتقدم بهم الطرب. وانهطل مطر الأوراق النقدية عند أقدام نساء الذوات، المستسلمات لنشوة الرق، على وقع موسيقى أشهر أغنية شعبية..
"إذا صاح الليل وَيْن انباتُو *** فوق فراش حرير ومَخدّاتُو.."
أمان.. أمان..
إيه آ الفرقاني غَنِّ..
لا علاقة لهذه الأغنية بأزمة السكن، كما قد يبدو من الوهلة الأولى. إنها فقط تمجيد لليالي الحمراء والأسرّة الحريرية التي ليست في متناول الجميع.
"ع اللي ماتوا.. يا عين ما تبكيش ع اللي ماتوا.."
أمان.. أمان.
لن أبكي.. ليست هذه ليلة لسي الطاهر.. ولا لزياد.
ليست للشهداء ولا للعشاق. إنها ليلة الصفقات التي يحتفل بها علناً بالموسيقى والزغاريد.
"خارجة من الحمّامْ بالريحيّةْ *** يا لِندراشْ للغير وإلا ليّ.."
أمان.. أمان.
لن أطرح على نفسي هذا السؤال. الآن أعي أنكِ للغير ولستِ لي. تؤكد ذلك الأغنيات، وذلك الموكب الذي يهرب بك، ويرافقك بالزغاريد إلى ليلة حبّك الشرعية.
وعندما تمرّين بي، عندما تمرين.. وأنت تمشين مشية العرائس تلك، أشعر أنكِ تمشين على جسدي، ليس "بالريحيّة" وإنما بقدميك المخضّبتين بالحناء.. وأن خلخالك الذهبي يدّق داخلي، ويعبرني جرساً يوقظ الذاكرة..
قفي..
قسنطينة الأثواب مهلاً! ما هكذا تمرّ القصائد على عجل!
ثوبك المطرّز بخيوط الذهب، والمرشوش بالصكوك الذهبية، معلّقة شعر كتبتها قسنطينة جيلاً بعد آخر على القطيفة العنابي. وحزام الذهب الذي يشد خصرك، لتتدفّقي أنوثة وإغراءً، هو مطلع دهشتي.
هو الصدر والعجز في كل ما قد قيل من شعرٍ عربيّ.
فتمهّلي..
دعيني أحلم أن الزمن توقّف.. وأنك لي. أنا الذي قد أموت دون أن يكون لي عرس، ودون أن تنطلق الزغاريد يوماً من أجلي.
كم أتمنى اليوم لو سرقت كل هذه الحناجر النسائية، لتبارك امتلاكي لك!
لو كنت "خطّاف العرائس" ذلك البطل الخرافي الذي يهرب بالعرائس الجميلات ليلة عرسهنّ، لجئتك أمتطي الريح وفرساً بيضاء.. وخطفتك منهم..
لو كنتِ لي.. لباركتنا هذه المدينة، ولخرج من كل شارع عبرناه وليّ يحرق البخور على طريقنا.. ولكن ما أحزن الليلة.. قسنطينة!
ما أتعس أولياءها الصالحين.. وحدهم جلسوا إلى طاولتي دون سبب واضح.. وحجزوا لذاكرتي الأخرى كرسيّاً أمامياً..
وإذا بي أقضي سهرتي في السلام عليهم واحدا واحدا..
سلاماً يا سيدي راشد..
سلاماً يا سيدي مبروك.. يا سيدي محمد الغراب.. يا سيدي سليمان.. يا سيدي بوعنّابة.. يا سيدي عبد المؤمن.. يا سيدي مسيد.. يا سيدي بومعزة.. يا سيدي جليس..
سلاماً يا من تحكمون شوارع هذه المدينة.. أزقّتها وذاكرتها.
قفوا معي يا أولياء الله.. متعب أنا هذه الليلة.. فلا تتخلوا عني.. أما كان منكم أبي؟
أبي يا "عيساوي" أباً عن جَد؟
أنت الذي كنت في تلك الحلقات المغلقة، في تلك الطقوس الطُرقيّة العجيبة، تغرس في جسدك ذلك السفود الأحمر الملتهب ناراً.. فيتخرق جسدك من طرفٍ إلى آخر، ثم تخرجه دون أن تكون عليه قطرة دم؟
أنت الذي كنت تمرّر حديده الملتهب والمحمّر كقطعة جمر، فينطفئ جمره من لعابك، ولا تحترق.
علّمني الليلة كيف أتعذّب دون أن أنزف.
علّمني كيف أذكر اسمها دون أن يحترق لساني.
علّمني كيف أشفى منها، أنت الذي كنت تردد مع جماعة "عيساوة" في حلقات الجذب والتهويل، وأنت ترقص مأخوذاً باللهب:
"أنا سيدي عيساوي.. يجرح ويداوي.."
من يداويني يا أبي.. من؟
وأحبها..
في هذه الساعة المتأخرة من الألم، أعترف أنني مازلت أحبها.. وأنها لي.
أتحدّى أصحاب البطون المنتفخة.. وذلك صاحب اللحية.. وذلك صاحب الصلعة.. وأولئك أصحاب النجوم التي لا تعدّ.. وكل الذين منحتهم الكثير.. واغتصبوها في حضرتي اليوم.
أتحداهم بنقصي فقط.
بالذراع التي لم تعد ذراعي، بالذاكرة التي سرقوها منّي، بكل ما أخذوه منّا.
أتحداهم أن يحبوها مثلي. لأنني وحدي أحبها دون مقابل.
وأدري أنه في هذه اللحظة، هناك من يرفع عنها ثوبها ذاك على عجل. يخلع عنها صيغتها دون كثير من الاهتمام ويركض نحو جسدها بلهفة رجل في الخمسين يضاجع صبية.
حزني على ذلك الثوب.. حزني عليه.
كم من الأيدي طرّزته، وكم من النساء تناوبن عليه، ليتمتع اليوم برفعه رجل واحد. رجل يلقي به على كرسي كيفما كان، وكأنه ليس ذاكرتنا، كأنه ليس الوطن.
فهل قدر الأوطان أن تعدّها أجيال بأكملها، لينعم بها رجل واحد؟
أتساءل الليلة.. لماذا وحدي تستوقفني كل هذه التفاصيل. وكيف اكتشفت الآن فقط، معنى كل الأشياء التي لم يكن لها معنى من قبل؟
أتراه عُشق هذا الوطن.. أم البعد عنه، هو الذي أعطى الأشياء العادية قداسة لا يشعر بها غير الذي حرم منه؟
ألأن المعايشة اليومية تقتل الحلم وتغتال قداسة الأشياء كان أحد الصحابة ينصح المسلمين بأن يغادروا مكة، حال انتهائهم من مراسيم الحج، حتى تبقى لتلك المدينة رهبتها وقداستها في قلوبهم، وحتى لا تتحول بحكم العادة إلى مدينة عادية يمكن لأي واحدٍ أن يسرق ويزني ويجور فيها دون رهبة؟
إنه ما يحدث لي منذ وطئت قدماي هذه المدينة. وحدي أعاملها كمدينة فوق العادة.
أعامل كل حجر فيها بعشق. أسلم على جسورها جسراً جسراً. أسأل عن أخبار أهلها، عن أوليائها وعن رجالها، واحداً.. واحداً..
أتأملها وهي تمشي، أتألها وهي تصلي، وتزني وتمارس جنونها ولا أحد يفهم جنوني وسرّ تعلّقي بمدينة يحلم الجميع بالهرب منها.
هل أعتب عليهم؟
هل يشعر سكان أثينا أنهم يمشون ويجيئون على ذاكرة التاريخ.. وعلى تراب مشت عليه الآلهة، وأكثر من بطل أسطوري؟
هل يشعر سكان الجيزة في بؤسهم وفقرهم، أنهم يعيشون عند أقدم معجزة، وأن الفراعنة مازالو بينهم، يحكمون مصر بحجرهم وقبورهم؟
وحدهم الغرباء الذين قرأوا تاريخ اليونان والفراعنة، في كتب التاريخ، يعاملون تلك الحجارة بقداسة، ويأتون من أطراف العالم لمجردّ الاقتراب منها.
تراني أطلت المكوث هنا، واقترفت حماقة الاقتراب من الأحلام حتى الاحتراق، وإذا بي يوماً بعد آخر، وخيبة بعد أخرى، أشفى من سلطة اسمها عليّ، وأفرغ من وهمي الجميل.. ولكن ليس دون الم؟
في هذه اللحظة، لا أريد لهذه المدينة أن تكون أكثر من رصاصة رحمة.
ولذا أتقبّل تلك الزغاريد التي انطلقت في ساعة متقدّمة من الفجر، لتبارك قميصك الملطّخ ببراءتك، كآخر طلقة نارية تطلقها في وجهي هذه المدينة، ولكن دون كاتم صوت.. ولا كاتم ضمير. فأتلقاها جامداً.. مذهول النظرات كجثة، بينما أرى حولي من يتسابق للمس قميصك المعروض للفرجة.
ها هم يقدمونك لي، لوحة ملطّخة بالدم، دليلاً على عجزي الآخر. دليلاً على جريمتهم الأخرى.
ولكنني لا أتحرك ولا أحتجّ. ليس من حق مشاهد لمصارعة الثيران، أن يغير منطق الأشياء، وينحاز للثور. وإلا كان عليه أن يبقى في بيته ولا يحضر "كوريدا" خلقت أساساً لتمجيد "الموتادور"!
شيء ما في هذا الجو المشحون بالزغاريد والزينة وموسيقى "الدخلة".. والهتافات أمام ثوب موقّع بالدم، يذكّرني بطقوس الكوريدا. وذلك الثور الذي يعدّون له موتاً جميلاً على وقع موسيقى راقصة يدخل بها الساحة، ويموت على نغمها بسيوفٍ مزيّنة للقتل، مأخوذاً باللون الأحمر.. وبأناقة قاتله!
من منّا الثور؟ أنتِ أم أنا المُصاب بعمى الألوان، والذي لا يرى الآن غير اللون الأحمر.. لون دمك؟
ثور يدور في حلبة حبّك، بكبرياء حيوان لا يهزم إلا خِدعة، ويدري أنه محكوم عليه بالموت المسبق.
الواقع أن دمك هذا يربكني، يحرجني، ويملأني تناقضاً.
أما كنت أتحرق دائماً لمعرفة نهاية قصتك معه، هو الذي أخذك مني، تراه أخذ منك كل شيء؟
سؤال كان يشغلني ويسكنني حد الجنون، منذ ذاك اليوم الذي وضعت فيه (زياد) أمامك. ووضعتك أمام قدرك الآخر.
تراك فتحت له قلاعك المحصّنة، وأذللت أبراجك العالية، واستسلمت لإغراء رجولته؟
تراك تركت طفولتك لي، وأنوثتك له؟
ها هو الجواب يأتيني بعد عام من العذاب. ها هو أخيراً لزج.. طريّ.. أحمر.. ورديّ.. عمره لحظات.
ها هو الجواب كما لم أتوقّعه، مقحماً، محرجاً، فلِمَ الحزن؟
ما الذي يؤلمني الأكثر هذه الليلة.. أن أدري أنني ظلمت زياداً بظني، وأنه مات دون أن يتمتع بك، وأنه في النهاية كان هو الأجدر بك الليلة؟
أم أن تكوني فقط، مدينة فتحت اليوم عنوة بأقدام العسكر، ككل مدينة عربية؟
ما الذي يزعجني أكثر الليلة؟ أن أكون قد عرفت لغزك أخيراً، أم كوني أدري أنني لن أعرف عنك شيئاً بعد اليوم، ولو تحدّثت إليك عمراً، ولو قرأتك ألف مرة؟
أكنتِ عذراء إذن، وخطاياك حبر على ورق؟
فلماذا أوهمتني إذن بكل تلك الأشياء؟ لماذا أهديتني كتابك وكأنك تهدينني خنجراً للغيرة؟
لماذا علّمتني أن أحبكِ سطراً بعد سطر.. وكذبة بعد أخرى.. وأن أغتصبك على ورق!
فليكن..
عزائي اليوم، أنك من بين كل الخيبات.. كنت خيبتي الأجمل.
***
يسألني حسان: لماذا أنت حزين هذا الصباح؟
أحاول ألا أسأله: ولماذا هو سعيد اليوم؟
أدري أن غياب ناصر ومقاطعته البارحة للعرس، قد عكّر نوعاً ما مزاجه. ولكنه لم يمنعه من أن ينسجم مع أغاني "الفرقاني"، وأن يضحك.. ويحادث كثيراً من الناس الذين لم يلتق بهم من قبل.
كنت ألاحظه. وكنت سعيداً شيئاً ما، لسعادته الساذجة تلك.
كان حسان سعيداً أن تُفتح له أخيراً تلك الأبواب التي قلما تفتح للعامة، وأن يدعى لحضور ذلك العرس الذي يمكنه الآن أن يتحدث عنه في المجالس لأيام؛ ويصفه للآخرين الذين سيلاحقونه بالأسئلة، عن أسماء من حضروا وما قُدِّم من أطباقي.. وما لبست العروس..
ويمكن لزوجته أيضاً أن تنسى أنها استعارت صيغتها والثياب التي حضرت بها العرس من الجيران والأقارب، وتبدأ بدورها في التفاخر على الجميع بما رأته من بذخٍ في ذلك العرس، وكأنها أصبحت فجأة طرفاً فيه، فقط لأنها دعيت للتفرّج على خيرات الآخرين.
قال فجأة:
- إن سي الشريف يدعونا غداً للغداء عنده. لا تنسَ أن تكون في البيت وقت الظهر لنذهب معاً..
قلت له بصوت غائب:
- غداً سأعود إلى باريس.
صاح:
- كيف تعود غداً.. ابقَ معنا أسبوعاً آخر على الأقلّ.. ما الذي ينتظرك هناك؟
حاولت أن أوهمه أن لي بعض الالتزامات، وأنني بدأت أتعب من إقامتي في قسنطينة.
ولكنه راح يلحّ:
- يا أخي عيب.. على الأقل احضر غداء سي الشريف غداً ثم سافر..
أجبته بلهجة قاطعة لم يفهم سببها:
- فرات.. غدوة نروّح.
كان يحلو لي أن أحدّثه بلهجة قسنطينية. كنت أشعر مع كل كلمة ألفظها، أنه قد يمر وقت طويل قبل أن ألفظها مرة أخرى.
قال حسان وكأنه يقنعني بضرورة عدم رفض تلك الدعوة:
- والله سي الشريف ناس ملاح.. مازال برغم منصبه وفيّاً لصداقتنا القديمة. أتدري أن البعض يقول هنا إنه قد يصبح وزيراً. ربما يفرجها الله علينا في ذلك اليوم على يده..
قال حسان هذه الجملة الأخيرة بصوت شبه خافت، وكأنه يقولها لنفسه..
مسكين حسان!
مسكين أخي الذي لم يفرجها الله عليه بعد ذلك. أكان من السذاجة بحيث يجهل أن ذلك العرس هو صفقة لا غير، وأن سي الشريف لا بدّ أن يتلقّى شيئاً ما مقابله. نحن لا نصاهر ضبّاطاً من الدرجة الأولى.. دون نوايا مسبقة.
أما بالنسبة لما يمكن أن يربح حسان من وراء منصب سي الشريف المحتمل.. فمجرد أوهام.
المؤمن يبدأ بنفسه، وقد تمر سنوات قبل أن يصل دور حسان.. وينال بعض ما يطمح إليه من فتات.
سألته مازحاً:
- هل بدأت تحلم أن تصبح أنت أيضاً سفيرا؟
قال وكأن السؤال قد جرحه نوعاً ما:
- يا حسرة يا رجل.. "اللي خطف.. خطف بكري.." أنا لا أريد أكثر من أن أهرب من التعليم، وأن أستلم وظيفة محترمة في أيّة مؤسسة ثقافية أو إعلامية، أية وظيفة أعيش منها أنا وعائلتي حياة شبه عادية.. كيف تريد أن نعيش نحن الثمانية بهذا الدخل؟. أنا عاجز حتى عن أن أشتري سيارة. من أين آتي بالملايين لأشتريها؟. عندما أتذكّر تلك السيارات الفخمة التي كانت مصطفّة أمس في ذلك العرس، أمرض وأفقد شهية التعليم. لقد تعبت من هذه المهنة، أنت لا تشعر بأية مكافأة مادية أو معنوية فيها. لقد تغيّر الزمن الذي "كاد فيه المعلم أن يكون رسولاً".. اليوم حسب تعبير زميل لي "كاد المعلم أن يكون (شيفوناً) وخرقة لا أكثر.
لقد أصبحنا ممسحة للجميع. فالأستاذ يركب الحافلة مع تلاميذه. و "يدزّ" و "يطبّع" مثلهم. ويشتمه الناس أمامهم. ثم يعود مثل زميلي هذا، ليعدّ دروسه ويصحّح الامتحانات في شقّة بغرفتين، يسكنها ثمانية أشخاص وأكثر.
بينما هناك من يملك شقّتين وثلاثاً بحكم وظيفته أو واسطاته.. يمكنه أن يستقبل فيها عشقياته أو يعير مفاتيجها لمن سيفتح له أبواباً أخرى.
صحّة عليك يا خالد.. أنت تعيش بعيدا عن هذه الهموم، في حيّك الراقي بباريس.. ما على بالكش واش صاير في الدنيا.!
آه حسان.. عندما أذكر حديثنا ذلك اليوم، تصبح المرارة غصّة في الحلق، تصبح جرحاً، تصبح دمعا، تصبح ندماً وحسرة.
كان يمكن أن أساعدك أكثر، صحيح.
كنت تقول: "اطلب شيئاً يا خالد مادمت هنا، ألست مجاهداً؟ ألم تفقد ذراعك في هذه الحرب؟ اطلب محلا تجارياً.. اطلب قطعة أرض.. أو شاحنة، إنهم لن يرفضوا لك شيئاً. هذا حقك. وإذا شئت دعه لي لأستفيد منه وأعيش عليه أنا وأولادي.. أنت يحترمونك ويعرفونك، وأما أنا فلا يعرفني أحد. إنه جنون ألا تأخذ حقك من هذا الوطن. إنهم لا يتصدّقون عليك بشيء. أكثر من واحد يحمل شهادة مجاهد وهو لم يقم بشيء في الثورة. أنت تحمل شهادتك على جسدك.."
إيه حسان.. لم تكن تفهم أن هذا هو الفرق الوحيد بيني وبينهم. لم تكن تفهم أنه لم يعد ممكناً اليوم، بعد كل هذه السنوات، وكل هذا العذاب، أن أطأطئ رأسي لأحد.. ولو مقابل أية هبة وطنية.
ربما كنت فعلت هذا بعد الاستقلال. ولكن اليوم مع مرور الزمن، أصبح ذلك مستحيلا.
لم يبق من العمر الكثير أخي. لم يبق من العمر الكثير، لأطأطئ رأسي قبل الموت.
أريد أن أبقى هكذا أمامهم، مغروساً كشوكة في ضميرهم. أريد أن يخجلوا عندما يلتقوا بي، أن يطأطئوا هم رؤوسهم ويسألوني عن أخباري، وهم يعرفون أنني أعرف كل أخبارهم، وأنني شاهد على حقارتهم.
آه لو تدري حسان!
لو تدري لذّة أن تمشي في شارع مرفوع الرأس، أن تقابل أيّ شخص بسيط أو هامّ جداً، دون أن تشعر بالخجل.
هناك من لا يستطيع اليوم أن يمشي خطوتين على قدميه في الشارع، بعدما كانت كل الشوارع محجوزة له. وكان يعبرها في موكب من السيارات الرسمية.
لم أقل شيئاً لحسان. وعدته فقط كمرحلة أولى أن أشتري له سيارة. قلت له: "تعال معي، واختر سيارة تناسبك. تأخذها معك من فرنسا. لا أريد أن تعيش هكذا في هذه الحالة بعد اليوم..".
فرح حسان يومها كطفل. شعرت أن ذلك كان حلمه الكبير الذي كان عاجزاً عن تحقيقه، وعاجزاً عن طلبه مني. ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لم أزره منذ سنوات؟
عندما أذكر حسان اليوم، وحدها تلك الالتفاتة تبعث في قلبي شيئاً من السعادة، لأنني أسعدته بعض الوقت، ومنحته راحة لبضع سنوات.
سنوات.. لم أكن أتوقع أن تكون الأخيرة.
عاد حسان إلى موضوعه قال:
- هل أنت مصر حقاً على السفر غداً؟
قلت له:
- نعم.. من الأرجح أن أسافر غداً..
قال:
- إذن لا بد أن تطلب سي الشريف اليوم، لتعتذر منه. فقد يسيء تفسير موقفك.. ويأخذ على خاطره..
فكرت قليلاً فوجدته على حقّ. قلت لحسان:
- اطلب لي رقم سي الشريف لأعتذر إليه..
كنت أتوقع أن تتوقف الأمور هناك. ولكن سي الشريف راح يرحّب بي.. ويحرجني بلطفه، ويلحّ لأحضر لزيارته ولو في ذلك الحين..
قال:
- تعال إذن وتغدّ معنا اليوم.. المهم أن نراك قبل أن تسافر.. ثم يمكنك أن تقدم هديتك بنفسك للعروسين قبل أن يسافرا أيضاً هذا المساء..
لم يكن هناك من مخرج. وجدت نفسي مرة أخرى، أواجه قدري معك. أنا الذي قررت السفر على عجل، حتى أنتهي من العيش في هذه الأجواء التي كانت تدور كلها بطريقة أو بأخرى حولك.
ها أنا مرة أخرى ألبس بدلتي السوداء نفسها، أحمل لوحة توقّفت أمامها يوماً وكانت سبب كل ما حلّ بي بعد ذلك. وأذهب مع حسان إلى الغداء..
ها هما قدماي تقودانني مرة أخرى نحوك. كنت أدري أنني سألتقي بكِ هذه المرة. كان هناك حدس مسبق يشعرني أننا لن نخلف هذا الموعد اليوم.
ما الذي قاله سي الشريف ذلك اليوم؟ ما الذي قلته ومن قابلت من الناس؟ وماذا قدم لنا من أطباق على تلك السفرة.. لم أعد أذكر.
كنت أعيش لحظات حبك الأخيرة. ولم يكن يهمني شيء في تلك اللحظة، سوى أن أراك.. وأن أنتهي منك في الوقت نفسه!
ولكن.. كنت أخاف حبك. كنت أخاف أن يشتعل حبك من رماده مرة أخرى. فالحب الكبير، يظلّ مخيفاً حتى في لحظات موته.. يظلّ خطراً حتى وهو يحتضر.
وجئت..
أكثر اللحظات وجعاً، أكثر اللحظات جنوناً، أكثر اللحظات سخرية، كانت تلك التي وقفت فيها لأسلم عليكِ، وأضع على وجنتيك قبلتين بريئتين، وأنا أهنئك بالزواج، مستعملاً كل المفردات اللائقة بذلك الموقف العجيب.
كم كان يلزمني من القوة، من الصبر ومن التمثيل، لأوهم الآخرين أنني لم ألتقِ بك قبل اليوم، سوى مرّة عابرة، وأنكِ لم تكوني المرأة التي قلبت حياتي رأساً على عقب؟
المرأة التي تقاسمني سريري الفارغ منذ عدة أشهر، والتي كانت حتى البارحة.. لي!
كم كان يلزمني من التمثيل، لأهديك تلك اللوحة، دون أي تعليق إضافي، دون أية إشارة توضيحية، وكأنها لم تكن اللوحة التي بدأت بها قصتي معك منذ خمس وعشرين سنة.
وكم كنتِ مدهشة أنتِ في تمثيلك، وأنتِ تفتحينها وتلقين نظرة معجبة عليها، وكأنك ترينها لأول مرة! فلا أستطيع إلا أن أسألك يتواطؤ سري جمعنا يوماً:
هل تحبين الجسور؟
ويخيم بيننا فجأة صمت قصير، يبدو لي طويلاً كلحظة تسبق حكماً بالإعدام.. أو العفو.
قبل أن ترفعي عينيك نحوي وينزل حكمكِ عليّ:
- نعم أحبها!
كم من السعادة منحتني لحظتها في كلمتين!
شعرت أنك تبعثين لي آخر إشارة حبّ.
شعرت أنك تهديني أكثر من مشروع لوحة قادمة. أكثر من ليلة وهمية.. وأنك رغم كل شيء ستظلّين وفيّة لذاكرتنا المشتركة.. ولمدينة تواطأت معنا، ومدّت كل هذه الجسور.. لتجمعنا.
ولكن.. أكنت حبيبتي حقاً؟ في تلك اللحظة التي كان رجل آخر فيها إلى جوارك. يلتهمك بعينين لم تشبعهما ليلة حب كاملة، في تلك اللحظة التي كان فيها الحديث يدور حول المدن التي ستزورينها في شهر العسل، وكنت أنا أشيّعك بصمت، لسفرك الأخير عن قلبي..
لقد كانت تلك هزيمتك الأولى معي.. انتهى كل شيء إذن. ها أنا قابلتك أخيراً، أكان هذا اللقاء يستحق كل ذلك الانتظار، كل ذلك الألم؟
كم كان حلمي به جميلاً! وكم هو اليوم مدهش ومسطّح في واقعه! كم كان مليئاً بانتظارك، وكم هو فارغ.. موجع بحضورك!
أكانت نصف النظرة التي تبادلناها بين نظرتين، تستحق كل ذلك الوجع، كل ذلك الشوق والجنون؟
تريدين أن تقولي لي شياً، وتتلعثم الكلمات.. تتلعثم النظرات.
لقد نسيت عيناك الحديث إليّ.. ولم أعد أعرف فكّ رموزك الهيروغليفية.
فهل عدنا يومها إلى مرتبة الغرباء، دون أن ندري؟
افترقنا..
قبلتان أخيرتان على وجنتيك. نظرة.. نظرتان.. وكثير من التمثيل، وألم سري صامت.
تبادلنا جميعاً كلمات المجاملة والتهاني والشكر الأخير.
تبادلنا عناويننا، بعدما أصرّ زوجك على أن يعطيني رقم هاتفه في البيت وفي المكتب في حالة ما احتجت إلى شيء.
وانصرفنا كل بوهمه.. وقراره المسبق.
عندما عدت إلى البيت بعد ذلك، نظرت طويلاً إلى تلك البطاقة التي كنت أتحسّسها طوال الطريق بشيء من الذهول.. ومذاق ساخر للمرارة. وكأنك انتقلت معها من قلبي إلى جيبي تحت اسم ورقم هاتفي جديد.
ودون كثير من التردد.. أو التعمّق في التفكير، قرّرت أن أمزّقها فوراً، مادمت أملك القدرة على ذلك، ومادمت مصمماً على أن ينتهي كل شيء هنا في قسنطينة.. كما أردتِ يوماً، وكما أصبحت أريد أنا اليوم.
***
ما الذي كنت تريدينه ذلك المساء؟ عندما جاء هاتفك فجأة ليخرجني من دوامة أفكاري وأحاسيسي المتناقضة؟
حين مدّ حسان نحوي الهاتف وقال: "هناك امرأة تريد أن تتحدث إليك.." توقّعت كل شيء إلا أن تكوني أنتِ.
سألتكِ بدهشة:
- ألم تسافري بعد؟
قلتِ:
- سنسافر بعد ساعة.. أردت أن أشكرك على اللوحة.. لقد وهبتني سعادة لم أتوقّعها..
قلت لكِ:
- أنا لم أهبك شيئاً.. لقد أعدت لكِ لوحة كانت جاهزة لكِ منذ خمس وعشرين سنة.. إنها هدية قدرنا الذي تقاطع يوماً. وأما أنا فلي هدية أخرى أتوقع أن تعجبك، سأقدمها لك ذات يوم فيما بعد..
قلتِ بصوت خافت وكأنك تخافين أن يسترق أحد السمع إليك أو يسرق منكِ تلك الهدية:
- ماذا ستهديني؟
قلت:
- إنها مفاجأة.. لنفترض أنني سأهبك غزالة.
قلتِ مدهوشة:
- إنه عنوان كتاب!
قلت:
- أدري.. لأنني سأهبك كتاباً. عندما نحب فتاة نهبها اسمنا. عندما نحب امرأة نهبها طفلاً. وعندما نحب كاتبة.. نهبها كتاباً. سأكتب من أجلك رواية.
أحسست في صوتك بشيء من الفرح والارتباك.. شيء من الدهشة والحزن الغامض. ثم قلتِ فجأة بنبرة عشقية لم أعهدها منك:
- خالد.. أحبك.. أتدري هذا؟
وانقطع صوتك فجأة، ليتوحد بصمتي وحزني، ونبقى هكذا لحظات دون كلام. قبل أن تضيفي بشيء من الرجاء:
- خالد.. قل شيئاً.. لماذا لا تجيب؟
قلت لك بشي من السخرية المرة:
- لأن رصيف الأزهار لم يعد يجيب..
- هل تعني أنك لم تعد تحبني؟
أجبتك بصوت غائب:
- أنا لا أعني شيئاً بالتحديد.. إنه عنوان لرواية أخرى للكاتب نفسه!
ماذا قلت لك بعدها، لا أذكر. من الأرجح أن يكون هذا آخر ما قلته لك قبل أن أضع السمّاعة، ونفترق لعدة سنوات.
***
"لا تطرقي الباب كل هذا الطرق.. فم أعد هنا".
لا تحاولي أن تعودي إليّ من الأبواب الخلفية، ومن ثقوب الذاكرة، وثنايا الأحلام المطويّة، ومن الشبابيك التي أشرعتها العواصف.
لا تحاولي..
فأنا غادرت ذاكرتي. يوم وقعت على اكتشاف مذهل: لم تكن تلك الذاكرة لي، وإنما كانت ذاكرة مشتركة أتقاسمها معك. ذاكرة يحمل كل منا نسخة منها حتى قبل أن نلتقي.
لا تطرقي الباب كل هذا الطرق سيدتي.. فلم يعد لي باب.
لقد تخلّت عني الجدران يوم تخلّيت عنك، وانهار السقف عليّ وأنا أحاول أن أهرّب أشيائي المبعثرة بعدك.
فلا تدوري هكذا حول بيت كان بيتي.
لا تبحثي عن نافذة تدخلين منها كسارقة. لقد سرقت كلّ شيء منّي، ولم يعد هناك من شيء يستحقّ المغامرة.
لا تطرقي الباب كلّ هذا الطرق الموجع..
هاتفك يدقّ في كهوف الذاكرة الفارغة دونك، ويأتي الصدى موجعاً ومخيفاً.
ألا تدرين أنني أسكن هذا الوادي بعدك، كما يسكن الحصى جوف "وادي الرمال"؟
تمهّلي سيدتي إذن..
تمهّلي وأنت تمرّين على جسور قسنطينة. فأية زلة قدم سترميني بسيلٍ من الحجارة. وأي سهو منك سيرميك هنا عندي لتتحطمي معي.
يا امرأة متنكّرة في ثياب أمي.. في عطر أمي وفي خوف أمي عليّ..
متعب أنا.. كجسور قسنطينة. معلّق أنا مثلها بين صخرتين وبين رصيفين.
فلماذا كل هذا الألم..؟ ولماذا.. أكذب الأمهات أنت، وأحمق العشاق أنا؟
لا تطرقي أبواب قسنطينة الواحد بعد الآخر.. أنا لا أسكن هذه المدينة.. إنها هي التي تسكنني.
لا تبحثي عني فوق جسورها، هي لم تحملني مرة.. وحدي أنا حملتها.
لا تسألي أغانيها عنّي، وتأتني لاهثة بخبرٍ قديم _جديد، وأغنية كانت تغنّى للحزن فصارت تغنّى للأفراح..
"قالوا العرب قالوا *** ما نعطيوْ صالح ولا مالُو
قالوا العرب هيهات *** ما نعطيوْ صالح باي البايات.."
أعرف عن ظهر قلب ما قاله العرب، وما لم يجرؤوا اليوم على قوله.
وأدري.. كان "صالح" ثوب حدادك الأول حتى قبل أن تولدي. كان آخر بايات قسنطينة.. وكنت أنا وصيّته الأخيرة: "يا حمودة.. آخ يا وليدي تها الله لي في الدار.. آه.. آه..".
أي دار يا صالح.. أي دار توصيني بها؟
لقد زرت (سوق العصر) وشاهدت دارك فارغة من ذاكرتها. سرقوا حتى أحجارها، وشبابيكها الحديدية. خرّبوا ممراتها وعبثوا بنقوشها.. وظلّت واقفة، هيكلاً مصفرّاً يبول الصعاليك والسكارى على جدرانه.
أيّ وطن هذا الذي يبول على ذكرته يا صالح؟
أي وطن هذا؟
ها هي ذي مدينة تلبس حداد رجل لم تعد تذكر اسمه. وها أنت ذي طفلة لا أحد يعرف قرابتها بهذه الجسور..
فانزعي "ملايتك" بعد اليوم.. وارفعي عن وجهك الخمار، ولا تطرقي الباب كل هذا الطرق..
فلم يعد صالح هنا.. ولا أنا.
افترقنا إذن..
الذين قالوا الحب وحده لا يموت، أخطأوا..
والذين كتبوا لنا قصص حب بنهايات جميلة، ليوهمونا أن مجنون ليلى محض استثناء عاطفي.. لا يفهمون شيئاً في قوانين القلب.
إنهم لم يكتبوا حباً، كتبوا لنا أدباً فقط
العشق لا يولد إلا في وسط حقول الألغام، وفي المناطق المحظورة. ولذا ليس انتصاره دائماً في النهايات الرصينة الجميلة..
إنه يموت كما يولد.. في الخراب الجميل فقط!
افترقنا إذن..
فيا خرابي الجميل سلاماً. يا وردة البراكين، ويا ياسمينة نبتت على حرائقي سلاماً.
يا ابنة الزلازل والشروخ الأرضية! لقد كان خرابك الأجمل سيدتي، لقد كان خرابك الأفظع..
قتلت وطناً بأكمله داخلي، تسللت حتى دهاليز ذاكرتي، نسفت كل شيء بعود ثقاب واحد فقط..
من علّمكِ اللعب بشظايا الذاكرة؟ أجيبي!
من أين أتيت هذه المرة _أيضاً_ بكل هذه الأمواج المحرقة من النار. من أين أتيت بكل ما تلا ذلك اليوم من دمار؟
افترقنا إذن..
لم تكوني كاذبة معي.. ولا كنتِ صادقة حقاً. لا كنتِ عاشقة.. ولا كنتِ خائنة حقاً. لا كنتِ ابنتي.. ولا كنتِ أمي حقاً.
كنت فقط كهذا الوطن.. يحمل مع كل شيء ضده.
أتذكرين؟
في ذلك الزمن البعيد، في ذلك الزمن الأول، يوم كنت تحبينني وتبحثين فيّ عن نسخة أخرى لأبيك.
قلت مرة:
- انتظرتك طويلاً.. انتظرتك كثيراً، كما ننتظر الأولياء الصالحين.. كما ننتظر الأنبياء.. لا تكن نبياً مزيفاً يا خالد.. أنا في حاجة إليك!
لاحظت وقتها أنكِ لم تقولي أنا أحبك. قلتِ فقط "أنا في حاجة إليك"..
نحن لا نحب بالضرورة الأنبياء. نحن في حاجة إليهم فقط.. في كل الأزمنة.
أجبتك:
- أنا لم أختر أن أكون نبياً..
قلت مازحة:
- الأنبياء لا يختارون رسالتهم، إنهم يؤدّونها فقط!
أجبتكِ:
- ولا يختارون رعيّتهم أيضاً. ولذا لو حدث واكتشفتِ أنني نبيّ مزيّف.. قد يكون ذلك لأنني بعثت لرعية تحترف الردّة!
ضحكت.. وبعناد أنثى يغريها التحدّي قلت:
- أنت تبحث عن مخرج لفشلك المحتمل معي، أليس كذلك؟..
لن أمنحك مبرراً كهذا. هات وصاياك العشر وأنا أطبقها.
نظرت إليك طويلاً يومها. كنت أجمل من أن تطبّقي وصايا نبي، أضعف من أن تحملي ثقل التعاليم السماوية. ولكن كان فيك نور داخلي لم أشهده في امرأة قبلك.. بذرة نقاء لم أكن أريد أن أتجاهلها..
أليس دور الأنبياء البحث عن بذور الخير فينا؟
قلت:
- دعي الوصايا العشر جانباً واسمعيني.. لقد جئتك بالوصية الحادية عشرة فقط..
ضحكت وقلت بشيء من الصدق:
- هات ما عندك أيها النبي المفلس.. أقسم أنني سأتبعك!
لحظتها شعرت برغبة في أن أستغلّ قسمك. وأقول لك: "كوني لي فقط.." ولكن لم يكن ذلك كلام نبي. وكنت دون أن أدري قد بدأت أمثّل أمامك الدور الذي اخترته لي.. فرحت أبحث في ذهني عن شيء يمكن أن يقوله نبي يباشر وظيفته لأول مرة.. قلت:
- احملي هذا الاسم بكبرياء أكبر.. ليس بالضرورة بغرور، ولكن بوعي عميق أنك أكثر من امرأة. أنت وطن بأكمله.. هل تعين هذا؟ ليس من حق الرموز أن تتهشّم.. هذا زمن ****، إذا لم ننحز فيه إلى القيم سنجد أنفسنا في خانة القاذورات والمزابل. لا تنحازي لشيء سوى المبادئ.. لا تجاملي أحداً سوى ضميرك.. لأنك في النهاية لا تعيشين مع سواه!
قلت:
- أهذه وصيتك لي.. فقط؟!
قلت:
- لا تستهيني بها.. إن تطبيقها ليس سهلاً كما تتوهّمين.. ستكتشفين ذلك بنفسك ذات يوم..
كان لا بد ألا تسخري يومها من وصية ذلك النبي المفلس.. وتستسهليها إلى هذا الحد..!
مرّت ستّ سنوات على ذلك السفر. على ذلك اللقاء، ذلك الوداع.
حاولت خلالها أن ألملم جرحي وأنسى. حاولت منذ عودتي، أن أضع شيئاً من الترتيب في قلبي. أن أعيد الأشياء على مكانها الأول، دون ضجيج ولا تذمّر، دون أن أكسر مزهرية، دون أن أغيّر مكان لوحة، ولا مكان القيم القديمة التي تكدّس الغبار عليها داخلي منذ زمن.
حاولت أن أعيد الزمان إلى الوراء، دون حقد ولا غفران أيضاً.
لا.. نحن لا نغفر بهذه السهولة لمن يجعلنا بسعادة عابرة، نكتشف كم كنا تعساء قبله. ونغفر أقل، لمن يقتل أحلامنا أمامنا دون أدنى شعور بالجريمة.
ولذا لم أغفر لك.. ولا لهم.
حاولت فقط أن أتعامل معك ومع الوطن بعشق أقل. واخترت اللامبالاة عاطفة واحدة نحوكما.
كان يحدث لأخبارك أن تصلني عن طريق المصادفة، وأنا أستمع إلى من يتحدث عن زوجك، عن صعوده المستمر.. وعن صفقاته وشؤونه السرية والعلنية التي تشغل أحاديث المجالس.
وكان يحدث لأخبار الوطن أن تأتيني أيضاً تارة في جريدة، وتارة في مجالس أخرى. وتارة عندما زارني حسان بعد ذلك لآخر مرة ليشتري تلك السيارة التي وعدته بها..
وكل مرة، كنت أواجه كل ما أسمعه باللامبالاة نفسها التي لا يمكن أن يولّدها سوى اليأس الأخير.
بدأت أتعلّق بحسان فقط، وكأنني اكتشفت فجأة وجوده. أصبح أمره وحده يهمني بعدما وعيت أنه كل ما تبقّى لي في هذا العالم، وبعدما اكتشفت تلك الحياة البائسة التي كان يعيشها، والتي كنت أجهل كل شيء عنها قبل زيارتي إلى قسنطينة.
أصبحت أطلبه هاتفياً بانتظام. أسأله عن أخباره وعن الأولاد، وعن البيت الذي كان ينوي أن يقوم فيه ببعض الإصلاحات، والذي وعدته أن أتكفّل بمصاريف ترميمه وتجديده.
كانت معنوياته تنخفض وترتفع من هاتف إلى آخر. كان يحدثني تارة عن بعض مشاريعه، وعن بعض الاتصالات التي يقوم بها ليتم نقله إلى العاصمة.. ثم يعود ويفقد فجأة حماسه.
كنت أعرف ذلك عندما يسألني في آخر مكالمته:
- متى ستأتي يا خالد؟
أشعر عندئذٍ أنه باخرة تغرق، وتبعث إشارة ضوئية تطلب النجدة مني.
وبرغم ذلك، كنت أسايره فقط، وأعده كل مرة أنني قد أزوره في الصيف القادم. وكنت أعرف في أعماقي أنني أكذب، وأنني قطعت الجسور مع الوطن حتى إشعار آخر.
في الواقع، أصبحت عندي قناعة بانعدام الأمل. كان القطار يسير في الاتجاه المعاكس، وبسرعة لم يكن ممكناً معها أن نفعل شيئاً.. أي شيء، غير الذهول وانتظار كارثة الاصطدام.
وكنت أحزم حقائب القلب.. وأمضي دون أن أدري في اتجاهٍ آخر أيضاً، في الاتجاه المعاكس للوطن.
رحت أؤثث غربتي بالنسيان. أصنع من المنفى وطناً آخر لي، وطناً ربما أبدياً، عليّ أن أتعود العيش فيه.
بدأت أتصالح مع الأشياء. أقمت علاقات طبيعية مع نهر السين.. مع جسر ميرابو.. مع كل المعالم التي كانت تقابلني من تلك النافذة، والتي كنت أعيش في معاداة لها دون سبب.
اخترت لي أكثر من عشيقة عابرة. أثثت سريري بالملذّات الجنونية.. بنساء كنت أدهشهن كل مرة أكثر، وأقتلك بهن كل مرة أكثر، حتى لم يبق شيء منكِ في النهاية.
نسي هذا الجسد شوقه لك، نسي تطرّفه وحماقاته وإضرابه عن كل لذة ما عدا لذّتك الوهمية.
تعمدت أن أفرغ النساء من رموزهن الأولى.
من قال إن هناك امرأة منفى، وامرأة وطناً، فقد كذب..
لا مساحة للنساء خارج الجسد. والذاكرة ليست الطريق الذي يؤدي إليهن. في الواقع هنالك طريق واحد لا أكثر.. يمكنني أن أجزم اليوم بهذا!
اكتشفت شيئاًً لا بد أن أقوله لك اليوم..
الرغبة محض قضية ذهنية. ممارسة خيالية لا أكثر. وهم نخلقه لحظة جنون نقع فيها عبيداً لشخص واحد، ونحكم عليه بالروعة المطلقة لسبب غامض لا علاقة له بالمنطق.
رغبة تولد هكذا من شيء مجهول، قد يعيدنا إلى ذكرى أخرى.. لعطر رائحة أخرى.. لكلمة، لوجه آخر..
رغبة جنونية تولد في مكان آخر خارج الجسد، من الذاكرة أو ربما من اللاشعور، من أشياء غامضة تسللت إليها أنتِ ذات يوم، وإذا بك الأروع، وإذا بك الأشهى، وإذا كل النساء أنتِ.
أفهمت لماذا قتلتك تلقائياً يوم قتلت قسنطينة في داخلي؟
ولم أعجب يومها وأنا أرى جثتك ممدة في سريري.
لم تكونا في النهاية سوى امرأة واحدة.
ستقولين: لماذا كتبت لي هذا الكتاب إذن؟ وسأجيبك أنني أستعير طقوسك في القتل فقط، وأنني قررت أن أدفنك في كتاب لا غير.
فهناك جثث يجب ألا نحتفظ بها في قلبنا. فللحب بعد الموت، رائحة كريهة أيضاً، خاصة عندما يأخذ بُعْد الجريمة.
لاحظي أنني لم أذكر اسمك مرة واحدة في هذا الكتاب. قررت هكذا أن أتركك بلا اسم. هنالك أسماء لا تستحق الذكر.
لنفترض أنك امرأة كان اسمها "حياة"، وربما كان لها اسم آخر.. فهل مهم اسمك حقاً؟
وحدها أسماء الشهداء غير قابلة للتزوير، لأن من حقهم علينا أن نذكرهم بأسمائهم كاملة. كما من حق هذا الوطن علينا أن نفضح من خانوه، وبنوا مجدهم على دماره، وثروتهم على بؤسه، مادام لا يوجد هناك من يحاسبهم.
وأدري.. ستقول إشاعة ما إن هذا الكتاب لك. أؤكد لك سيدتي تلك الإشاعة.
سيقول نقّاد يمارسون النقد تعويضاً عن أشياء أخرى، إن هذا الكتاب ليس رواية، وإنما هذيان رجل لا علم له بمقاييس الأدب.
أؤكد لهم مسبقاً جهلي، واحتقاري لمقاييسهم. فلا مقياس عندي سوى مقياس الألم، ولا طموح لي سوى أن أدهشك أنتِ، وأن أبكيك أنت، لحظة تنتهين من قراءة هذا الكتاب..
فهناك أشياء لم أقلها لك بعد.
اقرئي هذا الكتاب.. وأحرقي ما في خزانتك من كتبٍ لأنصاف الكتاب، وأنصاف الرجال، وأنصاف العشاق.
من الجرح وحده يولد الأدب. فليذهب إلى الجحيم كل الذين أحبوك بتعقّل، دون أن ينزفوا.. دون أن يفقدوا وزنهم ولا اتزانهم..
تصفّحيني بشيء من الخجل.. كما تتصفّحين ألبوم صور مصفرّة، لطفلة كانت أنتِ.
كما تطالعين قاموساً لمفردات قديمة معرّضة للانقراض والموت.
كما تقرأين منشوراً سرياً، عثرت عليه يوماً في صندوق بريدك.
افتحي قلبك.. واقرأيني.
كنت يوماً أريد أن أحدثك عن سي الطاهر وعن زياد وعن آخرين.. عن كل ما كنت تجهلين.
ولكن مات حسان.. ولم يعد اليوم وقت للحديث عن الشهداء.. أصبح كل واحد منا مشروع شهيد.
يحزنني ألا أهبك غزالة. "الغزلان لا تكون غزلاناً إلا عندما تكون حيّة". ولم يبق لي ما يمكن أن أهديكِ اليوم.
لقد أخذت مني كل من أحببت، الواحد بعد الآخر، بطريقة أو بأخرى. وتحول القلب إلى مقبرة جماعية ينام فيها دون ترتيب كل من أحببت. وكأن قبر (أمّا) قد اتسع ليضمهم جميعاً.
ولم أعد أنا سوى شاهد قبر لسي الطاهر.. لزياد ولحسان. شاهد قبر للذاكرة.
كنت أدري الكثير عن حماقة القدر، الكثير عن ظلمه وعن عناده، عندما يصرّ على ملاحقة أحد.
ولكن أكان يمكن لي أن أتوقع أن شيئاً كذلك يمكن أن يحدث؟
كنت اعتقد أنني دفعت لهذا القدر الأحمق ما فيه الكفاية، وأنه حان لي بعد هذا العمر، وتلك السنوات التي تلت فجيعة زياد، وفجيعة زواجك، أن أرتاح أخيراً.
فكيف عاد القدر اليوم ليأخذ مني أخي، أخي الذي لم يكن لموته من منطق. لا كان في جبهة، ولا كان في ساحة قتال ليموت ميتة سي الطاهر، وميتة زياد، رمياً بالرصاص.. أيضاً.
***
ذات يوم من أكتوبر 88، جاء خبر موته هكذا صاعقة يحملها خط هاتفي مشوش، وصوت عتيقة الذي تخفيه الدموع.
ظلت تجهش بالبكاء وتردد اسمي، وأنا أسألها مفجوعاً:
- "واش صار..؟"
كنت على علم بتلك الأحداث التي هزّت البلاد، والتي كانت الجرائد ونشرات الأخبار الفرنسية تتسابق بنقلها مصور، مفصلة، مطوّلة، باهتمام لا يخلو من الشماتة.
كنت أعرف تفاصيلها، وأدري أنها مازالت وهي في يومها الثاني مقتصرة على العاصمة. فمن أين لي أن أتوقّع الذي حدث؟
كان صوت عتيقة يردد مقطّعاً:
- قتلوه.. آ خالد.. يا وخيدتي قتلوه..
وصوتي يردد مذهولاً:
- كيفاش.. كيفاش قتلوه؟
كيف مات حسان؟
هل مهم السؤال، وموته كان أحمق كحياته، ساذجاً كأحلامه.
أقرأ كل الجرائد لأفهم كيف مات أخي، بين الحلم والحلم.. بين الوهم والوهم.
ما الذي ذهب به إلى العاصمة ليقابل "جماعة" هناك، هو الذي لم يزر العاصمة إلا نادراً.
ذهب هكذا في نهاية أسبوع.. ليبحث عن نهايته.
ضاقت به قسنطينة، ولم توصله جسورها الكثيرة إلى شيء.
قالوا له: "في العاصمة ستكون لك "خيوط". ستوصلك الطرق القصيرة هناك.. ولن توصلك الجسور هنا!".
صدّق حسان، وذهب إلى العاصمة ليقابل "فلاناً" من قبل "فلان" آخر..
وكان مقرراً أن تحل قضيته أخيراً هذه المرة، بعد عدة سنوات من الوساطات والتدخلات، ويغادر نهائياً سلك التعليم، لينتقل إلى العاصمة ويعيّن موظفاً في مؤسسة إعلامية.
ولكن القدر هو الذي حسم "ملفه" هذه المرة.
بين "فلان" و "فلان" مات حسان، خطأ برصاصة خاطئة، على رصيف الحلم.
فالحلم ليس في متناول الجميع أخي.. كان عليك ألا تحلم!
أحقاً "إن الشقاء يعرف كيف يختار صفاته" ولهذا اختارني أنا، واختار لي كل هذه الفجائع المذهلة، لأنفرد بها وحدي.
أنا الذي لم أكن أحلم سوى بأن أهبك غزالة..
كيف لي أن أفعل ذلك.. وأنت تهبينني كل هذا الدمار.. كل هذا الخراب؟
***
ويعود فجأة، حديث قديم بيننا إلى البال.
حديث مرّت عليه اليوم ست سنوات. في ذلك الزمن الذي كنت تجدين فيه شبهاً بيني وبين "زوربا". الرجل الذي أحببته الأكثر حسب تعبيرك، والذي كنتِ تحلمين بكتابة رواية كروايته، أو حب رجل مثله.
ترى لأنك كنت عاجزة عن كتابة رواية كتلك، اكتفيت بتحويلي إلى نسخة منه، وجعلتني مثله أتعلم أن أشفى من الأشياء التي أحبها بأكلها حتى التقيؤ..
جعلتني أعشق الخراب الجميل، وأتعلم كطائر يذبح أن أرقص من ألمي..
ها هوذا الخراب الجميل، الذي حدّثتني عنه يوماً بحماسٍ مدهش لم يثر شكوكي، يوم قلتِ:
"مدهش أن يصل الإنسان بفجائعه حد الرقص. إنه تميز في الخيبات والهزائم أيضاً. فليست كل الهزائم في متناول الجميع. لا بد أن تكون لك أحلام فوق العادة، وأفراح وطموحات فوق العادة، لتصل بعواطفك تلك إلى ضدها بهذه الطريقة..".
آه سيدتي لو تدرين!
كم كانت أحلامي كبيرة. وما أفظع هذا الخراب الذي تتسابق قنوات التلفزيون على نقله اليوم!
ما أفظع هذا الدمار، وما أحزن جثة أخي الملقاة على رصيف، يخترقها رصاص طائش!
ما أحزن جثته، وهي تنتظرني الآن في ثلاجة الموتى لأتعرف عليه، وأرافقه جثماناً إلى قسنطينة.
ها هي ذي قسنطينة مرة أخرى..
تلك الأم الطاغية التي تتربص بأولادها، والتي أقسمت أن تعيدنا إليها ولو جثة.
ها هي قد هزمتنا، وأعادتنا إليها معاً. في تلك اللحظة التي اعتقدنا فيها أننا شفينا منها، وقطعنا معها صلة الرحم.
لا حسان سيغادرها إلى العاصمة.. ولا أنا سأقدر على الهرب منها بعد اليوم..
ها نحن نعود إليها معاً..
أحدنا في تابوت.. والآخر أشلاء رجل.
وقع حكمك عليّ أيتها الصخرة.. أيتها الأم الصخرة..
فأشرعي مقابرك، وانتظريني. سآتيك بأخي.. افسحي له مكاناً صغيراً جوار أوليائك الصالحين، وشهدائك، وباياتك.. كان حسان كل هذا على طريقته.
كان غزالاً..
في انتظار ذلك.. تعالي سيدتي وتفرّجي على كل هذا الخراب الجميل!
فبعد قليل سيحضر زوربا ليمسك بكتفي ولنبدأ الرقص معاً.
تعالي..
لا بد ألا تخلفي هذا المشهد، سترين كيف يرقص الأنبياء عندما يفلسون حقاً.
تعالي.. سأرقص اليوم كما لم أرقص يوماً، كما اشتهيت أن أرقص في عرسك ولم أفعل..
سأقفز وكأن جناحينْ قد التصقا بقدمي فجأة، وكأن ذراعي المفقودة قد نبتت من جديد لتصبح ذراعي.
تعالي.. وليعذرني أبي الذي لم أشاركه يوماً في طقوس "عيساوة".
في حفل جذبه ورقصه الجنوني، وغرسه ذلك السفود في جسده من طرف إلى آخر.. بنشوة الألم الذي يجاور اللذة.
للحزن أكثر من طقس، وليس للألم وطن على التحديد. فليعذرني الأنبياء والأولياء الصالحون!
ليعذروني جميعا. لا أدري ماذا يفعل الأنبياء بالتحديد عندما يحزنون، ماذا يفعلون في زمن الردّة؟
هل يبكون أم يصلون؟
أنا قررت أن أرقص. الرقص تواصل أيضاً. الرقص عبادة أيضاً..
فانظر أيها الأعظم.. بذراع واحدة سأرقص لك.
ما أصعب الرقص بذراعٍ واحدة يا ربي! ما أبشع الرقص بذراعٍ واحدة يا ربي! ولكن..
ستعذرني أنت الذي أخذت ذراعي الأخرى.
ستعذرني.. أنت الذي أخذتهم جميعاً.
ستعذرني.. لأنك ستأخذني أيضاً!
هل المؤمن مصاب حقاً؟.. أن ترى تلك مقولة خلقت لتعلمنا الصبر فقط، لتبيعنا بدل مصائبنا فرح امتلاك شهادة بالتقوى؟
فليكن..
شكراً لك أيها الأعظم، أنت الذي لا يُحمد على مكروه سواه.
أنت الذي لا تخصّ بمصابك سوى المؤمنين من عبادك.. والأتقياء منهم.
اعترف أنني لم أكن احلم بشهادة حسن سلوك كهذه!
أفرغ منك سيدتي وأمتلئ لحناً يونانياً.
تتقدم موسيقى "زوربا" نحوي، دعوة للجنون المتطرف.
تأتي على شريط تعودت الاستماع إليه بمتعة غامضة. وإذا بذلك اللحن القادم اليوم وسط الخراب والجثث، يأخذ فجأة بُعده الأول الحقيقي.
فأنتفض فجأة من أريكتي وهو يفاجئني، وأصرخ كما في تلك القصة "هيا زوربا.. دربني على الرقص..".
ها هوذا "الخراب الجميل" الذي جعلتنا نشتهيه. لم أكن أعتقد أن يكون بشعاً إلى هذا الحد.. موجعاً إلى هذا الجد!
تزحف موسيقى تيودراكيس نحوي. وتخترقني نغمة.. نغمة. جرحاً.. جرحاً.
بطيئة.. ثم سريعة كنوبة بكاء.
خجولة.. ثم جريئة كلحظة رجاء.
حزينة.. ثم نشوى كتقلبات شاعر أمام كأس.
مترددة.. ثم واثقة كأقدام عسكر.
فأستسلم لها. أرقص كمجنون في غرفة شاسعة، تؤثثها اللوحات والجسور.
وأقف أنا وسطها وكأنني أقف على تلك الصخرة الشاهقة، لرقص وسط الخراب، بينما جسور قسنطينة الخمسة تتحطم وتتدحرج أمامي حجارة نحو الوديان.
إيه زوربا!
تزوجت تلك المرأة التي كنت أحبها، وكانت تحبك أنت. وكنت أريد أن أجعلها نسخة مني، فجعلتني نسخة منك.
ومات زياد.. ذلك الصديق الذي اشترى هذا الشريط لأنه ربما كان يحبك أيضا من اجلها، وربما لأنه كان يتوقع لي يوماً كهذا، ويعد لي على طريقته كل تفاصيل حزني القادم.
وربما يكون تلقّاه هدية منها.. وورثته أنا في جملة ما أورثني من أحزان.
ومات حسان.. أخي الذي لم يكن يهتم كثيراً بالإغريق، وبالآلهة اليونانية.
كان له إله واحد فقط، وبعض الأسطورات القديمة.
مات ولا حب له سوى الفرقاني.. وأم كلثوم.. وصوت عبد الباسط عبد الصمد.
ولا حلم له سوى الحصول على جواز سفر للحج.. وثلاجة.
لقد تحققت نصف أحلامه أخيراً. لقد أهداه الوطن ثلاجة ينتظرني فيها بهدوء كعادته، لأشيعه هذه المرة إلى مثواه الأخير.
لو عرفك، ربما لم يكن ليموت تلك الميتة الحمقاء.
لو قرأك بتمعّن، لما نظر إلى قاتليه بكل الانبهار، لما حلم بمنصب في العاصمة، بسيارة وبيت أجمل..
لبصق في وجه قاتليه مسبقاً.. لشتمهم كما لم يشتم أحداً، لرفض أن يصافحهم في ذلك العرس، لقال:
- "أيها القوّادون.. السراقون.. القتلة. لن تسرقوا دمنا أيضاً. املأوا جيوبكم بما شئتم. أثثوا بيوتكم بما شئتم.. وحساباتكم بأية عملة شئتم.. سيبقى لنا الدم والذاكرة. بهما سنحاسبكم.. بهما سنطاردكم.. بهما سنعمّر هذا الوطن.. من جديد".
آه زوربا.. مات زياد وها هوذا حسان يموت غدراً أيضاً.
آه لو تدري يا صديقي، لم يكن أحدهما ليستحق الموت.
كان حسان نقياً كزئبق، وطيباً حد السذاجة. كان يخاف حتى أن يحلم، وعندما بدأ يحلم قتلوه.
وكان زياد.. آه كان يشبهك بعض الشيء. لو رأيت ضحكته، لو سمعته يتحدث.. يكفر.. يلعن.. يبكي.. يسكر.. لو عرفتهما، لرقصت.. حزناً عليهما الليلة كما لم ترقص من قبل.
ولكن لا يهم.. أدري بأنك أنت أيضاً لن تحضر الليلة. ربما لأنك متّ، كما في تلك الرواية، بعد أن لعنت الكاهن الذي جاء ليناولك القربان المقدس قبل الموت..
أو ربما لأنك لم توجد يوماً أبداً على هذه الأرض. لأنك بطل خرافي لزمن كان الناس يبحثون فيه عن خرافة كهذه. عن آلهة إغريقية جديدة، تعلّمهم الجنون والتحدي.. وعبثية الحياة.
فهل مهم أن تتغيب الليلة، كما تغيبوا جميعاً؟
لن أعتب عليك يا صديقي. أنت لست مسؤولاً في النهاية عن كل ما يمكن أن يرتكب من حماقات بسبب رواية!
ولكن أجبني فقط.. أنت الذي قتلت من الأتراك، وقتلوا من رفاقك الكثيرين. هل هناك من فرق بين القتلة؟
على يد الفرنسيين مات سي الطاهر.. وعلى يد الإسرائيليين مات زياد.. وها هو حسان يموت على يد الجزائريين اليوم.
فهل هناك درجات في الاستشهاد؟ وماذا لو كان الوطن هو القاتل والشهيد معاً؟
فكم من مدينة عربية دخلت التاريخ بمذابحها الجماعية، ومازالت مغلقة على مقابرها السرية!
كم من مدينة عربية أصبح سكانها شهداء.. قبل أن يصبحوا مواطنين!
فأين تضع كل هؤلاء.. في خانة ضحايا التاريخ، أم في خانة الشهداء؟
وما اسم الموت عندما يكون بخنجر عربي!
***
ما كادت كاترين تراني في ذلك الصباح حتى صاحت:
- إن لك وجه رجل يستيقظ من ليلة سكر!
ثم أضافت بشيء من السخرية والتلميح الواضح:
- ماذا فعلت أمس أيها الشقي، لتكون في هذه الحالة؟
قلت:
- لا شيء.. ربما لم أنم فقط!
قالت وهي تلقي نظرة على الصالون، وتبحث بفضول امرأة عن آثار تدلها على نوعية من قضيت معهم السهرة:
- هل استقبلت أصدقاء أمس؟
ابتسمت لسؤالها، شعرت برغبة في أن أجيبها: نعم.
يحدث للحزن عندما يجاور الجنون، أن يبدأ هكذا في السخرية من نفسه..
واصلَتْْ:
- وهل قضوا الليلة هنا؟
قلت:
- لا.. رحلوا..
أضفتُ بعد شيء من الصمت:
- أصدقائي يرحلون دائماً!
وربما لم يقنعها كلامي، أو زاد في فضولها فقط. فراحت تواصل بعينيها البحث وسط فوضى الغرفة، والحقيبتين المفتوحتين في الصالون عن شيء ما.
النساء هكذا دائما: لا يرين أبعد من أجسادهن، ولذا لم يكن في إمكان كاترين أن تكتشف آثار زياد وحسان وزوربا.. في ذلك البيت.
في الحقيقة.. لقد كانت كاترين دائماً تعيش على هامش حزني.
ولا ربما اقتنعت دون كثير من الكلام أنني أستيقظ من ليلة حب.
سألتني وكأنها لا تجد فجأة مبرراً لوجودها عندي في تلك اللحظة:
- لماذا طلبتني على عجل؟
قلت:
- لأسباب كثيرة..
ثم أضفت فجأة:
- كاترين.. هل تحبين الجسور؟
قالت بنبرة لا تخلو من التعجب:
- لا تقل لي إنك أحضرتني في هذا الصباح لتطرح علي هذا السؤال!
قلت:
- لا.. ولكن أود لو أجبتني عليه.
قالت:
- لا أدري.. أنا لم أسأل نفسي سؤالاً كهذا قبل اليوم. لقد عشت دائماً في مدن لا جسور فيها. ما عدا باريس ربما..
قلت:
- لا يهم.. فأنا أفضّل في النهاية ألا تحبيها. يكفي أن تحبي رسمي..
أجابت:
- طبعاً أحب ما ترسمه.. لقد راهنت دائماً على انك رسام استثنائي..
قلت:
- فليكن إذن.. كل هذه اللوحات لك.
صاحت:
- أأنت مجنون؟ كيف تهبني كل هذه اللوحات؟ إنها مدينتك.. قد تحنّ إليها يوماً.
قلت:
- لم يعد هناك من ضرورة للحنين بعد اليوم، أنا عائد إليها. أهبها لك، لأنني أدري أنك تقدّرين الفن، وأنها معك لن تضيع..
قالت كاترين وصوتها يأخذ نبرة جديدة لحزن وفرح غامض:
- سأحتفظ بها جميعاً.. فلم يحدث لرجل أن أهداني يوماً شيئاً كهذا..
قلت وأنا ألقي نظرة أخيرة على جسدها المختبئ داماً تحت الأثواب الخفيفة الفضفاضة:
- ولم يحدث لامرأة قبلك أن منحتني غربة أشهى..
قالت:
- أخاف أن تندم يوماً وتشتاق إلى إحدى هذه اللوحات.. اعلم أنك ستجدها دائماً عندي.
قلت:
- ربما سيحدث ذلك.. فنحن في جميع الحالات نندم على شيء ما..
تقاطعني وكأنها اكتشفت جدية الموقف:
- Mais ce n'est pas possible .. لا يمكن أن نفترق هكذا!
- أوُ كاترين.. دعينا نفترق على جوع. لقد حكم علينا التاريخ ألا نشبع من بعض تماماً.. ولا نحب بعضنا تماما.. لأكثر من سبب. إنك تملكين اليوم أكثر من نسخة مني.. علّقي على جدرانك ذاكرتي، حتى ولو كانت ذاكرة مضادة.. لقد كنت أيضاً طرفاً فيها!
لا تفهم كاترين لماذا كل هذه الرموز اليوم.
ولماذا هذا الحديث الغامض الذي لم أعوّدها عليه؟
وربما فهمت، ولكن جسدها كان يرفض أن يفهم. جسدها يخرج عن الموضوع دائماً. جسدها موظف فرنسي يحتج دائما. يطالب دائماً بالمزيد.. يفرط في حرية التعبير، في حرية الإضراب.
ولكن..
من أين سآتي بالكلمات التي ستشرح لها حزني؟
من أين سآتي بالصمت الذي سيقول لها دون أن أقول شيئاً، إن حسان هناك في مدينة أخرى، ينتظرني في ثلاجة، وأن أولاده الستة لم يعد لهم غيري.
كيف أشرح لها سر قدميّ الباردتين، والصقيع الذي يزحف نحوي كلما تقدمت بي الساعات، وكلما راحت يداها تفتحان أزرار قميصي دون انتباه.. بحكم العادة.
- كاترين.. ليس لي شهية للحب، اعذريني..
- وماذا تريد إذن؟
- أريد أن تضحكي كالعادة.
- لماذا أضحك؟
- لأنك عاجزة عن الحزن.
- وأنت؟
- وأنا سأنتظر أن تذهبي لأحزن. حزني مؤجل فقط كالعادة..
- ولماذا تقول لي هذا اليوم.؟
- لأنني متعب.. ولأنني سأرحل بعد ساعات..
- ولكن لا يمكنك أن تسافر. لقد ألغوا كل الرحلات إلى الجزار..
- سأذهب، وأنتظر في المطار أول طائرة تقلع. لا بد أن أسافر اليوم أو غدا. هناك من ينتظرني..
كان يمكن أن أقول لها: "لقد مات أخي.. أخي الوحي يا كاترين.." وأجهش بالبكاء. فقد كنت في حاجة إلى أن أبكي أمام أحد يومها.
ولكن لم أكن قادراً على ذلك معها. لعلها عقدة قديمة.. فالحزن قضية شخصية، قضية أحياناً وطنية..
ولذا احتفظت بجرحي داخلي. وقررت أن أواصل حديثي كالعادة. لعلني في يوم آخر سأخبرها بذلك. ولكن ليس اليوم. الصمت اليوم أكبر.
شعرت فجأة أنني أسأت للفراشات.
قلت:
- كاترين.. لقد كانت قصتنا جميلة، أليس كذلك؟ كانت معقدة بعض الشيء.. ولكنها جميلة برغم ذلك. لقد كنت المرأة التي كانت دائماً، على وشك أن تكون حبيبتي. وربما سينجح الفراق في تحقيق ما عجزت كل سنوات القرب هذه من تحقيقه..
- هل ستحبني عندما نفترق؟
- لا أدري.. من المؤكد أنني سأفتقدك كثيراً. إنه منطق الأشياء. لقد كان لي معك أكثر من عادة. ولا بد لي بعد اليوم أن أغيّر عاداتي..
- وهل ستعود؟
- ليس قبل مدة طويلة.. لا بد أن أتعلم الآن الوجه الآخر للنسيان. الغربة أمّ أيضاً ليس سهلاً أن نجتاز الجسر الذي سيفصلنا عنها..
- خالد.. لماذا تحيط نفسك بكل هذه الجسور؟
- أنا لا أحيط نفسي بها.. أنا أحملها داخلي. هناك أناس ولدوا هكذا على جسر معلّق. جاؤوا إلى العالم بين وصيفينْ وطريقينْ وقارّتينْ. وُلِدوا وسط مجرى الرياح المضادة، وكبروا وهم يحاولون أن يصالحوا بين الأضداد داخلهم. ربما كنت من هؤلاء.. في الحقيقة دعيني أبوح لك بسرّ. اكتشفت أنني لا أحب الجسور. وأكرهها كراهيتي لكل شيء له طرفان، ووجهتان، واحتمالان، وضدان. ولهذا تركت لك كل هذه اللوحات.
كنت أود إحراقها، راودتني هذه الفكرة. ولكن لست في شجاعة طارق بن زياد. ربما لأن إحراق بحّار لباخرته في معركة حربية، يظلّ أسهل من إحراق رسام للوحاته في لحظة جنون..
وبرغم ذلك، أريد أن أحرقها حتى أقطع على قلبي طريق العودة إلى الخلف.
لا أريد أن أقضي حياتي، وأنا أسلك هذا الجسر في الاتجاهين.
أريد أن أختار لقلبي مسقطه الأخير..
أريد أن أعود إلى تلك المدينة الجالسة فوق صخرة، وكأنني أفتحها من جديد. كما فتح طارق بن زياد ذلك الجيل، ومنحه اسمه..
.. منذ غادرتها أضعت بوصلتي. قطعت علاقتي بالتاريخ وبالجغرافية. ووقفت سنوات على نقطة استفهام، خارج خطوط الطول والعرض.
أين يقع البحر وأين يقف العدوّ؟ أيهما أمامي وأيهما ورائي؟
ولا شيء وراء البحر سوى الوطن.. ولا شيء أمامي سوى زورق الغربة.. ولا شي بينهما سواي..
على من أعلن الحرب ولا شيء حولي سوى الحدود الإقليمية للذاكرة؟
نظرت إليّ كاترين، ولم تفهم شيئاً..
لقد كانت علاقتنا دائماًً ضحية سوء فهم وقصر نظر. فافترقنا كما التقينا منذ أكثر من قرن، دون أن نعرف بعضنا حقاً.. دون أن نحب بعضنا تماماً.. ولكن دائماً بتلك الجاذبية الغامضة نفسها.
***
وقلتِ:
"الحب هو ما حدث بيننا.. والأدب هو كل ما لم يحدث".
نعم ولكن..
بين ما حدث وما لم يحدث، حدثت أشياء أخرى، لا علاقة لها بالحب ولا بالأدب.
فنحن في النتيجة، لا نصنع في الحالتين سوى الكلمات. ووحده الوطن يصنع الأحداث. ويكتبنا كيفما شاء.. مادمنا حبره.
غادرت الوطن في زمن لحظر التنفس.. وها أنا أعود إليه مذهولاً في زمن آخر لحظر التجول.
أتذكر وأنا أواجه وحدي هذه المرة مطار تلك المدينة الملتحفة بالحداد كلاماً قاله حسان منذ ست سنوات واستوقفتني كلماته دون سبب واضح.
قال: "إن قسنطينة فرغت من أهلها الأصليين. لقد أصبحوا لا يأتونها سوى في الأعراس و في المآتم".
يذهلني اكتشافي.. ها أنا أصبحت إذن الابن الشرعي لهذه المدينة التي جاءت بي مكرهاً مرتين.
مرة لأحضر عرسك.. ومرة لأدفن أخي. فما الفرق بين الاثنين؟ لقد مات أخي في الواقع مثلما متّ أنا منذ ذلك العرس.
قتلتنا أحلامنا..
هو لأنه أصيب بعدوى الأحلام الفارغة الكبيرة.
وأنا لأنني غادرت وهمي.. ولبست نهائياً حداد أحلامي.
يسألني جمركيّ عصبي في عمر الاستقلال لم يستوقفه حزني ولا استوقفته ذراعي.. فراح يصرخ في وجهي، بلهجة من أقنعوه أننا نغترب فقط لنغنى، وأننا نهرّب دائماً شيئاً ما في حقائب غربتنا..
- بماذا تصرّح أنت؟
كان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه.. ولكن لم يقرأني.
يحدث للوطن أن يصبح أميّاً.
كان آخرون لحظتها يدخلون من الأبواب الشرفيّة بحقائب أنيقة دبلوماسية.
وكانت يداه تنبشان في حقيبة زياد المتواضعة، وتقعان على حزمة من الأوراق.. فتكاد دمعة مكابرة بعيني تجيبه لحظتها:
- أصرّح بالذاكرة.. يا ابني..
ولكنني أصمت.. وأجمع مسودّات هذا الكتاب المبعثرة في حقيبة، رؤوس أقلام.. ورؤوس أحلام.
باريس _ تموز 1988
تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
|












 جديد مواضيع قسم الادباء والكتاب العرب
جديد مواضيع قسم الادباء والكتاب العرب










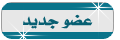




 العرض العادي
العرض العادي



