مملكة الغرباء
قلت لها إنَّني أشمّ رائحة الذكريات.
ابتسمت.
كانت مريم تبتسم حين لا تعرف الأجوبة ثمَّ تتلعثم وتتردّد قبل أن تقول إنَّها لا تعرف أن تعبّر عن فكرتها.
هكذا كانت.
امرأة قصيرة الشعر, واسعة العينين, ظهرها ينحني قليلاً إلى الأمام, تدندن لحنا غريبا لم تقل لي مرّةً من أين جاءت به, وتمشي إلى جانبي صامتةً على ضفّة البحر الميِّت.
كان الأفق رصاصيّا.
رصاصٌ يلوّن ضفّة البحر الميِّت, وأنا أقف. غور الأردن ينخفض بي إلى قاعٍ لَزِج. رطوبة ورصاص ورائحة ذكريات.
الفرق هو القصّة, قالت. الحبّ هو قصّة الحبّ.
لم تكن معي في رحلتي إلى الغور. بلى كانت, رائحتها كانت, وأنا أشمّ رائحة الذكريات, وهي لا تعرف الفرق بين الحبّ وقصّة الحبّ.
قالت إنَّها تحبّني.
يوم التقيت بها في تلك اللّيلة, لم تتلعثم أو تتردّد. قبّلتني وقالت إنَّها تحبّني, ولم تسأل عن الفرق بين الحبّ وقصّة الحبّ.
هكذا بداية الأشياء, تبدو وكأنَّها معلّقة في الفراغ.
التقيت بها, كان ليلٌ وكانت بيروت. التقينا على شرفةٍ معلّقة فوق البحر. كنت عائدا من غور الأردن, رائحتي مبلّلة بالتَّعب, وعلى رأسي غبارٌ من أرض فلسطين. وكانت هناك. جاء أصدقاء لا أعرفهم وسهرنا حتَّى الثَّالثة صباحا. كانوا يرقصون وكنت أشعر أنَّني وحيدٌ وسوف أموت. كنت قادما من الموت. هكذا قلت لها. اعتقدت أنَّني أحاول غوايتها وضحكت.
"(الموت)", قالت, "(يا لطيف)".
وضحكت.
ضحكت أنا ورقصنا. رقصت أمامي, كان جسمها مربوطا بآلاف الخيوط غير المرئيّة. كانت تتحرَّك يمينا وشمالاً دفعة واحدة. لا أذكر كثيرا. أنا لا أعرف أن أتذكَّر الأشياء, هي أخبرتني, أخذتها إلى البحر وركبنا قاربا شراعيّا ومضينا نتوغّل من الشاطئ إلى الأعماق وهناك أخبرتني وكنت أرى الأشياء وكأنَّها ظلال. كأنَّنا ظلالٌ للكلمات. قلت لها إنَّ ما روته يبدو لي معقولاً, (أذكره لأنَّك تروينه). ضحكت. الضحكة لم أنسها; كيف أنسى? كانت ترقص وكنت أرقص, ثمَّ نامت. لم تنم. ذهبت إلى الشُّرفة واستلقت على أرجوحة إسبانيّة مصنوعة من الحبال. مشيت باتِّجاهها. كانت عيناها مغمضتين, ولكنَّها رأتني. رأتني بعينيها ولم تفتح عينيها. رأتني أتقدّم فأزاحت جسمها قليلاً كأنها تترك لي مكانا صغيرا كي أستلقي إلى جانبها. أمسكتُ بطرف الأرجوحة قليلاً وهززتها. كان هواء أيلول. في تلك السنة أمطرت في أيلول. دائما تمطر في أيلول. بيروت في أيلول تبدو مبلّلة ببدايات الشِّتاء. يكون الشِّتاء على طرف ثوبها وكأنَّه على طرف ثوب امرأة. كنت أراها من الخلف, وكان ثوبها طويلاً ومطرّزا برسومٍ حمراء, وهي تركض والماء ينقِّط من طرف الثوب. كانت مريم تنام, وأنا أمسك بحبل الأرجوحة, والهواء المبلّل برائحة الماء يغطّي وجهها.
كان وجهها مغطّى بالماء, بما يشبه الماء. ثمَّ اقتربتُ واستلقيتُ إلى جانبها. لم تقل كلمة, أغمضتُ عينيَّ كما أغمضت عينيها, ورأيتها كما رأتني, وصارت الأرجوحة التي تحملنا كأنَّها سفينةٌ تهتزّ وسط بحر هادئ.
قالت إنَّها فتحت عينيها فوجدت أنَّ الجميع ذهبوا.
أيقظتني, وسألتني ذلك السؤال الذي سألتني إيَّاه آلاف المرَّات. فتحت عينيها وقالت شيئا يشبه (الأهلا), ثمَّ سألتني من أكون. لم تكن تعرف اسمي, وأنا لم أقل لها اسمي. بعد ذلك عرفته, لكنَّها لم تكن تستخدمه أبدا حين تخاطبني. فتحت عينيها وسألتني من أكون, فضحكت, وضممتها إلى صدري وتركتها تتغلغل هناك في الداخل.
في تلك اللّيلة التي أذكرها لأنَّها روتها لي, أو رويتها لها, لا أعرف, ولا أعرف لماذا لا يتوقّف العشَّاق عن رواية حكاياتهم التي يعرفونها. معها تعلَّمت أنَّ الحكاية تُروى لأنَّها معروفة, وأنَّ النَّاس حين يروي بعضهم حكاياتهم لبعض, يحوّلون الماضي إلى حاضر, وأنَّ القصص لا تكون إلاَّ بوصفها ماضيا يحضر الآن.
سألتني من أكون, ونهضتْ من الأرجوحة, فتبعتها. دخلنا إلى الصالون, وكان هناك فراش على الأرض. قالت تعال, وجئت. استلقيتُ إلى جانبها ونمتُ.
(...)
يومها قالت لي إنَّها تحبّني, وضحكت.
لم نضحك لأنّنا لم نصدِّق, ضحكنا لأنّنا صدّقنا. تصديق الأشياء مثل عدم تصديقها يقود إلى الضحك. (خمس ساعات وأنت تطير فوقي, كأنّي أستقبلك وأودِّعك وأنت تضحك).
هكذا قالت.
هكذا كانت تروي القصّة دائما.
(وغدا عندما تنتهي الحكاية سوف نجلس على شاطئ البحر, ونسكر ونضحك ثمَّ نمضي, لا أريد نهاياتٍ حزينة).
تحدّثت عن نهاية الحبّ قبل أن يبدأ. تحدّثت عن الحبّ وكأنّه حكاية تعرفها من بدايتها إلى نهايتها.
(الحكايات لا تنتهي), قلتُ لها.
(ماذا ينتهي?), سألت.
(ينتهي الرَّاوي), أجبتها.
(أنت الرَّاوي), قالت.
(لا, أنا الحكاية).
ضحكت, (أنت هكذا).
(أنا هكذا), قلت. وأخبرتها عن البحر الميِّت, الذي هو بحر الملح وبحر الماء وبحر الحدّ الفاصل بين السَّماء والأرض.
أخبرتها كلّ الحكايات وطلبت منها أن تأتي معي. قالت إنَّها لا تجد مكانا. الزورق مضى وعليها أن تمضي إلى حيث تمضي.
سألتني كيف ينتهي الحبّ, ومضت.
واليوم أراها.
أراها أمامي كامرأة مبلّلة الثّوب بالمطر. أراها من الخلف وهي تمشي مسرعةً في شوارع بيروت المبقّعة بمطر أيلول. أراها وأقول لها إنّني أراها, وأتركها تمضي إلى حيث لا أعلم.
(أنا لا أحبّ الشرفات), قالت.
وقالت إنّها تشعر بدوخة أمام البحر.
وقالت إنّها تحبّني.
وقالت إنّها الحكاية.
اسمها مريم, نسيت أنْ أخبركم أنَّ اسمها مريم, وأنّها بيضاء مثل وداد, وأنّها تملك جسدا يتلوّن بالرغبة حين تأتي الرغبة. وأنها الآن لست أدري.
أخذتها إلى البحر الميّت. أذكر أنّني أخذتها وأنّنا مشينا أمام الأفق الرصاصيّ, وأنّها بكت حين رأت أنوار القدس تتسلّل من خلف مدينة أريحا, وأنّها ركضت وسط الماء المالح وقالت إنّها تمشي على الماء, وأنَّها شربت قنّينة نبيذ أبيض, وأنّها روت لي حكاياتٍ لا تنتهي عن رجالٍ ونساءٍ عرفتهم وأحبَّتهم.
كلّ الحكايات التي أعرفها ولا أعرفها اجتمعت هناك, على تلك الضفّة المكسورة من ذلك البحر المالح الذي كان لونه رماديّا. بحرٌ رماديّ لا يشبه البحار, وخلفنا مدنٌ تنزلق نحو غور الأردن, كأنّها تتساقط إلى تحت الأرض. إلى مكان لا يمكن الوصول إليه, إلى حكايات تدور وتدور وكأنَّها لا تنتهي.
وتدور الحكاية.
عندما رجعت هذه المرّة والذكريات تغطِّيني بدل الغبار, ورغبة الحياة صار طعمها مُرّا وناشفا, أخبرتها حكاية الرَّاهب الذي مات, وحاولت أن ألعب معها لعبة أخبار الحكايات التي نعرفها.
(أنا لم أكن معك), قالت.
(الحبّ هو قصّة الحبّ), قلتُ.
(ومتى ينتهي الحبّ?), سألتْ.
(حين تنتهي القصّة), أجبتها.
(ومتى تنتهي القصّة?).
(حين يموت الرَّاوي).
(ومتى يموت الرَّاوي?).
(هنا يجب تغيير السؤال, يجب أن تسألي: من قتل الرَّاوي?).
(ومن قتل الرَّاوي?), سألتْ.
(لا أعرف).
عمَّ أكتب?
حكايتان, لا, ثلاث حكايات. لست أدري كم عددها, ولا أعرف لماذا تترابط حين أرويها. عندما نكتب فنحن نمتلك أن نقول ما نشاء, كلاَّ, نمتلك أن نقول ما يُقال, نشاء ما نقول, لا العكس.
ولكن لماذا?
لماذا تحضر صورة وداد البيضاء على وجه المسيح مع نهر الأردن, مع المريمات وهنَّ يحطن بالرَّجل الذاهب إلى الموت? هل هي الذكريات حين تُستعاد تختلط وتتحوّل إلى مزيج, إلى حكايةٍ واحدة أصولها في كلِّ الحكايات?
لكنَّها ليست ذكرياتي.
هل أجرؤ يا سيِّدي على أن أقول بأنّ حكايتك هي ذكرياتي? هل أجرؤ يا سيِّدي على أن أنتظر منك جوابا?
قلت لسامية إنّها ليست ذكرياتي, ونحن نقف أمام الجامع المهدّم الذي تحوّل إلى مقبرةٍ في مخيَّم شاتيلا. حتَّى كلمة حبّ لم أتلفَّظ بها. كان اسمها سامية لا مريم. سامية تأتي إلى هذا الحقل الشاسع من الحكايات وتدخل فيها. وتقول إنّها مريم.
الحقيقة أنّني قلت لها بأنّنا سنغيّر العالم. حدّثتها عن تغيير العالم من غير أن أعى ما أقول. قلت نغيّر العالم لأنّنا كنّا نقول ذلك.
على ضفّة البحر الرصاصيّ, سألتني عن العالم.
(هل تغيّر العالم?), سألت.
هذه المرّة لم تتلعثم حين سألتْ, ولم تبتلع نصف كلماتها كما كانت تفعل دائما. أنا الذي تلعثم, فأنا لم أغيّر العالم, ولكنّني اكتشفت أبسط الأشياء وأكثرها بداهةً وسذاجة, اكتشفت أنّني سأموت لأنّ الإنسان يموت, وعندما اكتشفت العالم تغيّر الموت أو بالعكس, عندما اكتشفت الموت تغيّر العالم. أنا لم أغيّره, أنا رأيته, وحين رأيته تغيّر كلّ شيء, أنا وهو وأنتم وهي.
ربَّما, لهذا, تمتزج القصص لتتحوّل إلى هذه الحكاية. فالقصّة, كما لا تعرف مريم, تبدأ حين لا تعود قصّة, وتمتزج بقصصٍ أخرى, عندها لا يموت الحبّ حتّى بعد أن يموت البطل.
وداد الشركسيّة البيضاء, لم تكن تعرف, وهي تأتي بعد رحلة التيه والذّلّ الطويلة لتستقرّ في بيروت, بأنّها سوف تنتهي في حقل الموت هنا, وستتحوّل إلى الأرض التي تفرشها هذه الحكاية لتخبر حكايات عن هذا العالم الغريب الذي لم نغيّره.
لماذا أروي?
هل لأقول لمريم إنّني أحبّها, وقد قلت لها ذلك ألف مرّة? واليوم لم يعد القول يعني شيئا, فهي ليست هنا, ولن تقرأ ما أكتبه, حتَّى ولو قرأت, فلن تعرف أنّني أحبّها. أم نكتب لأننا لسنا أبطالاً?
الأبطال يموتون, وأمّا نحن فنروي حكاياتهم.
فلأُحَدِّدْ. أنا أتكلَّم عن امرأةٍ واحدةٍ اسمها مريم. هذه المرأة هي التي أخذتني إلى خطوط التَّماسّ في بيروت, حيث شاهدت كلّ ذلك الخراب الذي صنعناه, ثمّ صعدتُ وإيّاها إلى مطعم مهدّم كان اسمه (لوكولوس), يقع في الطابق الأخير من بناية عالية تواجه البحر. حملت مريم طنجرة الفاصوليا والرّز التي طبختها في بيتها, وصعدنا الدرجات المحطَّمة والمبنى المتداعي, حتَّى وصلنا إلى مكان المطعم. جلسنا على الأرض لأنّنا لم نجد كرسيّا واحدا, وأكلنا وشربْنا, وروت لي كلّ شيء.
أمَّا سامية فحكاية أخرى.
حين أمسكت سامية بيدي أمام قبر علي أبو طوق داخل مخيَّم شاتيلا, قلت لها مريم, فَحَنَتْ رأسها كأنَّها مريم.
هنا يقع الخلل الأساسيّ.
فالأبطال يَحْنُون رؤوسهم حين نروي حكاياتهم. حتَّى فوزي القاوقجي أحنى رأسه وهو يستمع إلى ذكرياته.
كان قائد جيش الإنقاذ في السبعين من العمر, حين التقينا به في مركز الأبحاث الفلسطينيّ في بيروت. كان يقف في مكتب مدير المركز الدكتور أنيس صايغ ويروي ذكرياته عن بطولات جيشه. ثمَّ وضع رجله اليمنى على الكرسيّ ورفع بنطلونه إلى الأعلى, فرأينا آثار الرّصاص.
(تسع رصاصات), قال.
كان فوزي القاوقجي طويلاً ورفيعا, وإلى جانبه تقف زوجته الألمانيّة البيضاء الممتلئة, وهي تحاول أن تعيد البنطلون إلى مكانه وهو لا يكترث لها.
الأبطال لا يكترثون.
كانت رجل القاوقجي اليمنى طويلة وبيضاء, وقد تساقط الشَّعر منها, ولم يبق سوى أخاديد داكنة تخترقها في كلِّ الأماكن, والزوجة الألمانيّة تحاول أن تشدّ البنطلون وهو لا يكترث.
الأبطال يحكون حين يصيرون أبطالاً.
هل كان الأبطال يعلمون أنَّهم سيصبحون أبطالاً? هل كان علي يعلم وهو يركض تحت القذائف, في أزقّة مخيَّم شاتيلا المحاصرة, أنَّه سيصير بطلاً, وستصير حكايته حكاية?
فوزي القاوقجي صدّق الحكاية.
كان يقف وسط الغرفة, ونحن حوله, ويروي. كنّا قد قرأنا مذكّراته التي صدرت في كتاب. روى لنا أشياء من الكتاب, ونحن نستمع إليه وكأنَّنا لم نقرأ. روى عن التجمّع في غور الأردن, عن مجموعات الفرسان التي التقت في الغور وكيف قطعت النَّهر إلى فلسطين. ولكن لم يكن يخبر الحقيقة. مجموعات الفرسان التي أخبرنا عنها التقت في الغور عام 1936 لا عام 1948. عام 1936 كان القاوقجي يقود كوكبةً من المتطوّعين, وعام 1948 كان يقود جيشا. ولكنَّه حين وقف أمامنا ليروي لم يميّز بين الحربين. روى عن نفسه وكأنّه وُلِد قائدا لجيش الإنقاذ. واستمعنا إليه وصدّقناه. لماذا لا نصدّقه? ما الفرق بين 1936 و1948? وغدا عندما سأقف أنا, أو سيقف عليّ, عليّ لن يقف لأنَّه مات, لكن لنفترض أنَّ عليّا لم يمت. علي يصلح للوقوف أكثر منّي, لأنَّه مثل القاوقجي, كان مصابا بخمس طلقاتٍ في رجله. وعندما التقيت به للمرّة الأولى, كانت قدمه اليسرى داخل الجفصين, وكان يمشي متكئا على عصا ويعرج. بعد أن شفيت قدمه ولم يعد يعرج ظلَّ يحمل العصا, وحين يتذكَّر نفسه كان يعرج قليلاً. لكأنَّه اعتاد على أن يعرج ولم يعد يريد أن يمشي كما كان يمشي قبل أن تصيبه الطلقات في قدمه اليسرى على مدخل حيّ البرجاوي في بيروت.
لنفترض أنّ عليّا كان يروي.
لنفترض أنّني أقف ومعي مجموعة من النَّاس, في مركز الأبحاث الفلسطيني نفسه, الذي حوّلوه إلى مقبرة بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982, حين نسفوه بسيَّارة مفخّخة, فماتت حنّة شاهين القادمة من (فسوطة) في الجليل, وصارت سعاد كسيحة, ودخل ثلاثون من العاملين فيه المستشفيات, وبقيت أشلاء الموتى في شارع (كولومباني) ثلاثة أيَّام قبل أن يأتي عمَّال التنظيفات ويرشّوا الحيّ بالماء والمبيدات.
لنفترض أنّ كل شيء عاد كما كان, وأنّ عليّا يقف والكهولة تغطِّي شعر رأسه, ويروي لنا ذكرياته.
ماذا سيروي?
هل سيجد متّسعا في الذاكرة ليميّز بين معارك أيلول 1970 في الأردن, وبين حصار مخيَّم شاتيلا في بيروت عام 1985?
أم كان سينسى قليلاً, ويخبرنا عن سامية وكأنَّها كانت رفيقته في قواعد الفدائيّين في (غور الصافي); ويحدثنا عن أولاده الذين يدرسون في عمَّان, مع أنّهم كانوا سيدرسون في تونس?
أراه أمامي كما رأيت القاوقجي.
القاوقجي كان طويلاً ورفيعا, وأمّا عليّ فكان قصيرا ونحيلاً وله لحية كثَّة وحاجبان مقفلان. أراه يحكي عن بطولاته وينسى التواريخ.
(لماذا تصدّقون?), سألت مريم.
(لا أعرف), جاوبتها. (نصدّق لأننا نشعر بالهزيمة, المنتصر معنيّ بالحقيقة, يقسّم الزَّمن إلى مراحل, ويميّز بين مرحلة ومرحلة لأنّه يريد أن يسيطر على الماضي والمستقبل, وأمّا نحن?).
(نحن ماذا?), سألتْ.
(نحن لم ننهزم بعد), قلت.
(وماذا تسمّي ما يجري?).
(هزائم, لكنّنى لا أستطيع أن أصدّق).
(لا تصدّق لأنّك مهزوم, تصدّق حكاياتك وتنسي الحقيقة).
ومريم كانت تعلم.
قالت لي إنَّها كانت تعلم أنَّ الفتى سوف ينظر إليها, وستمتلئ عيناه بالرَّغبة. نسيت أن أخبركم أنَّنا حين صعدنا إلى المطعم المهدَّم, كانت الحرب قد انتهت, وكان الجيش اللّبنانيّ قد انتشر في الوسط التِّجاريّ. ذهبنا أنا ومريم إلى مطعم (لوكولوس), ورأينا الجنود المتعبين جالسين على الأرض بين الرّكام والدمار. كانوا من (فوج الأغرار). سألنا المجموعة التي كانت تشعل نارا قرب مبني المطعم من أين هم, فقالوا من الشمال. دعوناهم إلى الغداء معنا فتردَّدوا. كانوا خمسة جنود, صعد ثلاثة معنا وبقي اثنان تحت. كان الفتى الطويل الأسمر ذو الشَّارِب الأسود الرَّفيع ينظر إلى مريم, وهي تبتسم له. ثمَّ بدأ يخبرها حكاياتٍ عن عائلته. وأمَّا أنا فلم أستمع, كنت مدهوشا بقدرة مريم على الاستماع وعلى دفع الآخرين إلى الكلام. ثمَّ اختفت, نزلت مع الجنديّ الطَّويل الأسمر كي تسكب الطَّعام للجنديّين اللَّذين بقيا تحت للحراسة, ولم تعد إلاَّ بعد وقتٍ طويل.
الوقت طويل.
هكذا شعرت عندما غرقت في البحر, كان الوقت طويلاً.
فأنا كنت أعرف أنَّني لن أصير بطلاً. مرَّة واحدة حاولت البطولة وفشلت. خرجت من مركب الصَّيد, كان ذلك في بحر (عين المريسة) وكنَّا نصطاد السَّمك. خرجت ومشيت على وجه البحر. قلت لهم إنَّني سأمشي على وجه الماء ومشيت. كلّهم رأوني أمشي, هكذا قالوا لي, وأمَّا أنا فغرقت. وجدت نفسي أغوص والماء يصبح كالغطاء فوقي. بطرس الرَّسول خاف وهو يغرق, غرق لأنَّه خاف, فاستيقظ المسيح وأنقذه. وأمَّا أنا فلم يأتِ أحدٌ لإنقاذي. كنت لا أريدُ أحدا. كنت أريد أن أمش وأن أغرق. غرقت ولم أمشِ. كلّهم قالوا إنَّهم رأوني أمشي, وأمَّا أنا فغرقت. ثمَّ صدَّقت ما قاله الآخرون. هذه هي البطولة, أن تصدِّق ما قاله الآخرون لك.
ومريم صدَّقت أنها ذهبت مع الجنديّ الأسمر الطويل. أنا قلت لها ذلك وهي صدَّقت, لذلك صارت تصلح للكتابة.
روت لي أنَّها شعرت بحنانٍ نحو الفتى, تركته يقبِّل يدها ثمَّ رأته يموت.
(قبَّل يدي ومشى), قالت.
(رأيته يمشي وسط الشَّارع, وكان يشير إليّ بأن أتبعه. أردت أن أتبعه لكنَّني بقيت جامدةً في مكاني, وسمعت صوت الانفجار).
رأت مريم الفتى يموت حين انفجر به لغمٌ وسط الشَّارع. لم تقترب منه لأنَّها خافت من أشلائه التي انتشرت على الحيطان.
هذه هي البطولة.
أن تصدِّق ما يرويه الآخرون عنك, ثمَّ تصبح حكايتهم وتموت.
الخلل الوحيد في حكايتي هو أنَّني لم أمت, كذلك فوزي القاوقجي حين رفع قدمه اليمنى ووضعها على الكرسيّ, وأخبرنا عن مقتل ابنه في ألمانيا. لكنَّه صدَّق. وأمَّا أنا فلا. الصدق لا.
عمَّ أكتب?
(أين الحكاية?), سألتني مريم.
قلت لها إنَّني أروي حكاية سامية لا حكايتها. وأنا أعرف أنَّ ما رويته حتى الآن لا يصلح حتَّى كمقدِّمة لحكاية البحر الميّت أو حكاية وداد أو إميل.
لكنَّني لا أكتب قصّة.
أترك الأشياء تأتي. أقول إنَّني أروي الحكاية كما هي, وكنت أريد أن أضيف: دون زيادة أو نقصان, لكنَّني عدلت عن ذلك. فوداد الشَّركسية التي ماتت منذ عشر سنوات تشبه هذه الدمية المكسورة التي أراها الآن على شرفة مكتب القوميسيون لصاحبه جورج نفَّاع. مسكين جورج نفَّاع. أقول مسكين لأنَّه مات. أحزن عليه دون أن يكون لذلك علاقة بالشَّاعر فؤاد غبريال نفَّاع الذي مات هو أيضا, ولكنَّه بقي في ذاكرتي كأنَّه تمثال. يمشي في طرقات (الأشرفيّة) التي اسمها أيضا (الجبل الصغير), يحوم حول بيت جوليا قرب مقرّ الصليب الأحمر, وفي جيب سترته أوراقٌ مجعلكةٌ هي ديوانه الجديد. يدخِّن (البافرا) ولا يردّ السَّلام على أحد. مسكين فؤاد غبريال نفَّاع, هو أيضاً مات. هكذا يبرِّر الأحياء خياناتهم للموتى ببعض الكلمات العاطفيّة التي لا معنى لها. نحن نخون الموتى بشكلٍ دائم, الكتابة عنهم هي ذروة خيانتهم. لكن هذا ليس صحيحا. مجرَّد استمرارنا في الحياة, رغم كلّ هذا الموت, هو خيانة. ولذلك نلجأ إلى الذكريات كي لا نخون, ولكن في النهاية ماذا نذكر? لا نذكر سوى أنفسنا.
وحدها سامية, حين روت لي عن موت عليّ, لم تروِ عن نفسها. في العادة يخبرونك عن موت الآخرين كي يتحدَّثوا عن أحزانهم أو عن آلامهم. سامية حين تحدَّثت عن موت عليّ, روت عن جسده الممزَّق بالشَّظايا, وكيف أقفل الطبيب الباب على الغرفة حيث حاول معالجته رغم علمه بأنَّه ميّت.
لم تسقط دمعة واحدة من عينيها السوداوين, كان هناك ما يشبه الضّباب حول عينيها وهي تمسكني بيدي أمام الجامع المهدوم الذي تحوَّل إلى قبر. كان الطبيب الذي عالج عليّا ميِّتا وحاول أن يردَّ إليه الحياة, قبل أن يخرج من الغرفة ويغرق في دموعه, رجلاً يونانيّا يُدعى الدكتور (يانو), عمل مع (الهلال الأحمر الفلسطينيّ) منذ عشر سنوات, حين كان يتابع دروسه في القاهرة. يوناني هاجر أهله إلى كندا, يدرس في القاهرة. ثمَّ يصبح الطبيب الوحيد في مخيَّم شاتيلا الذي حُوصِر ثلاث سنوات متواصلة. تلك حكاية تستحقّ أن تُروى. الدكتور (يانو) ألَّف كتابا عن حصار المخيَّم وعن مقتل عليّ. وروى لي كيف جاؤوه بعليّ ميِّتا.
أخذته, قال, حملته بين ذراعيّ وأدخلته غرفة العمليَّات. وضعته أرضا وأقفلت الباب بالمفتاح. كنت أعرف أنَّه مات, لكنَّني لم أصدِّق. كانت الارتجافة التي لم تتوقَّف في جسده توحي بأنَّ هناك شيئا أكبر, من الطبّ والعلم. رأيت روحه. كانت هذه التي انتفضت في جسمه لمدّة نصف ساعة أو أكثر هي الرُّوح التي تنسحب بوحشيّةٍ فظيعة من الجسد الميّت وكأنَّها لم تكن تريد أن تغادره, كأنَّها فُوجئت بالموت وأرادت أن ترفضه. الجسم كان ميّتا, عرفت ذلك حتَّى قبل أن ألمسه. حملوه وكان ينتفض كالمذبوح, كان مذبوحا في صدره وميّتاً. أخذته منهم وحملته بين ذراعيّ وكأنَّني أحمل طفلاً. عاد عليّ طفلاً, فجأة زالت القسوة عن وجهه وعاد طريّا ومرتجفا كطفلٍ وضعته أمّه منذ ثوانٍ قليلة. وضعته على الأرض وقلت لهم أن يخرجوا. أخرجتهم وأقفلت الباب بالمفتاح. لم أفعل شيئا. مزَّقت القميص ورأيت الجروح والشظايا والدمّ الذي كان قد توقَّف عن التدفُّق وكأنَّ هناك شيئا منعه, كأنَّ سدّا أُقيم ليمنع الماء. دمه كان كالماء, لكنّه جمد. نظرتُ إلى عينيه نصف المغمضتين وأغلقتهما بأصابعي, كانتا طريَّتين كوردتين ذابلتين. عرفت الموت من العينين. فجأة تذبل العيون كما تذبل الزهور. العين زهرة الجسد, العين ملجأ الروح. فقدت روحه ملجأها وبدأت تبحث عن مكانٍ تذهب إليه.
كان الجسد ينتفض وأنا الطبيب الذي أنقذ حيوات مئات الجرحى وجدت نفسي عاجزا عن إنقاذ حياته. كان هذا الرّجل أقرب إنسانٍ إليّ. كنت وحدي في هذا المخيَّم المحاصر بالدَّمار والخوف. كنت وحدي, ولولاه لمتُّ خوفا من الوحدة. الآن أراه أمامي يموت. مات قبلي وأنا لم أفعل شيئا. فجأة خلعت جلد الطبيب عنِّي. لم أشعر أنَّني ساحرٌ إلاَّ في هذا الحصار. هنا شعرت أنَّني نصف إله. أنقذ النَّاس بالأعجوبة وحدها. هل تعلم ماذا يعني أن تكون طبيبا في مثل هذه الشروط التي كنت فيها? لا أحد يعلم, نقصٌ في المضادَّات الحيويّة, نقصٌ في البنج, نقصٌ في الممرِّضين, نقصٌ في المازوت من أجل تشغيل مولِّد الكهرباء, كلُّ شيءٍ ناقص, وأنا أصنع العجائب. يوم عليّ سقطت الأعجوبة, ورأيت الموت وأحسست بالعجز المطلق. رأيت روحه وجلست أرضا إلى جانب جسده. أردتُ أن أدلِّك الجسد المرتجف أمامي كي أساعد الروح على الذّهاب. ولكنَّني لم أجرؤ, خفت, جلست إلى جانبه وكنت خائفا. وعندما همد جسده أحسست بما يشبه الإغماء. أحسست بحاجةٍ إلى النَّوم. كدت أنام. سمعت قرعها على الباب. عندما فتحت قالت إنَّها تقرع منذ نصف ساعة ولكنَّني لم أسمعها, لم تسألني عنه, لم تسأل. سامية كانت تعرف. اقتربت منه وألقت عليه نظرة وكأنَّها تغطيه. أخذتني من يدي وقالت لي إنَّني مُتعب ويجب أن أذهب وأرتاح. خرجت من الغرفة وتركتها معه. سمعتها تقفل الباب خلفي. لكنَّني لم أسألها شيئا. لم أسألها لأنَّني نمت عشر ساعاتٍ متواصلة. نمت كالقتيل, ولم أسمع القذائف ولم أحلم بشيء.
الطبيب اليونانيّ يدلّني على المستشفى. أرى غرفاً شبه محطَّمة وستائر مفتوحة وكأنَّها معلَّقة في الفراغ. أمشي إلى جانبه وهو يريني غرفة الأدوية. أشمُّ رائحة الدَّواء وأسأل عن غرفة العمليَّات, والطبيب يبتسم. سامية لم تتكلَّم, كانت تنظر إلينا. سمعته وهو يروي لي كيف مات عليّ ولم تقل شئيا.
كانت تشرب قهوتها وتضع يديها الاثنتين حول الفنجان وكأنَّها تدفئهما, وتبتسم. رأيت ظل ابتسامة صغيرة على شفتيها.
تكرَّرت هذه الابتسامة في ذاكرتي إلى ما لا نهاية.
طبعا رحل الطبيب اليونانيّ إلى كندا أو إلى بلادٍ أخرى, لست أدري, وعليّ بقي في مكانه, جسده يرتجف, وروحه تمتدّ فوق المكان, وأصوات قذائف مختنقة تملأ الفضاء.
أمَّا شرفة جورج نفَّاع فكانت كأنَّها معلَّقة وحدها في الفضاء.
غبار, وهذا الدّمار الذي يلفّ الوسط التجاريّ في بيروت, والنَّاس يمشون بين الخرائب وكأنَّهم يفتِّشون عن مدينتهم الضائعة, أو كأنَّهم يكتشفونها. وعلى جانب الشّرفة برزت الدمية, دمية امرأة عارية جسدها ورديّ وشعرها أشقر, ويدها اليسرى مكسورة, واليمنى ممدودة, تلتفت منحنية إلى الخلف وسط صناديق كرتونيّة ممزَّقة, وأثاث محطَّم, ويبدو أنَّها وضعت على الشّرفة كي يتخلّص منها الذين دخلوا الشّقّة لسرقتها.
(إنَّها شركسيّة, انظر), قالت مريم.
كانت الدّمية شركسيّة, هكذا كان النَّاس يرون الشَّركسيَّات, شقراوات الشَّعر بأجسادٍ بيضاء تميل إلى اللَّون الوردي.
كنَّا ننحدر من كنيسة (الكبُّوشيّة) باتّجاه شارع البطريرك حويِّك, ونحن نبحث عن مطعم (لوكولوس), حين رأينا الدُّمية الشَّركسيّة على شرفة جورج نفَّاع.
(إنَّها وداد البيضاء), قالت مريم.
مشينا باتّجاه شارع الحويّك.
(هنا مات خليل), قلت لها.
(أنت تنسى), قالت, (لقد روت لي ذلك ألف مرّة).
ماذا أكتب?
(أين الخلل?), سألتها.
(لا شيء), قالت.
ونزلت الدمية. كانت مريم تحاول أن تركض باتّجاه الشَّارع حين رأت الدمية. لم تكن دمية, بل امرأة. امرأة في السَّبعين من العمر, بيضاء بيضاء, كانوا يسمُّونها المرأة البيضاء, هكذا روى جورج نفَّاع عن زوجة أبيه. قال إنَّها البيضاء, وقال إنَّ والده أشهر إسلامه من أجلها. في البداية لم تكن الحكاية جدِّيّة. كان إسكندر نفَّاع شريكا لليهودي وديع السّخن في محلّ القوميسيون الشَّهير, الكائن قرب مكتبة أنطوان, خلف ساحة رياض الصّلح.
وجاءوا بها.
كانت فتاة لا تتجاوز الثالثة عشرة, تبدو مذعورة وخائفة ولا تتكلَّم العربيّة. واشتراها. في تلك الأيَّام, كانت مجموعة من التُّجار وقطَّاع الطرق تعمل بين بيروت والإسكندريّة وروسيا, تخطف الفتيات أو تشتريهنَّ, وتبيعهنَّ في أسواق الرّقيق الأبيض في القاهرة ودمشق وبيروت. كان ذلك سنة 1920, سنة إعلان دولة لبنان الكبير, وبيروت تنفض آثار الحرب العالميّة الأولى, وذكريات المجاعة التي لم تنجُ منها عائلة نفَّاع إلاَّ بفضل حرص نسيم والد وديع السّخن, وشريك إسكندر, وقدرته على تهريب القمح من حوران, وبيعه لبعض العائلات الغنيّة في بيروت.
جاء إسكندر نفَّاع إلى بيته, وكان في الخمسين, ومعه الفتاة الشَّركسيّة المذعورة التي اشتراها. لم يقل لزوجته مدام لودي إنَّه اشتراها. قال إنَّها خادمة. ودخلت الخادمة البيت وبدأت الحكاية.
لست أدري لماذا تذكَّرت وديع السّخن حين التقيت إميل آزاييف. كان إميل هو أوَّل رجلٍ إسرائيليٍّ ألتقيه في حياتي.
نيويورك 1981.
الحرب الأهليّة في لبنان تحوَّلت إلى (وجوهٍ بيضاء), وأنا في نيويورك أُعدُّ بحثا أكاديميّا عن الحكايات الشعبيّة الفلسطينيّة, وأبحث عن شخصيّة جرجي الرَّاهب.
في مكتبة جامعة كولومبيا, التقيت إميل. كان أسمر, كثّ اللّحية, يتكلَّم الأميركيّة بلهجةٍ شرقيّة, ويمطّ الحروف ويتركها تمتدّ, فتصبح الكلمة عنده واسعة تحتلّ حيِّزا, لا على طريقة الأميركيّين الذين يقبضون على الكلمات ويتركونها تتطاير من أفواههم.
إميل آزاييف قدَّم نفسه بوصفه طالبا إسرائيليّا يعيش في نيويورك, ودعاني لحضور فيلم قصير, أخرجه أحد أصدقائه عن (كندا بارك) في القدس, أى عن القرى الثلاث عمواس وبيت نوبا ويالو, التي دمَّرها الإسرائيليُّون فور احتلالهم الضفّةَ الغربيّة عام 1976, وحوَّلوها إلى (كندا بارك), من أجل توسيع مدينة القدس.
على ضفّة البحر الميّت رأيت صديقي إميل.
كنَّا نجلس في الغور, وسط سماءٍ رصاصيّة.
العودة إلى عمَّان هي عودة إلى مدينةٍ لا تنضب ذاكرتها. ربَّما لأنَّنا حين ذهبنا إليها للمرَّة الأولى كنَّا ممتلئين بذلك الشَّوق إلى البداية, الذي يموت مع التقدُّم في العمر.
من عمَّان ذهبنا إلى الغور, إلى نهر الأردن, حيث بدأت معموديَّتنا بالماء والرُّوح والدمّ.
وأمام النَّهر التقيت به.
كان المسيح في كلِّ مكان. يقف وسط المياه الضّحلة التي حوَّل الإسرائيليُّون مجاريها, فصار النَّهر كمجرى صغيرٍ موحل. هناك في المجرى الصغير الموحل رأيته. السيِّد يقف وحده كغريب. وأنا أمامه. يومها سألوه كما سيسألونه كلّ يوم, (هل أنت إيليَّا?) وسيجيبهم كما أجابهم دائما, (لا).
هذه المرّة سألوني أنا. لست أدري من أين جاؤوا, ولماذا, فجأة رأيتهم أمامي, وسألوني: (هل أنت إيليَّا?).
قلت: لا.
قالوا: من?
قلت: أنا.
قالوا: من?
قلت: مجرَّد من يكتب هذه الحكاية.
التفت المسيح, وكانت المياه تصل إلى ركبتيه, وهو يقف وكأنَّه يستمع إلى أصواتٍ غامضةٍ لا نسمعها نحن.
التفت وسألني: (أيَّة حكاية)?
(حكايتك يا سيِّدي), قلت.
(ولكنَّها مكتوبة), قال.
(أكتبها لأنَّها مكتوبة), قلت, (نكتب المكتوب, لو لم يكن مكتوبا ما كتبنا).
وسأله رجلٌ من هناك (هل أنت مسيَّا), (أنت قلت), أجابه. لم يقل إنَّه هو, تركهم يقولون, وأمَّا هو فقال ما سبق أن قيل.
هكذا يا سيِّدي أكتب المكتوب, وإلاَّ ماذا أكتب?
كان الأفق رصاصيّا, وكان هو وإيليَّا نبيّ النَّار, وهذه المسافة الصّغيرة التي تفصل الأرض عن الأرض.
إميل لم يكن معي.
كنت قد استمعت إلى حكايته في نيويورك, وكان قد أحبَّ كثيرا شخصيّة الرَّاهب, قال إنَّها تصلح لرواية كاملة عن بطلٍ شعبيٍّ عربيٍّ يشبه (روبين هود), ولكنَّه قد يُتَّهم بأنَّه معادٍ للسَّاميّة, واقترح تغيير قصّة خطفه لليهودي.
قلت لإميل إنَّ الرَّاهب لم يخطف أيّ يهوديّ, ولكن الحكاية الشعبية تقول الأشياء كي لا تحدث, إنَّها مجرَّد بديلٍ نفسىّ. إميل أصرَّ على رأيه ولم يقتنع بإمكانيّة أن نكتب الحكاية.
ولكن الفرق كبير, أعني بين حكاية إميل وحكاية وديع السّخن. فوديع السّخن لم يكن يملك حكاية. حكايته أنَّه لا يمتلك حكاية, فوجد نفسه مضطرّا إلى تبنِّي حكاية ما, كي يهاجر إلى إسرائيل بعد الحرب الأهليّة الصغيرة التي حدثت في لبنان عام 1958, يومها باع كلّ شيء, وجورج نفَّاع هو الذي اشترى.
روى إميل.
روى كيف هرب والده ألبير من بولونيا إلى فلسطين.
كان ألبير آزاييف يمشي في أحد شوارع صوفيا عندما رأى الشَّاحنة التي تنقل المعتقلين اليهود الذين كانوا يؤخذون إلى معسكرات الإبادة والموت. وفي الشَّاحنة رأى شقيقه الوحيد. كان رأس الأخ يظهر من النَّافذة المغلقة بالأسلاك. رأى ألبير شقيقه والتصق بالحائط, كان يبحث عن مكانٍ يهرب إليه, فلم يجد سوى الحائط, التصق به وهو يرتجف من الخوف. وهنا بدأ السَّجين يصرخ, قال ألبير إنَّه رأى شقيقه يصرخ وينطّ ويشير برأسه إلى حيث ألبير الذي كاد يسقط على ركبتيه من الخوف الذي كسر مفاصله. هل كان السَّجين يشير إلى معتقليه بأن يأخذوا أخاه أيضا? هل كان يريد أن يقول لهم إنَّ هذا الرَّجل الملتصق بالحائط هو يهودي آخر ويجب اعتقاله? أم كان خائفا على الأخ ويريد تحذيره?
ألبير لا يعرف.
روى الحكاية لابنه مرَّة واحدة, وبقيت المسألة غامضة في ذهن إميل. الأب حين روى كان صوته يتقطَّع بالذّعر.
(هل كان أخي يريد قتلي, أم كان خائفا, والخوف يستطيع أن يجعل الإنسان يفعل كلّ شيء?).
ووصل ألبير آزاييف إلى فلسطين عن طريق الوكالة اليهوديّة. كان يريد الذّهاب إلى سويسرا للالتحاق بالمدرسة الفندقيّة في لوزان, ولكنَّه وصل إلى تل أبيب. اعتبر تل أبيب محطّة إلى لوزان, وهناك التقى بزوجته, وهي فتاةٌ روسيّة الأصل وُلِدت في فلسطين, وبقي معها.
(لم يكن أبي يريد العودة إلى فلسطين), قال إميل.
(لكنّه ذهب), قلت.
(لم يكن يريد العودة), قال.
(الذّهاب), قلت.
وألبير آزاييف ليس مثل فيصل.
كيف أكتب قصّة فيصل, وفيصل مات قبل أن تكتمل قصّته? هل هو الفتى نفسه الذي قابلته بعد مذابح شاتيلا وصبرا عام 1928? لست أدري.
سألت محمد ملص, ولكن المخرج السينمائي السوريّ حين جاء معي إلى مخيَّم شاتيلا لزيارة سامية كان فيصل قد قُتِل. أُصيب فيصل في رأسه قبل مقتل عليّ أبو طوق بثلاثة أيَّام.
محمد ملص الذي صنع فيلما عن منامات الفلسطينيين, لم يضع فيصل في فيلمه, بل نشر نصّ منام فيصل في كتاب.
قال فيصل:
(زيّ ما بيحكوا لنا أهالينا كيف نزحوا من فلسطين بالثمان وأربعين. تماما, شفت أنه إحنا, أهالي المخيَّم, راكبين شاحنات وحاملين أغراضنا, بسّ قال راجعين على فلسطين. بعد ما قطعنا النَّاقورة, شفت بحيرة كبيرة, تطلَّعت وسألت أبوي عنها, قال لي وأك يابا هاي طبريّا مش عارفها? حسّيت ساعتها من كلام أبوي أنّه انشرح صدري, وصرت أتطلَّع, وشفت من الشاحنة الماشية الأرض خضرا خضرا وكلّها شجر زيتون. وبالمنام بسّ, وصلنا إلى فلسطين, ما شفت إلاَّ كلّ أهالي المخيَّم صاروا يتفرَّقون, وصار كلّ واحد يروح على بلده. يللِّي من حيفا راح على حيفا, ويلِّلي من يافا راح على يافا. وشفت حالي بقيت لوحدي, وكلّ أصحابي يلِّلي معاي بالمدرسة راحوا. حسّيت بوحدة شديدة, صرت أقول لحالي, يا ريت نرجع نحن يلِّلي عايشين بالمخيَّم نعمل بلد صغيرة, بلد أو قرية أو مخيَّم, شي زيّ شاتيلا يلِّلي كنَّا عايشين فيه. رحت دغري أدوّر على أصحابي تقول لهم, تعالوا نعمِّر بلد صغيرة, بلد أو قرية أو مخيَّم, شي زيّ شاتيلا يلِّلي كنَّا عايشين فيه. رحت دغري أدوّر على أصحابي تقول لهم, تعالوا نعمِّر بلد بقلب فلسطين, تجمَّعنا مع بعض, وتكون زيّ المخيَّم, بسّ لحظتها فقت).
أفاق فيصل, وكان في الحادية عشرة, أفاق لأنَّه عرف بأنَّه لن يعود إلى فلسطين, بل سيذهب إليها. لا أحد سيرجع, الرّجوع وهم. نعود أي نذهب.
لماذا نذهب إذا كنَّا لن نعود?
(هل عاد اليهود?), سألت إميل.
فيصل عاد مرّة ثانية كي يروي حكاية أخرى. وحكايته الأخرى لم تكن مناما, كانت ما جرى. المنام جرى والمذبحة جرت.
تكدَّس الجميع, وكان فيصل قد أُصيب بثلاث رصاصات في خاصرته ويده. زحف ونام بين أشقَّائه وشقيقاته السبع وأمّه الذين ماتوا برصاص الذين دخلوا مخيَّم شاتيلا ليل 61 أيلول 1982. تغطَّى بالموتى كي يوحي بأنَّه ميّت, ولم يكن ميِّتا. وحين غادر المسلَّحون, ركض في الشَّارع, ثمَّ صار يزحف وسط الجثث الأفقيّة التي وصف جان جينيه سوادها وانتفاخها ودهشتها في الموت, حتَّى وصل إلى حيث الصحافيُّون الأجانب, وهناك أُغمي عليه.
فيصل لم يروِ حكايته الثالثة, لأنَّه في المرّة الثالثة مات.
قال إميل إنَّ هذه المأساة يجب أن تنتهي.
كنت أقف أمام خاصرة البحر الميّت.
يشبه البحر الميّت خاصرة العالم. هكذا كان سيقول محمود درويش لو جاء معي إلى هنا. سيقول إنَّه سيركض إلى هناك ويعود. وسيدخل أريحا, ومنها إلى تلال القدس. أضواء القدس تنبعث من خلف اللّون الرَّماديّ الذي يفصل منخفض الغور عن الأرض.
(هل ستعود?), كنت سأسأله.
وسيجاوب كمن يسأل, (من قال بأنَّ الأرض تورث كاللُّغة?).
وسأخبره عن حكاية القدس. سأخبره أنَّ المتصوِّفين العرب كانوا يعتقدون أنَّ القدس تقع في نقطة هي الأقرب إلى الجنّة والجحيم. على تلالها تستطيع أن تستمع إلى تسابيح الجنّة وتشمّ رائحتها, وفي وديانها تستمع إلى صراخ الجحيم وتشمّ رائحتها. ولذلك كان المتصوّفون يرفضون الإقامة فيها, وينصحون النَّاس بمغادرتها, لأنَّها مدينة البكاء. سوف يهزّ برأسه وهو يستمع إلى الحكاية, ويُصاب بدهشة يحجبها خلف نظَّارتين سميكتين وسيحدِّثني عن (الهدنة مع المغول).
(الهدنة مع المغول مستحيلة), سوف أقول له, (لأنَّ الهدنة تفترض اقترابا من الحقيقة).
(ما الحقيقة?), سألتني مريم.
(إنَّها لقاء كذبتين), هل تستطيع كذبتان أن تلتقيا فوق أرضٍ واحدةٍ لتعطياها حقيقتها?
(أيَّة كذبتين)? سألت مريم.
(إميل والرَّاهب), جاوبتها.
(وفيصل)?
(فيصل لا, إنَّه المنام, إنَّه الحكاية التي أحاول أن أرويها).
(لكنَّك تروي حكاية أخرى).
ماذا أكتب?
لست أدري. أشعر بالكلام يتخلخل ويتفكَّك.
نحن أمام البحر الميّت.
(إنَّه بحر الملح, ويُدعى بحر العربة والبحر الشرقيّ وبحر سدوم. يبعد بحر الملح 16 ميلاً عن أورشليم شرقا, ويُرى جليّا من جبل الزيتون, وهو في أعمق جزءٍ من الغور الممتدّ من خليج العقبة إلى الحولة. طوله 46 ميلاً, وأقصى عرضه عشرة أميال ونصف الميل. ومساحته 300 ميل مربَّع تقريبا. وأمَّا ماؤه فلونه صافٍ, ويحتوي هذا الماء على 25 في المئة من المادّة الجامدة, نصفها ملح اعتياديّ, ومن جملتها كلوريد الماغنيسيوم الذي يكسبه طعمه المرّ. ويذكر حزقيال أنَّ من علامات الحياة في ملكوت الله الجديد, شفاء مياه البحر الميّت, وتكاثر أنواع الأسماك فيه).
(هل مشى المسيح هنا?), سألت مريم.
(لا), قلت, (مشى في بحيرة طبريَّا التي كانت تسمَّى بحر الجليل).
(وهنا)?
(هنا لا أحد).
لكنَّني أراه اليوم, أى سنة 1991, في نهاية هذا القرن المتوحش الذي بدأ بمذبحة وانتهى بجريمة. أراه وحده ميِّتا ومصلوبا ويمشي على وجه المياه.
إنَّه الغريب الوحيد.
غريبٌ في مملكة الغرباء التي حاول تأسيسها, هكذا كانت تعتقد الشَّركسيّة البيضاء.
كانت تقف مرّة في العام, يوم الجمعة العظيمة, في كنيسة (سيِّدة الدخول), تتَّخذ لنفسها مكانا ثابتا في جنازة المسيح, على يمين الأيقونسطاس, قرب كرسيّ المطران, وترتِّل جميع الصلوات, وحين يصل المرتِّل إلى ترتيلة (الغريب), كانت تركع مع الرَّاكعين, وترتِّل بصوتٍ مرتفعٍ, والنَّعش يدور فوق رؤوس المصلِّين. الجميع ينظرون إلى النَّعش وينتظرونه للتبرُّك به, ما عداها, فهي كانت تؤخذ بالغريب ويرتفع صوتها. وكان المرتِّل إلياس متري, المعروف بتشدُّده في أصول التَّرتيل البيزنطيّ, يترك لها فراغات في ترتيلته, ليعطي صوتها مجالاً كي يبرز ويستمع إليه النَّاس.
(أعطني هذا الغريب,
الذي منذ طفوليّته تغرَّب كغريب,
أعطني هذا الغريب,
الذي أماتوه بغضا كغريب,
أعطني...).
كانت ترتِّل, والدّموع في عينيها, وصوتها الأنثويّ الرفيع يتسلَّل من بين ثنايا صوت إلياس متري القويّ, والنَّاس يبكون, والنَّعش يدور, والموت يدور.
إسكندر نفَّاع كان ينظر إلى هذه الغريبة التي دخلت حياته, وكأنَّه يبتلعها بعينيه. كان يريد أن يتحوَّل إلى امتدادٍ لجسدها الأبيض الغريب. صحيح أنَّه لم ينجب منها, ولكنّه عشقها طوال حياته. كانت كهولة, إسكندر نفَّاع سريعة, فلقد تزوَّج بوداد الشَّركسيّة وهو في الخمسين, وكانت هي في الرَّابعة عشرة. وبعد زواجه بثلاث سنوات بدأ يمرض. أُصيب بنوبةٍ قلبيّة, ثمَّ توالت الأمراض. في البداية لم يزره أحدٌ من أولاده الخمسة, تركوه يموت كالكلب, كما أمرت لودي زوجته الأولى. ثمَّ مع الأيَّام, ولأنَّ كهولة نفَّاع طالت إلى ما لا نهاية, عاد الأولاد لزيارته, وهناك تعرَّفوا من جديد على (الكلبة الشَّركسيّة) كما كانت تسمِّيها أمّهم, ورأوها وهي تعتني بالرَّجل وتسحبه من فم الموت, وكأنَّها تحمل في يديها سرّ حياته, وكأنَّ سحرها وجمالها هما الخيط الدَّقيق الذي يربطه بالحياة.
(لولاها لمات أبي).
قال جورج لأمّه.
(الله لا يردّه).
صرخت مدام لودي وبكت.
وبعد إلحاح أولادها زارته, وهناك رأت الشَّركسيّة البيضاء. لم تعد تشبه الخادمات, صارت امرأة. دخلت لودي البيت, وكانت ترتجف بالكراهية. الشَّركسيّة حين رأتها ركضت نحوها وقبَّلت يدها وبكت. ورأى جورج نفَّاع ذلك الجمال الأبيض وهو يتحوّل إلى حكاية.
قلت لمريم عن وداد الشَّركسيّة.
أخبرتها كيف خرجت وحدها من البيت. كانت قد عاشت أيَّاما صعبة. رفضت نصيحة ابن زوجها للمجيء والإقامة معه في بيته. كانت وحيدة تحت القصف والخوف, في منزلها الصغير الذي عاشت فيه ثلاثين عاما وهي تخدم إسكندر المريض, ثمَّ عاشت فيه ثلاثين عاما أخرى لا تزور ولا تُزار. تذهب إلى الكنيسة صباح كلّ أحد, وتعمل في مأوى العجزة كمتطوِّعة, وتحبّ الجميع. وعندما أُصيبت بالمرض, رفضت أن تغادر بيتها. قالت لجورج أن يهتمّ بعائلته وأغمضت عينيها, وسمعها الابن وهي تدندن بَيْتَي الشعر اللّذين كانت تقولهما لوالده لحظة احتضاره.
إسكندر شبه غائب عن الوعي, وداد إلى جانبه تمسك بيده, وجورج وكاتيا وربى وسمر وجاكلين في الغرفة. يفتح عينيه قليلاً, تهرع ابنته كاتيا إلى جانبه, يلتفت ناحية وداد, تنحني وداد إلى جانب رأسه, وتقول شعر امرئ القيس الذي كان يحبّه. وإسكندر يبتسم ثمَّ يغمض عينيه.
(مات مبتسما), قال جورج.
والآن, وداد في فراشها وترفض أن تغادر البيت. انحنى الابن فوقها, فقالت البيتين وابتسمت, لكنَّها لم تمت كما مات زوجها منذ ثلاثين سنة.
أجارتنا إنَّ المزار قريبُ وإنّي مقيمٌ مـا أقــامَ عسيبُ
أجارتنا إنّا غريبان ها هنا وكلُّ غريبٍ للـغريبِ نسيــبُ
قالتهما ولم تمت.
وبعد بضعة أيَّام خرجت إلى الشارع.
لا, لا, قبل أن تخرج, حدث ذلك الأمر الغريب.
وكانت النهاية أكثر غرابة من البداية.
قلت لمريم إنَّ النهاية قد تكون أكثر غرابة. هذه بيروت. فبيروت تحوّل الأشياء إلى نكهة من الغرابة الأليفة. يخبرونك حكاياتهم فتشعر أنّك سمعتها من قبل, ومع ذلك تُصاب بالدهشة. بيروت هكذا, دهشة الأشياء الغريبة التي تعطيك شعورا غامضا بالألفة.
(نحن لا نعرف البداية), قالت مريم. (نعتقد أنّنا نعرفها, ولكنَّنا لا نعرف شيئا). وقالت إنَّ بداية وداد الشَّركسيّة لا نعرفها لا نحن ولا هي. هي نسيت. ماذا ننتظر من فتاة تُخطف من إحدى قرى أذربيجان وهي في الحادية عشرة, ثمَّ تُرحَّل إلى الإسكندريّة, ومن بعدها إلى بيروت حيث اشتراها الخواجة إسكندر?
لم تكن شركسيّة.
إسكندر قال لزوجته إنّه سيتزوَّج الشَّركسيّة, عندما رأته وهو يحتضنها في المطبخ والفتاة تتأوَّه تحت ذراعيه. هذا ما جنَّن الرجل. ذلك التأوّه الذي كان يصدر من العينين اللَّتين لم يستطع إسكندر أن يحدّد لونهما طوال حياته.
دخلت لودي إلى المطبخ ورأتهما فصرخت.
أمّا هو فلم يتحرّك أو يرتبك.
(مع الصَّانعة يا كلب!).
(اخرسي), صرخ, وتزوَّجها.
قال إنّه سيتزوّجها وتزوّجها. لم يصدّقه أحد. خرج إسكندر من بيته وأخذها معه, أشهر إسلامه, أعتقها وتزوّجها, وسكن معها هذا البيت الصغير المبنيّ من الحجارة الرمليّة السميكة, والمطليّ بالأصفر, وتحيط به حديقة فيها ثلاث أشجار فتنة وياسمينة وشجرة لوز. وصار يعزف على العود ويغنّي لها, وهي إلى جانبه. ترك عمله, أو على الأصحّ خفّف من حضوره في الدكّان, واختلف مع جميع النَّاس من أجلها وأحبّها.
لودي قالت لأولادها إنّه مجنون, وإنّ الرِّجال كلاب.
(داروين على خطإ), كانت تقول, (فأصل الإنسان ليس قردا, أصله كلب, والدليل هو الخواجة محمد إسكندر نفَّاع).
وكان إسكندر وزوجته الجديدة يذهبان صباح كلّ أحد إلى الكنيسة. لم يسأله أحد لماذا يصلِّي هنا, بعد أن أسلم, وكيف? وقيل إنّ الشَّركسيّة تعمّدت, ولكن لا أحد يعرف.
أمَّا بالنسبة إلى جورج وشقيقاته الأربع فكانت الحكاية فضيحة. تربّى الأولاد في بيت هجره رجله وتعبق منه رائحة الفضيحة. الأولاد رفضوا زيارة والدهم في البداية, أمّهم منعتهم وأطاعوا أمَّهم, ثم صار الامتناع عن زيارة الوالد طبيعيّا. ولكن حين مرض, وقد مرض بعد ثلاث سنوات من زواجه, بدأوا بزيارته, وأحبُّوا هذه المرأة الصغيرة التي تشبه السَّاحرات.
يذكر جورج نفاع تلك المرأة كظلٍّ أبيض.
عندما أُصيب والده بالذبحة القلبيّة ذهب إلى المستشفى ورآها. كانت تجلس على كرسيٍّ في الجانب الأسفل من السرير وتنظر إلى قدمي الرجل. وبين وقتٍ وآخر كانت تمسّد قدميه بيديها, والدموع متجمّدة في عينيها وكأنَّها بكت طويلاً, أو هي على وشك البكاء.
يومها رآها.
قال جورج لأمل التي سيتزوَّجها بعد خمس سنوات, إنّه رآها يومها. في البيت كانت غير موجودة, كانت كأنّها طيف, وأمّا في المستشفى فتحوّلت إلى شيء آخر. يومها رأى الضوء, رأى امرأة يحيط بها الضوء. كان بياضها يضيء. بياض ليس مائلاً إلى الاحمرار كما هو حال نساء بلادنا. بياضٌ خاصّ, كأنّه مزيجٌ من لونين أبيضين, والضَّوء يشعُّ من داخل فجوة سرّيّة بينهما.
عاد إسكندر إلى بيته بعد أسبوعين, وصار جورج يزور والده كلّ يوم. وفي كلّ يوم كان يراها تمشي بصمت وكأنَّها لا تمشي. يسمع خشخشة ثيابها ولا يسمع وقع قدميها أو صوت تنفُّسها. كأنّها ممرِّضة. في تلك الأيَّام لم يكن جورج ولا شقيقاته يتكلَّمون معها. كانوا يأتون لزيارة والدهم فيرونها لحظةً ثمَّ تختفي. يمدّ جورج يده فتعطيه يدا صغيرة طريّة, ثمَّ تنسحب إلى المطبخ, تعدّ الشاي والقهوة وتعود.
تجلس على كرسيٍّ في الجانب الأسفل من السرير, وبين وقت وآخر, تمدّ يدها وتمسّد قدمي الرجل. وقبل أن يطلب شيئا كانت تعرف. يرفع رأسه ليطلب الماء, فيكون الكوب قد وصل إليه قبل أن يطلبه. وجورج ينظر إليها ويخاف أن يسأل. هل يمكن أن ينام رجلٌ مع هذه المرأة? إنّها كالطّيف الشفَّاف, فهل يمكن تمزيق هذا الحجاب من الصَّمت الذي يحيط بها?
ومرَّت الأيَّام.
لم يسأل جورج والده شيئا عنها. مرّة واحدة سأل عن الذكريات وعن أهل الفتاة واسم قريتها أو مدينتها. نظر إليه الأب بعينين نصف مغمضتين, حين يريد أن يوحي لزوجته لودي أو لأولاده بالغضب. نظر الأب بعينيه نصف المغمضتين إلى ابنه كي يجبره على إقفال الموضوع. ولكنّ جورج لم يقفله. لم يكن جورج آتيا في الأصل لمناقشة هذا الموضوع مع والده, كان قد قرّر أن يفاتح والده في موضوع العمل والزواج. قرّر جورج بعد أن أنهى دراسة إدارة الأعمال في الجامعة الأميركيّة في بيروت, أن ينزل إلى الشغل ويستلم الدكَّان. هكذا اتّفق مع أمّه لودي. قالت له أمّه إنّ عليه أن يرث الآن.
(أبوك مريض ويمكن يموت بأيّ لحظة. روح وخود كلّ شي, ما تقبل إلاَّ تستلم وحدك, وكلّ شي إلك. بكرا بيموت وبتورثنا الصَّانعة).
تابع جورج أسئلته عن الذكريات, فقال له أبوه (اسألها أنا لا أعرف). لم يسألها جورج, خاف أن تكون عارفة, خاف أن تجاوبه بأشياء لا يريد سماعها.
لو سألها لكان حصل على الجواب نفسه الذي سمعه من والده. فوداد البيضاء كانت لا تعرف. ما تعرفه يعرفه إسكندر, وما لا يعرفه إسكندر مُحي من الذَّاكرة. حتَّى تلك السنة التي قضتها في الإسكندريّة خادمةً في منزل آل خيَّاط اللبنانيّي الأصل الذين كانوا يملكون باخرتيْ شحن تعملان على خط الإسكندريّة - بيروت - مرسيليا, غابت في ذاكرتها, وتحوّلت إلى ما يشبه الطَّيف.
سكت جورج, وكان الأب مستلقيا على السرير يتنفَّس بصعوبة.
قال جورج عن العمل..
فتح إسكندر عينيه وقال طبعا. قال له أن ينزل إلى الشغل غدا, وأنَّ وديع السخن سوف يعطيه كلّ شيء ويعلّمه كلّ شيء. (هو مثلي), قال إسكندر, (عامله كما تعامل والدك). ثمَّ طلب من البنت أن تأتي. أتت راكضة. يومها فهم جورج سرّ مشيتها الصَّامتة. كانت لا تلبس حذاء, تمشي في البيت حافية. لم يرها جورج إلاَّ مرّة وهي تلبس حذاء, حتَّى عندما تخرج من البيت, كانت تلبس إسكربينة مطَّاطيّة لا كعب لها, وتمشي وكأنَّها حافية. رآها جورج وهي تأتي مسرعة وتمشي كأنّها تطير.
جاءت البنت.
أشار لها إسكندر بيده. ذهبت وعادت وهي تحمل الأوراق. أعطى إسكندر الأوراق لابنه. كانت أوراقا رسميّة موقّعة عند كاتب العدل, وتحتوي على تنازل عن الدكّان ومحتوياته للابن. أخذ جورج الأوراق وقرأها, وانحنى يريد تقبيل يد والده. أزاح الوالد يده وأشاح بوجهه. كان إسكندر نفَّاع يبكي.
ذهب جورج دون أن يسأل عن الأمر الثاني. جاء من أجل الزواج لا من أجل الدكَّان. لم يكن مقتنعا باقتراح والدته. كان يعتقد أنَّ الأمر سابق لأوانه, وأنَّه لن يستطيع أن يحدّث والده عن الميراث والموت. ولكن إسكندر والشَّركسيّة كانا قد أعدّا كل شيء. أخذ جورج الأوراق وجلس صامتا, يستمع إلى بكاء والده الصَّامت, ويرى انحناءة الشَّركسيّة البيضاء على قدميه.
في زيارات جورج المتكرِّرة لوالده, لم يكن إسكندر يريد أن يسمع شيئا عن الدكَّان. كان يكتفي بمراجعة الحسابات وتوزيع الأرباح بينه وبين ابنه. شفي إسكندر. كان الدكتور نجيب قد قال لجورج, بعد الذبحة القلبيّة الثالثة التي أصابت والده, إنّ إسكندر لن يعيش. فانسداد الشرايين لن يترك له متّسعا من الوقت. ولكنّه عاش كما في أعجوبة. لودي التي انتظرت موته, وانتظرت تلك اللَّحظة التي ستركع فيها الشَّركسيّة البيضاء تحت قدميها, كي تطلب منها أن لا تطردها من البيت, أو أن تعيدها إلى العمل عندها كخادمة, انتظرت طويلاً, وماتت قبل أن يتحقَّق حلمها.
عاش إسكندر بأعجوبة الحبّ, هكذا قال لابنه عندما جاءه ليحدّثه عن الزواج. جاء جورج في الصباح الباكر, كان ذلك في أيلول. الأرض مبلّلة بمطر الصيف الذي يفتح الرئتين على رائحة الأرض. جاء, وكان الأب كعادته كلّ صباح, يجلس في الحديقة قرب شجرة الياسمين, يشرب القهوة ويدخِّن نارجيلته. لم تكن الشَّركسيّة معه. كانت في الداخل تتحمّم. هكذا كانت صباحات إسكندر الصيفيّة في الحديقة, قرب شجرة الياسمين, يشرب القهوة وينتظر خروجها من الحمَّام. تخرج من الحمَّام بشعرها الطويل المبلّل بالماء ورائحة عطر الصابون, وتجلس إلى جانبه صامتة وهو يحكي. يحكي لها ما يشاء. ينسى ما رواه, ويعيد روايته بطريقة مختلفة. ينظر إليها فيراها تصدّق. كانت تصدّق كلّ شيء أو هكذا اعتقد إسكندر. جورج عرف بعد موت والده بعشر سنوات أنَّ المرأة البيضاء لم تكن تصدّق شيئا من كلام أبيه. طرحت عليه جميع الأسئلة عن أصل العائلة والعمل وكلّ شيء.
بعد موت الزوج, والعمل الطويل في مأوى العجزة, وحكاية العلاقة مع الصيدلاني الأرمني سيرافيم التي لا يستطيع جورج أن يؤكّدها أو ينفيها, رآها جورج بطريقة مختلفة. رأى في ابتسامتها الصَّامتة مكرا ودهاءً ونظرة إلى باطن الأشياء. سألته كالجاهلة وكانت تعرف, أخبرها عن العمل, وعن وديع السخن وابنه موسى, وعن تجارة الثياب الداخليّة التي كانت أحد فروع تجارتهم, وكانت تستمع كمن يشكِّك في كلّ شيء. كأنّها أرادت أن تعرف دون أن تسأل. كان يجد نفسه منقادا إلى الكلام معها. كأنْ لا حول له. يومها فهم جورج سرّ والده. فهم معنى ذلك الكلام الكثير الذي قاله والده عندما طلب منه الموافقة على زواجه من أمل تبشراني زميلته في الجامعة. لم يسأل إسكندر الأسئلة التقليديّة عن أصل الفتاة وفصلها, كما فعلت لودي وهي تحاول إقناع ابنها بالعدول عن الزواج من أمل, وبالتفتيش عن فتاة غنيّة. سأله فقط عن الحبّ.
(هل تحبّها?).
(طبعا), قال جورج.
(شو طبعا), (عم بسألك عن الحبّ, يعني أنت شفت لمن أنا حبّيت شو عملت وشو صار فيّ, بتحبّها هيك)?
(كيف هيك?).
(يعني متل ما أنا كنت أحبّ وداد).
(وهلق بطَّلت تحبّها?).
(هي مش الموضوع, الموضوع أنت).
(ما بعرف), قال جورج. (بعرف إنّي بحبّها وبدِّي أتزوَّجها).
(الزواج غير الحبّ يا ابني).
(أنت تزوَّجت لأنّك بتحبّ).
(صحيح, أنا تزوَّجت وداد لأنّه ما كان في حلّ تاني. بس وداد كانت قصّة حبّ).
في ذلك الصباح تأخَّرت وداد كثيرا في الحمَّام. لم تأتِ برائحة عطر الصابون لتجلس إلى جانب زوجها, وتسكت كما كانت تفعل كلّ صباح. تركته وحده مع ابنه يتحدّثان حتَّى الظهر, ويومها عرف جورج الحكاية. عرف أنّ والده أصيب بما يشبه الجنون عندما احتضن الفتاة البيضاء في المطبخ, وأنّه لم يعد يعرف كيف يتصرّف, (كأنّني شربت برميل عرق, صرت دائخا في البيت وفي العمل. كنت أريدها. لا, ليس النوم معها فقط, ليس الجنس, الجنس مسألة أخرى, كنت أريدها لي, أريدها كلّها, أريد كلّ شيء).
و(الآن?), سأل جورج.
(الآن, ماذا الآن?), جاوب الأب, (من يحكي عن الآن?, الآن هي لي, لكنّني لا أعرفها, عندما أخذتها إلى فندق (صوفر الكبير) وتزوّجتها اعتقدت أنّها صارت لي, وهي صارت لي بكلّ المعاني, لكن الحبّ يا ابني هو أن لا يكون الآخر لك, هو أن تبقى الهوّة مفتوحة. وداد بقيت هوّة مفتوحة. حاولت أن ألغي الحبّ بالزواج, أن أدجّن الرغبة في السَّرير, ولكنَّني اكتشفت الهوّة, ربَّما لأنّها امرأة غريبة, ربَّما لأنّى أشمّ فيها رائحة غريبة. أرى في أنفها أنّها تشمّ روائح لا نعرفها. ربَّما لأنّها ليست امرأة, والله هذه ليست امرأة, أنت لا تعرف بالنسوان).
(...)
جورج قال لأبيه إنّه لا يشعر هكذا, وأنَّ الأمر مختلف. قال إنّه يريد الزواج من أمل لأنّه يشعر أنّها زوجته. يشعر أنّه لا يستطيع شيئا من دونها وأنّه يحبّها, ويريد منها ولدا.
ضحك إسكندر, (تريد ولدا, أنا عندي خمسة أولاد, لكن في الحبّ لم أنجب أحدا. في الحبّ عشت أنا وهذه البنت ولم نكن بحاجة لأحد).
(لأنّها من عمر أولادك), قال جورج.
(من عمر أولادي, صحيح, لكنّها من عمر أجدادي أيضا. أنت لا تفهم في الأعمار, العمر لا معنى له, العمر شيء خارجيّ, الإنسان لا عمر له, هل تعرف عمرها? أنا لا أعرفه, لكنّني أعرف أنّه قديم وعميق, اذهب واسألها, لن تجاوب, هي لا تجيب, حاولت ألف مرّة أن أسألها, قلت لك إنّني لم أسألها شيئا, كذبت عليك, سألتها ولم تجب. أعرف أنّها لا تعرف الجواب, الجواب في داخلها ولا تعرفه. هي مثل أولادي, صحيح, وهي مثل لا أعرف... مرّات أعتقد أنّني أمام كائن غريب. لم أشعر معها بحاجة إلى الأولاد, وهي أيضا لم تشعر, عشنا بلا أولاد, الأولاد قبل الحبّ أو بعده. لكن لا تخلط بين الحبّ والأولاد).
كان إسكندر يكذب على ابنه, وكان الابن يعرف أن الأب يكذب عليه, ولكنّه لم يقل له ذلك. كان جورج يعرف قصّة طلب وداد لميرنا, وكيف صارت تبكي وتتحوّل إلى ثياب مبلّلة بالدموع, بعد أن رفض إسكندر طلبها تبنِّي الفتاة اليتيمة السمراء التي كانت تعيش في ميتم (زهرة الإحسان). كان جورج يعرف أنَّ الكلام في موضوع الحبّ والزواج والأولاد لا يوصل إلى نتيجة, لا لأنَّ والده يكذب, بل لأنَّ الموضوع يولِّد الكذب. ففي هذه الأمور يصبح الكلام تبريرا للرغبة والحالة. لا يعود الكلام موقفا, وأمّا حكاية العمر التي كانت حجّة والده في دعوته إلى التريّث قبل الزواج من أمل فهي حجّة مضحكة. استمع طويلاً إلى رأي والده في الأعمار, وإلى نظريّته عن وداد التي لا عمر لها, وكاد يقتنع, بل هو اقتنع. ثمّ جاءه إسكندر بتلك الحجّة عن أنّ عمر أمل هو من عمره, وأنّه من الأفضل أن يتزوَّج الرجل امرأة تصغره بعشر سنوات, لأنَّ البيولوجيا النسائيّة مختلفة عن البيولوجيا الرجاليّة, عندها نهض جورج وقال لوالده إنَّ حجّته تافهة.
(طز على البيولوجيا, ما أنا اقتنعت بإنّو مرتك ما إلها عمر, ليش مرتي لازم يكون إلها عمر).
(لأنّو ما بعرف), قال إسكندر, وصمت علامة الموافقة على الزواج.
حكاية العمر كانت تحيّرني وأنا أستمع إلى مريم وهي تروي لي عن ذلك الجنديّ الذي ذهبت معه قرب مطعم (لوكولوس). كان الجنديّ فتى في السابعة عشرة, أو هكذا بدا لي, وكانت مريم في الثالثة والثلاثين. عمرها من عمر المسيح. عندما أخذتها في تلك الأرجوحة على شرفة البحر, كنت أعرف أنّها في الثالثة والثلاثين. شممت فيها رائحة المسيح. هذا هو العمر الذي يتوّج الأعمار. هكذا كنت أعتقد من زمان. يوم علمت أنّهم صلبوه وهو في الثالثة والثلاثين, وقلت أنا أيضا, سوف أموت في الثالثة والثلاثين. وعندما وصلت إلى عتبة ذلك العمر ركبني خوفٌ لا مثيل له. هو كان يعرف أنّه إذا مات لن يموت, وخاف. وأمَّا أنا فلم أكن أعرف, فكيف لا أخاف? مرّ العمر, ونسيت تلك الحكاية عن الخوف من الثالثة والثلاثين إلى أن ذهبت مريم مع ذلك الجنديّ الطويل الأسمر, وتركته يموت. عندما ذهبت معه, ورأيتهما يبتعدان وسط الأزقّة المهدّمة قلت مريم ستموت. أردت أن أصرخ لها بأن لا تموت. وسمعت الانفجار ورأيتها تعود بخطى واثقة ونظرات بعيدة وكأنَّها لم تسمع أو تَرَ. تركتْ الفتى يموت وعادت. كنت أعلم أنَّها تملك نظريّتها الخاصّة في الأعمار. هي أيضا كانت تريد أن تمضي, لأنّها كانت تبحث عن ذلك الوهن الذي يكتسح العينين لحظة تبدأ الرغبة. أرادت أن ترى كيف يبدأ الجنديّ. ولكنّه بدل أن يبدأ مات. لم تقل لي مريم شيئا عن هذه المسائل, لم تقل لي إنَّ الرغبة تبدأ عندما تنتهي العيون. قالت إنّ مروان العاصي لم يكن يحبّها لأنّه كان ملتصقا بعينيه. كانت عيناه تقودانه إلى النَّظر في الأشياء. وأمَّا الجنديّ فقد ضاعت عيناه قبل أن يبدأ بالأكل. حملت طنجرة الفاصوليا وجلست قربه, كان جائعا, ولكنّه لم يأكل. أكل لقمة واحدة وقال إنّه شبع, وكانت هي تأكل. أكلت معي فوق في المطعم المهدّم, ثمَّ نزلت وأكلت مع الجنود. أنا لم آكل, والجنديّ لم يأكل, لكن الفرق أنّه مات وأنا لم أمت. هذه هي المسألة التي تحيّرني في حكايتي مع مريم. لا أريد أن أروي حكايتها الآن, أريد أن أروي رأي إسكندر نفَّاع بالأعمار, وأنا أوافقه, فالأعمار ليست قط بيد الله, وهي طبعا بيده, ولكنَّها أيضا مسألة لا تنتهي عن ماضٍ لا نعرفه. وداد البيضاء كانت بلا عمر, لأنّها جزءٌ من كهف أسود مليء بالذكريات الممحوّة, وأمّا مريم فحكاية أخرى. كنت أراها تنزلق إلى عمرها وتخاف من الكهولة. كنت أراها وأقول لها إنّه لا عمر لها, ولم تكن تصدّقني, ظلّت لا تصدّقني حتَّى ذهبت مع ذلك الجندي وتركته يموت, يومها عادت وقالت إنّها صدّقتني, ولكن الأوان كان قد فات. لم أعد أنا أصدِّقها. صرت أراها مثل ثوب ينزلق عن جسدها الأبيض. لم أصدّق الثوب ولم أصدّق الجسد. لم أقل لها إنّني مريض وأريد أن أغمض عينيّ كي أرى. وتركتها تذهب. رأيتها تذهب, هي لم تذهب, ربَّما ألّفتُ القصّة عن الجنديّ حتَّى أعطيها حرّيّة الذَّهاب. وذهبت.
سألتني مريم عن المريمات.
قالت إنّ ما يحيّرها في المسيح هو عدد المريمات اللَّواتي كنّ حوله.
و(أنتِ من تكونين?), سألتها.
قالت إنّ حكاية المريمات هي حكاية إسكندر. كان إسكندر يبحث عن مريمته الخاصّة كي يقوم بأعجوبته, (تذكّر قانا), قالت. (في قانا كانت أمّه, وهي التي دفعته إلى صنع أعجوبته الأولى, وأمام قبر لعازر كانت مريم أخرى, وفي القيامة كنّ جميعهنّ. إسكندر كان يبحث عن أعجوبيه, عن مريمته التي نسيت الملح وراحت. كان يريد أن يستعيد الملح الذي أغرق البحر الميِّت, وأغرق العالم).
في وادي الأردن, على ضفّة البحر الميّت الشرقيّة, رأيت ذلك الأفق الرصاصيّ الذي يغلّف العالم. كأنّنا في نهاية الكون, حيث الغيوم تمتدّ فوق الغمر وتبقى شفَّافة, كأنّها مرايا منثورة فوق التِّلال التي تحجب الوادي عن مدينة القدسَ. أضواء الغروب, والشَّمس تنام داخل المياه المالحة.
تقول الحكاية إنّها امرأة.
في ذلك الزَّمان, حيث كان الزَّمان وكأنّه لم يبدأ بعد, جلست امرأة تُدعى مريم. ربّما كانت مريم أخت موسى وهارون وابنة عمران, وربَّما كانت مريم.
(... )
ما حكاية المريمات?
سبع مريمات أحطن به في حياته القصيرة.
مريم أمّه التي ولدته ملفوفا بالكفن, ومات فخلع الكفن, وظهر لمريماته اللَّواتي لم يعرفنه في البداية. كان مشرقا كشمس العدل وكنّ حوله:
مريم أمّه.
ومريم أخت لعازر.
ومريم المجدليّة.
ومريم أمّ يعقوب.
ومريم كَلُوبا.
ومريم أمّ يوحنَّا مرقص.
ومريم الأخرى.
سبع مريمات يحطن بالشمس المتلألئة فوق البحر الميِّت الذي شُفيت مياهه وصارت طيِّبة, وهو يقف بينهنّ كغريب.
قلت له يا سيِّد.
كنت واقفا على ضفَّة البحر أنتظره, فقلت يا سيِّد. ثمَّ التفتُّ فرأيت عيون الجنود الأردنيّين من خلف التِّلال ولم أرَ المسيح.
قلت لمريم إنّني لم أرَ المسيح.
هل تعرف مريم ماذا تعني مريم?
إنّها تعتقد أنّ مريم اسم ككلَّ الأسماء, وهو يحيل على النساء اللَّواتي أحطن بالمسيح. لكن مريم شيء آخر. إنّها اسم مليء بالمعاني, مريم تعني العاصي, إنّها كلمة عبريّة تعني العاصي.
هل لأجل ذلك جعل من مريم حوَّاء الجديدة وأحاطها بالمريمات?
مريم الأولى عصته, تقول الحكاية. ومريم الثانية قبلت. لكن أين العصيان الحقيقيّ: في الرفض, أم في القبول?
قال جورج لزوجته إنّ وداد قبلت كلّ شيء. أعطاها إسكندر الصغير, كان يريد أن يعطيها إسكندر الصغير كي تشعر أنَّ لحياتها معنى, لكنَّها قبلت أن لا تعيش المعنَى (الله يخلِّيه لأمّه), قالت, طلب منها أن تكون عرّابة ابنه. إسكندر الابن جاء بعد انتظارٍ طويل. الوالد لم يبدِ رأيا, كان غير مهتمّ بمسألة عجز جورج وأمل عن الإنجاب. وأمّا هي فاهتمّت كثيرا. نصحت جورج بأن يفطر كلّ يوم عسلاً ممزوجا باللبن. (هذا طعام أهل الجنَّة), قالت له. نصحته أن يأكل اللَّبن والعسل ويتَّكل على الله ويتوقَّف عن استشارة الأطبَّاء. وبقي جورج عشرين سنة يأكل طعام أهل الجنّة وينظر إلى فراغ حياته وفراغ بطن زوجته. إلى أن حبلت أمل. فجأة, ودون مقدّمات حبلت أمل, ولم تتوقَّف بعد ذلك عن الإنجاب. أنجبت ستَّة أولاد, أربع بنات وصبيّين. كان إسكندر الصغير يحمل الرقم خمسة بينهم.
عندما وُلِد إسكندر, كان إسكندر الأب قد مات. جاء جورج إليها. جاء راكضا من المستشفى وضمّها إلى صدره وبدأ يبكي.
لحظة رأته يدخل باب بيتها, وقبل أن يفتح فمه, سألته (كيف إسكندر?).
(مَنْ أخبركِ?), سأل.
(رأيته), قالت. (رأيته في منتصف اللَّيل, كنت نائمة, استيقظت على صوت بكائه, فتحت عيني فرأيته).
(وُلِد في منتصف الليل), قال.
ضمَّها جورج وصار يشهق بالبكاء.
قبل العمادة بيوم, جاءها وقال لها إنّه اختارها لتكون عرّابة الصبيّ. قبلت دون أن تناقش أو تفرح بشكلٍ خاصّ. كان جورج يعتقد أنّه يعطيها فرح حياتها. بقيت جامدة, وافقت بحياديّة كأنَّها تستمع إلى اسم امرأة أخرى اختيرت لتكون العرّابة.
وفي حفل العمادة الذي جرى في البيت, لأنّ أمل كانت مريضة, وتعاني من آلام الأسنان الرهيبة التي تصاحب كلّ مولود تضعه, حتَّى انتهى بها الأمر مع مولودها السادس إلى ضرورة قلع جميع أسنانها. في البيت, أمام جرن المعموديّة, وقفت وداد بثوبها الأزرق وطرحتها البيضاء, وأخذت الطفل عاريا من يد الكاهن, ضمّته إلى صدرها حيث كانت تربط منشفة كبيرة بيضاء, لفّته بالمنشفة, وبدأت ترتِّل بصوت منخفض. لم تكن الترتيلة جزءا من طقوس العمادة. رتَّلت بصوتٍ منخفضٍ يكاد لا يسمعه أحد. توقّف الكاهن عن تلاوة صلاته, والتفت إليها بتأفّف واضح, وأراد أن يطلب منها أن تسكت, ولكنّه لم يفعل, تركها تنهي ترتيلتها, وعاد إلى صلاته التي اختصرها كي يذهب إلى الكنيسة حيث تنتظره عمادة أخرى.
أمل قالت إنّها كانت تشبه سيّدتنا مريم العذراء.
قالت لزوجها في المساء, بعد أن ذهب المدعوون, إنّها خافت عندما رأتها تحمله. كأنّها مريم العذراء, تحمل طفلها وتأخذه إلى الموت.
(دخيلك بلاها هالمرأة, دخيلك ما بدِّى ياها تشوف ابني).
ضحك جورج, وقال لها إنّها هكذا تدندن ترتيلة (أعطني هذا الغريب) دائما, لأنّها تحبّ اللّحن. وشرح جورج لزوجته بشكل مفصَّل أهميّة الألحان البيزنطيّة, ونظريّته في أنّ الكنيسة الشرقيّة لم تضمحل في العالم العربي بفضل الموسيقى, وأنّ الموسيقى البيزنطيّة تمتلك ميزة الخلود, لأنّها تحمل إيحاءً بأنّها ليست من صنع بشريّ. إنّها موسيقى تتداخل فيها بساطة الإنسان وعظمة الموت.
حاول أن يشرح لزوجته أنّ وداد غنَّت لأنّها تحبّ الغناء. وأنّ المقصود هو الأغنية لا مضمونها.
أمل قالت إنّها لا تريد أن ترى هذه المرأة في بيتها.
وداد لم تزر جورج في بيته مرّة أخرى. كانت ترفض جميع دعواته للزيارة, وتكتفي بأن تقول له بأنّها تدعو له ولأولاده.
وعندما أصيب إسكندر الصغير بشظايا القذيفة, وصار مشلولاً, ذهبت وداد إليه وخدمته ستَّة أشهر في المستشفى, وحملته بين ذراعيها كما حملته في عمادته, وبكت كما بكت قبل ذلك بعشر سنوات.
ماذا أكتب?
أين الخلل في هذه الحكاية?
الكتابة عن مريم مستحيلة, ليس لأنّني أحببتها, بل لأنّني أراها أمامي الآن وهي ترتجف بالخوف, ونحن نمشي في ممرّات الخطّ الأخضر الذي كان يفصل بيروت عن بيروت. وأنا أردّد الأسماء. استطعت أن أصل إلى تسعة وتسعين اسما, وصلت إلى العدد الأقصى وأنا أردّد أسماء الأصدقاء الذين ماتوا بين حجارة هذا الخط الدمويّ الذي صنعته الحرب.
وكانت الدمية الشَّركسيّة.
هل كان إميل آزاييف سيفهم مأساة وداد في أيَّامها الأخيرة, أم سيصرّ على تغيير حكاية جرجي الرَّاهب بوصفها حكاية معادية للسَّاميّة? سمعت الحكاية للمرّة الأولى من امرأة كهلة تسكن مخيَّم (الميّة وميّة), قرب صيدا. أخبرته الحكاية كما سمعتها معتقدا أنّها حكاية شعبيّة, وأنّه يجب جمع الروايات المختلفة للحكاية, كي نعيد صياغتها بوصفها جزءا من الأدب الشعبيّ الفلسطيني.
المفاجأة كانت أنّني في بحثي داخل مكتبة جامعة (كولومبيا) في نيويورك عثرت في صحيفة كانت تُدعى (القدس) على وصف لحادثة مقتل الرَّاهب جرجي خيري الدوماني اللبناني.
كتبت الصحيفة في عدد 17 أيَّار 1946 أنَّه عُثِر على جثّة الرَّاهب قرب (باب العمود) في القدس, وهي مصابة بعشر طلقات رصاص. إذن, فما روته لي المرأة الفلسطينيّة لم يكن حكاية شعبيّة, كان حادثة حقيقيّة. هنا يطرح السؤال: ما الفرق? كيف أتعامل مع حكاية الرَّاهب اللبنانيّ? هل أعيد تنظيم رواية المرأة الفلسطينيّة بحسب اقتراح (فلاديمير بروب) بشأن الحكايات الشعبيّة, أم أبحث عن الحقيقة?
وكانت مريم تسخر دائما منِّي حين أخبرها أنّني أبحث عن الحقيقة.
كانت تعتقد أنّني لا أبحث عن الحقيقة إلاَّ من أجل كتابتها, وعندما نكتبها نخونها ونحوّلها إلى حكاية.
ومريم معها حقّ.
ولكن ماذا نفعل غير ذلك?
نكتب أي نكذب, كما كتب غالب هلسا قبل أن يموت من انفجار قلبه في دمشق, بعيدا عن (سلطانة).
لكنّني أحاول أن لا أكذب.
(أنت مثله), قالت مريم.
(من?), سألتها.
(مروان العاصي), تعرفه?
(لا).
قالت إنّه كان, و(كان يحبّني, كنت في الثامنة عشرة, وكان في الأربعين. أحببته كما تحبّ طالبة في الجامعة اللبنانيّة أستاذها, وكان أستاذي. أحببته سنة كاملة. نخرج ونتعشَّى في المطاعم ويحكي لي أجمل الغزل, ويتنهَّد. ثمَّ غبت عنه. لم أغب أنا, بل الحبّ غاب. وتزوّجت وأنجبت. وبعد عشر سنوات التقيته صدفة في أحد شوارع روما. مشينا وذهبنا إلى المطعم والمقاهي, وحكى الغزل نفسه. وفي الفندق قضينا الليل في غرفته, وكان طوال اللَّيل كأنّه سيغمى عليه, أمسك يدي وقبَّلها, ثمَّ انتشرت فوق وجهه غيمة الإغماء ولم ينم معي. في سنة الحبّ تلك كان يكتب لي رسالة كلّ يوم. أحبّني على امرأة تُدعى مريم. ربّما كانت مريم أخت موسى وهارون وابنة عمران, وربَّما كانت مريم.
(... )
ما حكاية المريمات?
سبع مريمات أحطن به في حياته القصيرة.
مريم أمّه التي ولدته ملفوفا بالكفن, ومات فخلع الكفن, وظهر لمريماته اللَّواتي لم يعرفنه في البداية. كان مشرقا كشمس العدل وكنّ حوله:
مريم أمّه.
ومريم أخت لعازر.
ومريم المجدليّة.
ومريم أمّ يعقوب.
ومريم كَلُوبا.
ومريم أمّ يوحنَّا مرقص.
ومريم الأخرى.
سبع مريمات يحطن بالشمس المتلألئة فوق البحر الميِّت الذي شُفيت مياهه وصارت طيِّبة, وهو يقف بينهنّ كغريب.
قلت له يا سيِّد.
كنت واقفا على ضفَّة البحر أنتظره, فقلت يا سيِّد. ثمَّ التفتُّ فرأيت عيون الجنود الأردنيّين من خلف التِّلال ولم أرَ المسيح.
قلت لمريم إنّني لم أرَ المسيح.
هل تعرف مريم ماذا تعني مريم?
إنّها تعتقد أنّ مريم اسم ككلَّ الأسماء, وهو يحيل على النساء اللَّواتي أحطن بالمسيح. لكن مريم شيء آخر. إنّها اسم مليء بالمعاني, مريم تعني العاصي, إنّها كلمة عبريّة تعني العاصي.
هل لأجل ذلك جعل من مريم حوَّاء الجديدة وأحاطها بالمريمات?
مريم الأولى عصته, تقول الحكاية. ومريم الثانية قبلت. لكن أين العصيان الحقيقيّ: في الرفض, أم في القبول?
قال جورج لزوجته إنّ وداد قبلت كلّ شيء. أعطاها إسكندر الصغير, كان يريد أن يعطيها إسكندر الصغير كي تشعر أنَّ لحياتها معنى, لكنَّها قبلت أن لا تعيش المعنَى (الله يخلِّيه لأمّه), قالت, طلب منها أن تكون عرّابة ابنه. إسكندر الابن جاء بعد انتظارٍ طويل. الوالد لم يبدِ رأيا, كان غير مهتمّ بمسألة عجز جورج وأمل عن الإنجاب. وأمّا هي فاهتمّت كثيرا. نصحت جورج بأن يفطر كلّ يوم عسلاً ممزوجا باللبن. (هذا طعام أهل الجنَّة), قالت له. نصحته أن يأكل اللَّبن والعسل ويتَّكل على الله ويتوقَّف عن استشارة الأطبَّاء. وبقي جورج عشرين سنة يأكل طعام أهل الجنّة وينظر إلى فراغ حياته وفراغ بطن زوجته. إلى أن حبلت أمل. فجأة, ودون مقدّمات حبلت أمل, ولم تتوقَّف بعد ذلك عن الإنجاب. أنجبت ستَّة أولاد, أربع بنات وصبيّين. كان إسكندر الصغير يحمل الرقم خمسة بينهم.
عندما وُلِد إسكندر, كان إسكندر الأب قد مات. جاء جورج إليها. جاء راكضا من المستشفى وضمّها إلى صدره وبدأ يبكي.
لحظة رأته يدخل باب بيتها, وقبل أن يفتح فمه, سألته (كيف إسكندر?).
(مَنْ أخبركِ?), سأل.
(رأيته), قالت. (رأيته في منتصف اللَّيل, كنت نائمة, استيقظت على صوت بكائه, فتحت عيني فرأيته).
(وُلِد في منتصف الليل), قال.
ضمَّها جورج وصار يشهق بالبكاء.
قبل العمادة بيوم, جاءها وقال لها إنّه اختارها لتكون عرّابة الصبيّ. قبلت دون أن تناقش أو تفرح بشكلٍ خاصّ. كان جورج يعتقد أنّه يعطيها فرح حياتها. بقيت جامدة, وافقت بحياديّة كأنَّها تستمع إلى اسم امرأة أخرى اختيرت لتكون العرّابة.
وفي حفل العمادة الذي جرى في البيت, لأنّ أمل كانت مريضة, وتعاني من آلام الأسنان الرهيبة التي تصاحب كلّ مولود تضعه, حتَّى انتهى بها الأمر مع مولودها السادس إلى ضرورة قلع جميع أسنانها. في البيت, أمام جرن المعموديّة, وقفت وداد بثوبها الأزرق وطرحتها البيضاء, وأخذت الطفل عاريا من يد الكاهن, ضمّته إلى صدرها حيث كانت تربط منشفة كبيرة بيضاء, لفّته بالمنشفة, وبدأت ترتِّل بصوت منخفض. لم تكن الترتيلة جزءا من طقوس العمادة. رتَّلت بصوتٍ منخفضٍ يكاد لا يسمعه أحد. توقّف الكاهن عن تلاوة صلاته, والتفت إليها بتأفّف واضح, وأراد أن يطلب منها أن تسكت, ولكنّه لم يفعل, تركها تنهي ترتيلتها, وعاد إلى صلاته التي اختصرها كي يذهب إلى الكنيسة حيث تنتظره عمادة أخرى.
أمل قالت إنّها كانت تشبه سيّدتنا مريم العذراء.
قالت لزوجها في المساء, بعد أن ذهب المدعوون لن يستطيعوا البقاء لحظة واحدة بعد انسحاب قوَّات الانتداب البريطاني?
هل قُتِل من أجل هذه الجملة المكتوبة على صليبه? ومن يكون القاتل? لا أحد يدري. هل هم الصهاينة, أم هم جماعة الحاج أمين, أم هي (أخويّة القبر المقدَّس) التي أصبحت سمعتها مهدّدة بسبب أفعال الرَّاهب الجنونيّة?
لا أدري, قلت لمريم.
ووداد البيضاء, لم تكن تدري لماذا كلّ هذا.
الشَّركسيّة البيضاء لم تنجب أولادا. عاشت وحيدة وماتت. وحكاية موتها هي الحكاية.
ولكن لماذا?
لماذا نضع الموت في المرتبة الأولى, ونجعله هو الحكاية?
هل لأنّ النهاية تفسّر البداية?
ومن قال إنّ الموت هو النهاية? هل موت الرَّاهب اللبنانيّ يفسّر بدايته, أم أنّ موته كان البداية التي تحتاج إلى تفسير?
أسئلة وأسئلة, والجواب بقي معلّقا. كتبت رسائل إلى (دير مار سابا) في القدس أطلب فيها معلومات عن الرَّاهب, ولكنّي لم أتلقَّ جوابا. فقرّرت زيارة قرية (دوما) علّني أعثر على الحقيقة, وهناك وجدت حكايات أخرى.
ذهبت إلى (دوما). لم أكن قد زرت هذه القرية من قبل. ذهبت إليها في أعالي (البترون), لأجدها وكأنّها تنزلق إلى الوادي. من الأعلى, من طرف قرية (بشعلة) الموصولة ببلاد تنورين, تبدو (دوما) وكأنّها تسقط في الوادي. بيوت قرميديّة تتدرَّج نزولاً, ووادٍ سحيق يبدو وكأنَّه جزء من منخفض لا نهاية له. مشيت في الطريق الرئيسيّ الذي يشقّ القرية ولم أعرف كيف أبدأ أو ماذا أسأل ومن? لم أكن أملك معطيات محدّدة تسمح لي بأن أبدأ. كلّ ما كنت أعرفه هو الأسماء. اسم الرَّاهب واسم عمّه (الأكسرخوس). حتَّى الأسماء لست متأكّداً منها. ففي الكنيسة يغيّرون الأسماء, كما كنَّا نفعل نحن في غور الأردن. قلت إنّ أفضل بداية هي الذهاب إلى الكنيسة, هناك أستطيع أن أجد الأجوبة الأولى عن أسئلتي.
في الكنيسة, أصرّ القندلفت أنّها بُنيت في القرن التاسع عشر, وأنّ القنصل الروسيّ جاء بنفسه ليحضر حفل تكريس الكنيسة, وتبرَّع من ماله الخاص بثمن الجرس الذي كان واحدا من أوّل الأجراس التي علّقت في لبنان. وروى لي عن الأيقونات وأنّها تعود إلى القرن الثالث عشر, وأنّها تنتمي إلى المدرسة الحمصيّة في رسم الأيقونات, وأشياء لا أتذكَّرها لأنّها لم تكن تعني لي شيئا في ذلك الوقت.
كنت أبحث عن الرَّاهب وعن حكايته. هل صحيح أنّه خرج من (دوما) وقاد عصابة في (الجليل), أم أنّ الحكاية ليست سوى حكاية روتها لي امرأة في مخيَّم (الميّة وميّة) قرب صيدا? هل أبحث فعلاً عن جذور الحكاية الشعبيّة, أم أنّني أريد إقناع صديقي إميل آزاييف أنّ الرَّاهب لم يكن لا ساميا, لأنّنا في بلادنا لا نعرف معنى اللاَّساميّة? وما الفرق? إميل لن يعرف نتائج أبحاثي هذه, والرَّاهب لم يعد موضوعا بعد أن احتُلَّت القدس بأسرها وجرى تسويرها بالمستوطنات الإسرائيليّة, وحكاية الصَّليب الذي كُتِب عليه ما كتب لم تعد تعني شيئا كثيرا بعد أن تجاوز عذابنا نصف المدّة التي تنبّأ بها الرَّاهب. صبرنا خمسين سنة, فلماذا لا نصبر خمسين سنة أخرى ونرى?! لكنّنا لن نرى. بعد خمسين سنة تكون مريم قد ماتت, وأنا أيضا, والذين سيقرأون الحكاية, هذا إذا وجد من يريد قراءتها, سيضحكون من سذاجتي, وسذاجة الرَّاهب, لأنّ نهاية العذاب سوف تأتي عبر المرور بعذابٍ كبير أين منه هذا العذاب, وبعد ذلك لن يكون أحفادنا قادرين على التمتّع بنهاية العذاب.
أعود إلى الحكاية.
ذهبت إلى الكنيسة في (دوما), وهناك استمعت من (القندلفت) إلى حكاية (الأكسرخوس). لم يكن يعلم شيئا عن جرجي الرَّاهب, قال إنّه يذكر وجود (أكسرخوس) من عائلة خيري, وكان اسمه أبانا (جراسيموس). وروى عن الكاهن العائد من إقامته الطَّويلة في دمشق حيث كان مرافقا للبطريرك. قال إنّ الأب (جراسيموس) مات بعد عودته من دمشق بخمس سنوات, وأنّه قضى السنة الأخيرة من حياته وحيدا بعد أن قرّرت زوجته النزول إلى بيروت والإقامة مع ولديها الشَّابّيْن اللّذيْن كانا يدرسان في جامعة القدِّيس يوسف التابعة للآباء اليسوعيّين. بقي الكاهن وحيدا في البيت, ولم يكن يخرج منه إلاَّ للذهاب إلى الكنيسة. فجأة تقوّس ظهره وابيضّت لحيته وصار يمشي مثل سيّدنا البطريرك. (يا ربّ تسامحني, بسّ لو شفته يا أستاذ, صار متل كيف بدّي قلّك, متل ما عم بقول, صار كأنّه هو, كأنّه البطرك بسّ ما كان يحمل عصا. يا ربّ تسامحني, وبعدين الله يرحمه وقع وبرك, وما عاد فيه يمشي, والخورية أجت وزارته يومين, ونزلت على بيروت وتركته, قالت إنّه هو كان بدُّو هيك. ولولا رحمة الله كان تبهدل. تركته وبعد ثلاثة أيَّام مات. مسكين قضى كلّ عمره يخدم البطرك, وبسّ إجا وقته تركوه, بسّ الله كبير. أنا زرته وكان عم بموت. عرفت إنّو عم بموت لأنّو هو قال لي. وبعدين مات وخلصت القصّة).
لم أكن أريد حكاية (الأكسرخوس) أو (جراسيموس) أو لا أدري... كنت أبحث عن الرَّاهب. (القندلفت) أصرّ على أنّه لا وجود لراهب من القرية باسم جرجي.
(أنت بتعرف يا أستاذ, يمكن غيّر اسمه, هنِّي بالسلك بغيِّروا أساميهم, أنا ما بعرف راهب بهالاسم, يمكن لازم تسأل عن اسم تاني).
(شو منعمل?), سألته.
(ما بعرف), قال, (يمكن أحسن حدا بيقدر يفيدك هي زوجة ابن عمّ المحترم).
قلت إنَّني أريد زيارتها.
قادني وسط زقاقٍ شبيهَ بأزقّة المدن, وعلى جانبيه دكاكين مغلقة أو شبه مغلقة, من الواضح أنَّ القرية كانت مدينة أو حاضرة للقرى المحيطة, غير أنّ طابعها المديني بدأ يزول, ولم يبقَ منه شيء يذكّر بذلك الطَّابع سوى الدكاكين ذات الأقواس, والمقهى المكتظّ بالرجال والنراجيل وصوت طاولات الزَّهر.
ذهبنا إلى زوجة ابن عمّ المحترم, لنجد أمامنا امرأة في الثمانين من العمر تبلع ريقها بشكل دائم كأنّها تبتلع زلعومها. قال لي القندلفت إنّها مصابة بنشافٍ في الحنجرة والفم, جاء نتيجة التهاب في فكّيها وأسنانها كاد يودي بها.
كانت أمّ حليم, وهذا اسمها, تعيش وحيدةً في بيتٍ معتمٍ تفوح منه رائحة زيتون متعفِّن. روت عن الكاهن وأجهشت في البكاء.
قالت إنّها تخاف. قالت إنّ الليل يخيفها لأنّه يشبه عباءة سوداء تلفّها, وأنّها أصيبت بشحٍّ في البصر, وصارت ترى كما يرون هناك. وأشارت إلى فوق. فهمت أنّها تقصد الآخرة. لم أسألها كيف عرفت أنّهم يرون كما ترى, فأنا كنت مستعجلاً للوصول إلى حكاية الرَّاهب, ومعرفة الصدى الذي تركه في قريته, وهل تحوّل إلى حكاية هنا, أم أنّ حكايته هاجرت معه إلى فلسطين ولم تبق حيّة إلاَّ في ذاكرة امرأة كهلة تعيش في مخيَّم فلسطينيّ قرب صيدا.
أمّ حليم لم تكن مستعجلة للوصول إلى حكاية الرَّاهب. كان يهمّها أن تخبرني كيف يرى الناس فوق, وأنّها عندما أصيبت بالماء (الزرقاء) في عينيْها قرّرت أن لا تجري عمليّة جراحيّة.
قالت إنّها تعرف بأنَّ العمليّة ليست خطرة ولكنَّها تفضِّل هكذا, ترى كما سترى, (لماذا أعود إلى الوراء), قالت. (الموت قدَّام, وأنا بشوف لقدَّام, بشوف الأبونا سليم, قلت له ما بغيّر اسمه, شو هالاسم (جراسيموس), بكرا إنشالله فكره إنّو هونيك رح سمِّيه (جراسيموس), هونيك رح سمِّيه متل ما بعرفه, سليم. الله يرحمه شو كان آدمي, مات لوحده وما زعج حدا. إيه يا ابني.. هيدي حكايتي حكيتها. حضرتك باعتك سيدنا البطرك, دخلك ليش هيك بيموتوا البطاركة, لَمَّنْ مات أبيفانيوس بعث لي الأبونا سليم ورحت, كان البطرك ميّت وكانوا مقعّدينو على كرسي العرش ومحنّط. وبعدين نزّلوه على الأوضة لتحت. ما حطّوه بقبر, حطّوه بغرفة كبيرة حدّ البطاركة التانيين. أنا فتت لجوّه, يا لطيف, كلّهم محنّطين وقاعدين مع بعضهم على كراسي العرش كأنّهم باجتماع. يا لطيف. كلّهم محنّطين, واحد هرّت نُصّ لحيته, وواحد فاتح تمّه, وواحد أسود متل الفحمة. صلّبت إيدي على وجهي وصرت أبكي. يا دلّي شو بكيت. فكَّروني متأثّرة على البطرك, وأنا كنت عم ببكي من الخوف. متّ من الخوف وصرت أرجف كلّني سوا. أرجف وأبكي, ومن وقتها بلّشِتْ قصّة عيوني).
قلت لها إنّني لم أذهب للتفرُّج على قبر بطاركة إنطاكية وسائر المشرق, فأنا لا يهمّني هذا الموضوع, وشرحت لها أنّني أعدّ أطروحة دكتوراه عن الحكايات الشعبيّة, ورويت ما أعرفه عن الرَّاهب الدوماني. أبدت المرأة استغرابا. ثم أصرّت على القول بأنّ القصة مستحيلة, لأنّه من غير الممكن أن يقوم راهب بنشاطات عسكريّة وسياسيّة أو أن يسرق, وظيفة الرَّاهب أن يصلِّي ويبكي.
(كلّ الرهبان نُصّ عميان), قالت. (الرَّاهب يلِّلي ما بيعمى ما بصير قدِّيس. الرَّاهب لازم يبكي وتعمى عيونه حتَّى يكفّر عن ذنوب الكون كلّه, كيف هيدا راهب, لا ما بعرفه).
كنت أهمّ بالانصراف, والقندلفت ينظر إلى ساعته كأنّني أخّرته عن موعدٍ هامّ, عندما قالت المرأة إنّها تذكّرت. قالت إنّ الأبونا حدّثها عن قريب له لبس الأسكيم الرهباني, لكنّها لا تذكر أنّه حدّثها عن القدس, وأنّها لم ترَ هذا القريب إلا مرّة واحدة, عندما جاء لزيارة عمِّه في (دوما). قالت إنّه كان قصيرا وسمينا وشعر لحيته مبقّع بما يشبه الزيت ورائحته. كانت رائحته مثل رائحة الخنزير, وأنها اعتقدت أنّه من جماعة الرهبان الذين ينذرون عدم الاستحمام طوال حياتهم, وأنّها لم تستطع أن تبقى حيث كان أكثر من خمس دقائق. وأنَّه لم يكن يحكي, بل كان يهمهم. وأنَّه عاش في دير في منطقة الكورة, يدعي (دير مار يوحنا كفتين), وأنّه كان يعيش قرب بئر الدَّير, وكان راعيا للمواشي التي يملكها الدَّير, وأنّه لم يعد إلى زيارة (دوما) مرّة أخرى.
(والقدس?), سألتها.
(والله ما بعرف يا ابني, يمكن من دير مار يوحنا كفتين راح على القدس, أنا ما بعرف).
هذا كان حصاد زيارتي (لدوما).
بدل أن أجمع معلومات عن جرجي الرَّاهب عرفت أنّهم في الآخرة يرون ظلالاً زرقاء كما ترى السيِّدة أمّ حليم, وأنّ مشهد البطاركة المحنّطين في قبرهم أثار فيها الخوف, وأنَّ الخوري سليم أو (جراسيموس) صار في آخر أيَّامه يمشي كما كان يمشي سيِّده, وصار مقعدا مثله, وأنَّ جرجي الرَّاهب الذي أبحث عنه لم يذهب إلى (دير مار سابا) في القدس, بل ذهب إلى (دير مار يوحنَّا) في الكورة. ربَّما من (الكورة) عاد وذهب إلى القدس, لكن لا أحد يعرف.
من أين جاء الخبر في الجريدة? وكيف تحوّل الرَّاهب إلى حكاية? ومن أخبرني الجزء الآخر من الحكاية الذي لم تروِه المرأة الفلسطينيّة?
أسئلة لا أملك جوابا عنها, كلّ ما أعرفه أنّني شممت في قرية (دوما) رائحة تشبه رائحة الحرائق, وأنّ الرَّاهب الذي أبحث عنه لم يكتفِ بحمل صليبه, بل قرّر أن يموت عليه كما فعل سيِّده منذ ألفي سنة, وأنَّ الحكاية التي رويتها لصديقي إميل آزاييف صحيحة, لأنّني مقتنع بها.
لماذا أسمّي إميل صديقي?
لا أدري. هل لأنَّه روى لي حكايته? أَوَكلَّما استمعنا إلى حكاية إنسان نصبح أصدقاءه? هل أنا الآن صديق الجميع وصديق وداد?
وداد أحببتها. أحببتها كما أحببت مريم. حاولت أن أشرح لمريم معنى الحبّ, وأنّني حين رأيتها تذهب إلى الجنديّ وتمضي معه لفّني شعورٌ غامض وكأنَّني أمضي أنا, كأنّني صرت داخل عينيْها صورة مصغّرة لرجلٍ كنته, وها هو الآن يمضي إلى حيث تأخذه هذه المرأة.
في (دوما), وجدت حكايات أخرى, ولكنَّني لم أجد الرَّاهب. فقرّرت أنَّ بداية الحكاية هي كتابتها, وأنّ القدِّيس يوحنَّا حين بدأ إنجيله بعبارة (في البدء كان الكلمة), لم يكن يقصد بالكلمة (اللوغوس) اليوناني كما هو شائع, بل كان يقصد الكلمة المكتوبة, كان يقصد المسيح بوصفه كلمة مكتوبة على الصليب. لذلك حمل الرَّاهب صليبه ليبشِّر العرب بسنوات القهر المئة. ولذلك أيضا بدت وداد وهي مرميّة على الخط الأخضر الذي كان يفصل بيروت عن بيروت وكأنّها مصلوبة, مثل كمال ناصر, الشاعر الفلسطيني الذي قتلوه في بيته في بيروت عام 1972, وصلبوه على الأرض, وأفرغوا الرَّصاص في فمه.
لكن وداد كانت وحيدة.
(عاشت طوال حياتها وحيدة), قال جورج للدكتور نجيب الذي حاول معالجة ذاكرة المرأة البيضاء.
والآن يبدو المشهد بعيني جورج, فلا نرى سوى صورة ناقصة. جورج يرى مشهد المطبخ حين اكتشفت مدام لودي زوجها المكتهل وهو يحتضن الخادمة الصغيرة. يرى عيني الفتاة الممتلئتين رعبا وما يشبه الدموع. يرى إسكندر وهو يمسك بيد الخادمة ويخرج من البيت. هنا تغيب صورة وداد وتأتي صورة لودي. لقد تحوَّلت أمّه إلى ما يشبه الخرقة. انهارت فجأة وبدأت تنوح, وحين عرفت أنّ إسكندر أشهر إسلامه وتزوَّج الشَّركسيّة, تحوّلت إلى خيطٍ دقيقٍ مشدود. ذاب نهداها, وصارت تشبه رقبة طويلة مليئة بالتجاعيد.
وعندما مرض إسكندر واعتقد الجميع أنّه سيموت, زغردت لودي في البيت ورقصت, وقالت إنّ الله ينتقم لكرامتها. ولكنَّها ماتت قبل زوجها بعشرين سنة. ماتت كمدا كما قيل. كانت حين تعود من زيارتها لزوجها المريض ترتجف, وتملأ البيت صراخا. تدخل غرفتها وتقفل الباب ولا تفتح لأحد. أكثر ما كان يغيظها انحناءة الشَّركسيّة البيضاء وهي تقبِّل يدها, ثمَّ جلوسها على طرف كرسيّ الخيزران مطرقة الرأس دون أن تحكي.
في مأتمها بكى إسكندر كثيرا. وقف في الكنيسة خلف النَّعش وحيدا. وكانت الشَّركسيّة تقف في الخلف, مع النِّساء, ولا يلتفت إليها أحد.
لم تكن وداد تحكي إلاَّ حين يطلب منها زوجها ذلك.
كانت تلبس ثوبا أبيض, وتغطِّي رأسها بشالٍ من الحرير الأزرق, وتمشي منحنية الرأس وكأنَّها راهبة, ولا تحكي.
مرّة بكت.
كان جورج وشقيقاته يزورون والدهم. إسكندر يستلقي على أريكته في الصَّالة. يلبس قمبازه الحريريّ الأبيض المقصّب, وعلى رأسه طربوشه العثمانيّ الأحمر, وفي يده نربيش النارجيلة التي منعه الأطبَّاء من تدخينها, فصارت وداد تعدّها دون أن تضع الفحم الصغير المشتعل فوق رأس النارجيلة الملفوف بالتنباك. إسكندر يدخِّن دون دخان, والنارجيلة تقرقع بالماء, والأولاد يجلسون حول والدهم, وداد في مكانها على طرف كرسيّ الخيزران, وكلام يتقطَّع وسط الصمت. وبكت.
جورج نفَّاع يذكر أنّ المرأة غرقت في البكاء.
لم يسبق له أن رأى إنسانا يبكي هكذا.
كتلة بيضاء تتحوّل إلى نهرٍ من البكاء. التفت الجميع صوبها ولم يفهموا. كانت تنتفض بما يشبه الحشرجة, ثمّ بدأت ترتجّ, ثمَّ انهمرت الدموع وارتفع النشيج, حاولت أن تقف وتخرج من الصَّالة, ولكنَّها سقطت على الأرض وبدأ بكاؤها.
ركض جورج صوبها.
(اتركها), صرخ إسكندر.
تراجع جورج إلى مكانه, وكانت (تبلعط) وحيدةً وتنتفض, ويخرج النشيج من كلِّ أحشائها.
رفع إسكندر يده إلى الأعلى كي يطلب من أولاده أن لا يتحرَّكوا من أماكنهم.
وبقيت هكذا تتخبَّط في البكاء حوالي عشر دقائق, وكان الأب ينظر إليها بعينيْن لا مشاعر فيهما, والأولاد لا يتحرَّكون, وصوت النحيب يتضاءل ويغوص, وصار يغوص ويغوص وكأنه يغرق.
ثمّ نهضت.
خرجت من الصَّالة وذهبت إلى الحمَّام, اغتسلت وغيّرت ثيابها, وعادت لتجلس في مكانها على الكرسيّ بهدوء, كأنْ لا شيء.
(هي هكذا), قال إسكندر لأولاده. (تصيبها نوبة بكاء بين وقت وآخر, ولكن هذا لا يشغل البال).
جورج أخبر الدكتور نجيب حين جاء لمعالجتها من ذلك المرض المخيف الذي أصابها.
(قد تكون مصابة بداء الصّرع), قال جورج.
(لا, هذا ليس صرعا), جاوب الطبيب, (هذا شيء آخر, يا ساتر, وداد لم تكن مصروعة, وهي اليوم ليست خرفانة, هذا مرض آخر).
ولازمها مرض البكاء طوال حياتها.
إسكندر نفَّاع لم يكن يعرف حين اشتراها أنّه يدخل في منقلب آخر من حياته. اشتراها دون أن يفكِّر في الأمر كثيرا, كان يعتقد أنّه يحلّ مشكلة زوجته مع الخادمات. فمدام لودي كانت تتعذَّب كثيرا مع خادماتها. جميع الخادمات كنّ يغادرن البيت, بعد أقلّ من شهر, هربا من ظلم المدام وبخلها وتكبُّرها.
مدام لودي كانت تشعر أنّها ظُلمت بزواجها من إسكندر, هي ابنة عائلة جلخ الغنيّة التي كانت تعمل في تجارة الحرير, تزوّجت من رجل يعمل في القوميسيون, ولا ينتمي إلى إحدى عائلات بيروت السبع. وكانت طريقتها في التعويض هي التكبُّر على زوجها وظلم الخادمات, والتكلُّم باللُّغة الفرنسيّة. وكانت مأساة البيت هي الخادمات. تأتي الخادمة للعمل وفي أقلّ من شهر تهرب, ويدخل البيت في دوَّامة البحث عن خادمة جديدة. وقرّر إسكندر أنَّ الخادمات لن يدخلن بيته بعد اليوم, وكان ذلك بعد حادثة منيرة الحورانيّة. منيرة كانت فتاة ممتازة, هكذا كان إسكندر يعتقد حين رآها مع والدها في بيتهم ولودي تفاوضه على الأجر الشهريّ. سمراء, في الثامنة عشرة وتعرف كلّ شيء. تطبخ, تغسل, تنظِّف البيت, وتعدُّ النراجيل. لكن منيرة لم تطق البقاء في منزل لودي أكثر من ثلاثة أسابيع. إسكندر أُصيب بالرعب وهو يرى الخادمة تهجم على زوجته وتضربها, ثمَّ تبدأ بتحطيم كلّ شيء. صارت منيرة كالحيوان الهائج, حطَّمت الأواني الخزفيّة في المطبخ, ثمَّ انتقلت إلى الصالة, وبدأت تكسّر كلّ شيء. حملت شاكوشا وبدأت تضرب به أثاث البيت, كلّ شيء كان يتحطَّم, وإسكندر صامت لا يتدخَّل, ولودي مدمَاة على الأرض.
لم تأخذ حتَّى ثيابها.
خرجت منيرة من البيت بعد تلك المعركة ولم تعد. وإسكندر قرّر التوقُّف عن جلب الخادمات.
(أنت مسؤولة), قال لزوجته. (الحقّ عليكِ لأنَّك بلا قلب).
وكانت لودي تئنُّ وهي تقول له إنَّ الحقّ عليه لأنَّه لم يؤدِّب الخادمة الحورانيّة, لأنّ نيَّته عاطلة.
لودي كانت بلا قلب مع خادماتها.
كانت تحبّ الفقراء, توزِّع الثياب والطَّعام على المياتم, أمّا مع الخادمات فكانت تتحوّل إلى إنسانة أخرى. (الخادمة خادمة), كانت تقول, تعامل الخادمات كالعبيد, تجبرهنّ على العمل المتواصل, حتَّى وإن لم يكن هناك عمل, لا تطعمهنّ إلاَّ من أكل الأمس, وتضربهنّ ولا تعطيهنّ الثياب القديمة; لأنها كانت توزعها على العائلات الفقيرة، كما كانت تدعي .
عندما اشترى إسكندر الشركسيّة فكر أنها الحل.
قال لمحمد لاوند، وصديقه تاجر الجملة ، إنه يريد أن يشتري وجع رأسه بأي ثمن. وذهب مع محمد لاوند إلى فندق أميركا، قرب مرفأ ببيروت، وهناك اشتراها بخمس ذهبيات، وكانت لا تحكي ، وصلت بالباخرة من الإسكندرية قبل يومين، بياضها مخطوف من الإرهاق والخوف ، وتنظر بعينين فارغتين ، ولا تعرف سوى بعض الكلمات العربية بلهجة هي مزيج من المصرية والتركية.
اشتراها باعتبارها شركسية. هكذا سماها البائع الذي لا يذكر إسكندر منه سوى صلعته المبقعة بما يشبه الزيت.
قال البائع إنها وداد الشركسية، وهي تساوي ثقلها ذهبا.
اشتراها إسكندر، ومضى بها إلى البيت.
وكانت وداد لا تحكي.
رأسها ينحني قليلاً، وتعمل طوال النهار بلا تأفف لا تنتظر شيئا، وتنظر إلى الأشياء وكأنها لا ترى.
عيناها كبيرتان وغائمتان ، وهي كالمشدوهة لا تعرف، كأنها لا تعرف تمشي خلف لودي كظلها وتطيعها. وحين كانت المدام تضربها، لم تكن تبكي أو تعترض ، كانت كالظل، كأنها غير موجودة، وصارت تتكلم العربية وتفهم فرنسية المدام، ولم تعد لودي تشكو من الخادمات.
عملت هيك لأني حبيتك وعاملتك متل بنتي، يا بنت الكلب، قالت لها لودي وهي تراها تمشي خلف إسكندر الخارج من البيت.
حين وجدتها لودي مع إسكندر في المطبخ، لم تصدق المرأة عينيها فهذه الفتاة النحيلة التي تشبه الظل، لم تكن امرأة بالنسبة للودي ، كانت لا شيء لكن جنس الرجال. "جنس الرجال دني"، قالت لابنها جورج وهي تبكي.
الشركسية البيضاء لم تفهم.
كانت في المطبخ تجلي الصحون، مدام لودي في سريرها من أجل قيلولة بعد الظهر المقدسة ، الأولاد في المدرسة، والخواجة إسكندر في الصالة يدخن نرجيلته قبل أن يعود إلى عمله.
لم تره في البداية.
أحسّت بلهاثه على عنقها، عرفته من رائحة التنباك العجمي المختلط بلهاثه ، ولكنها لم تتحرك تسمرت في الأرض. وضع يديه على كتفيها وبرمها وأخذها بين ذراعيه، تأوهت ، فتحت عينيها وتأوهت . رأى إسكندر التأوه في العينين، واشتعلت فيه كل الرغبات التي لم يكن يدري بوجودها .
قال لها إنه كاد يبكي من الحب .
وداد إلى جانبه، وهو مستلق على السرير ويشعر بالاختناق ، أمسك بها من يدها وقال لها إنه كاد يبكي في المطبخ، من أجل ذلك تزوجها.
وضعت يدها على رأسه وطلبت منه أن ينام . فأغفى.
كان ، عندما تضع يدها على رأسه وتطلب منه أن ينام، يدخله النعاس ويطفو فوق النوم، بقي هكذا ثلاثين سنة، ينتظر النوم يأتيه عبر يدها الصغيرة الموضوعة على رأسه.
كبرت وداد.
كلها كبرت. رآها إسكندر تكبر تحت لمساته، صدرها استدار ، صارت أطول وأجمل ، الوركان اكتملا، وشعرها طال وطال ، وهو لا يسمح لها بأن تقصه، كل شيء كبر وتغير ما عدا اليد. الديان بقيتا صغيرتين وطريتين وتقودانه إلى النوم.
عندما دخلت لودي إلى المطبخ لم يكن إسكندر يعرف إلى أين سيقوده عمله الطائش هذا. ذهب إلى الفتاة هكذا، كما كان يفعل مع جميع الخادمات. لم يكن يمارس الجنس معهن ، كان يطوش ، كما يروي لأصدقائه على كأس العرق، يقتنص منهن قبلات ولمسات وأشياء صغيرة، من أجل تنشيط الدورة الدموية. ذهب إلى هذه الفتاة كما ذهب إلى سواها ، ولم يكن يخطر بباله أنه سيجاوب زوجته كما أجابها. فهذه لم تكن المرة الأولى التي تكمشه فيها لودي وهو في وضع ملتبس مع إحدى خادماتها. في العادة ، كان يدعي أنه يضرب الفتاة أو يؤنبها، وكانت لودي تفهم وتغض النظر، ويزداد اقتناعها بحقارة الجنس ووساخة الرجال ، وتتحول إلى لوح جامد في السرير.
هذه المرة لم يدّعِ إسكندر أنه يؤنب الشركسية . كان مؤخذا بذلك الماء في عينيها ، وتلك الآهة التي خرجت من أعماقها . احتضنها وشعر بدعسات زوجته، لم يتراجع.
أحكم قبضته على الفتاة وضمها إليه ، وبدأ يشمها. رأته لودي يشمشمها كما يشم الحيوان أنثاه قبل أن يضاجعها، والفتاة تتأوه وكأنها تستسلم . وإسكندر يذوب ويفقد قدرته على السيطرة.
وحين صرخت زوجته جاء صوتها وكأنه خارج من بئر عميقة . لم يحرك فيه صوت زوجته شيئاً، أمسك بيد الفتاة ومضى بها وتزوجها.
أما هي ، فهنا السؤال.
لا أحد يعرف بما شعرت، أو فيم فكرت، أو ماذا تريد،؟ مشت وراءه وذهبت إلى حيث أخذها.
هل كانت ترى الأشياء كما رأتها في النهاية؟ هل كانت تعرف؟ هل كانت الطرق التي قطعتها بين بيروت وصوفر تعني لها شيئا؟
لا أحد يعرف .
إسكندر لم يرو لأحد. أخذها ومضى بها إلى صوفر ، نزلا في فندق " صوفر الكبير" في الجبل، حيث حولها إلى سيدة، وعاد بها ليسكنا في بيتهما الجديد المحاط برائحة أشجار الفتنة والياسمين.
طوال حياته معها لم يسأل سؤالا واحدا عن بلادها أو أهلها ، كان حين يراها تبكي ، وكانت تبكي دائما، يتركها تغتسل بدموعها ولا يسأل. وهي لم تكن تحكي.
صارت تتكلم العربية بطلاقة، تعلمت القراءة والكتابة وحدها، كانت تسرق الحروف من المجلات والصحف، وتسأل إسكندر والرجل يبتسم ويعلمها. صارت كجميع الناس وعاشت. كانت نصف ممرضة ونصف راهبة ، وأقامت مع الرجل تعتني به وتمرضه وتخدمه ، وتضع يدها الصغيرة على رأسه، ولم تتركه.
عاش إسكندر عاشقا، وككل العاشقين كان يخاف من الفتاة البيضاء . يراها تتركه فيخاف. هكذا كان يراها في لحظات مرضه، تختفي من حياته كما دخلتها. تدخل الحائط الأبيض الذي جاءت منه وتمضي ، لكنه كان يعرف أنه لا مكان لها تذهب إليه، ومع ذلك لم يخصها بشيء في وصيته، كان يعرف أنه عندما سيموت، فإن وداد ستعود إلى بلادها. مات إسكندر ووداد لم تعد، بقيت في البيت نفسه، عاشت نمط الحياة الذي تعودت عليه أيام زوجها، كأنه لم يمت . إحدى جاراتها وكانت خياطتها وصديقتها الوحيدة قالت إنها رأتها مرة وهي تفتح الخزانة وتكلم ثياب زوجها التي بقيت معلقة في الخزانة، وكانت وداد تغسلها وتكويها وتعيدها إلى مكانها.
تعلمت وداد القراءة والكتابة، وصارت تذهب كل يوم إلى ميتم، زهرة الإحسان، حيث عملت كمتطوعة . إسكندر لم يعترض. فكر أن هذا يساعدها على التأقلم مع حياتها الجديدة. كانت تريد أن تخدم الفتيات اليتيمات، ولكنها وجدتهن وقد تحولن إلى ما يشبه الخادمات ، فصارت تخدم معهن. تأتي كل يوم في العاشرة صباحا بعد أن تنهي عملها المنزلي، وتغرق في شغلها داخل الميتم حتى الثانية بعد الظهر. وحتى عندما كان المرض يشتد على زوجها، ويجبرها على البقاء في المنزل، فإنها لم تنقطع عن عملها في الميتم.
مرة واحدة وافقت على أن تطلب من إسكندر شيئاً
كان إسكندر عندما ينتهي من شرب ثلاث كؤوس من العرق. هي حصته كل مساء، يبدأ بتقبيلها وهو يصرخ، اطلبي يلي بدك، بس قولي، لم تطلب شيئا ، رفضت أن تجلب خادمة إلى البيت، رفضت الذهب والماس وقطعة الأرض التي أراد أن يطويها لها. رفضت كل شيء وعندما طلبت منه ميرنا رفض.
مرة طلبت من زوجها أن يسمح لها بتبني إحدى الفتيات . رفض. قال إن عنده أربع بنات، ولا يجوز أن يتبنى فتاة جديدة.
يومها بكت وداد. ركعت على الأرض ، قبلت قدميه. كان مريضا ويعاني من احتقان في الرئتين، ركعت وصرخت " الله يخلّيلي ياك يا سيدي ، أنت على راسي ، أجرك على راسي ، بس ميرنا". قال لا .
بكت وداد . من يومها صارت الشركسية البيضاء تغرق في البكاء وتعود إسكندر على بكائها.
سأل الطبيب الابن عن أصدقاء المرأة.
جورج نفاع بدأ يشعر بأن ذاكرته تخونه، فهو يصغر وداد بسنة واحدة، الحرب والكهولة والابن المريض، والهموم، جعلت ذاكرته تتقطع ، فصار يجد صعوبة في تذكر أسماء الناس والأماكن، ولكن هذا لم يؤثر على سلامة عقله، وعلى قدرته على إدارة أعماله التجارية، رغم ظروف الحرب الصعبة.
قال جورج للطبيب إنه لا يعرف شيئا عن أصدقاء المرأة. صحيح أنه واظب على زيارة الشركسية بعد وفاة والده، ولكنه لا يعرف عنها شيئا. قال لزوجته إنها امرأة نبيلة ، جاءها بعد ثلاثة أيام على دفن والده ليحدثها عن الميراث، فقالت لا . كله لكم يا ابني ، أنا ما بدي شيء غير السترة، وقعت التنازل عن كل شيء، وأصرت على التنازل عن حصتها في ملكية البيت الذي تسكن فيه ، وقالت إنها ستلحق بزوجها بسرعة، ولا لزوم لإجراءات نقل الميراث المعقدة . لكنها عاشت ثلاثين سنة أخرى.
قالت لجورج إنها ستعود بسرعة، ففهم أنها تتكلم عن اللحاق بزوجها، ولكنها لم تعد . بقيت في البيت، وحافظت على نمط حياتها كما كان . شيء واحد تغير، وهذا لا علاقة له بموت الزوج، لأنه حصل قبل الوفاة، فلقد توقفت وداد عن الذهاب للعمل في الميتم بعد أن تزوجت ميرنا، الفتاة التي كانت طلبها الوحيد من زوجها، عندما لم تجد وداد ميرنا مع الفتيات، تركت كل شيء وركضت إلى مكتب الرئيسة "بربارة" وسألتها عن ميرنا. جاوبتها الراهبة بأنهم زوجوها وسافرت. قالت الراهبة إن هذا أفضل ، ولم تخبر وداد باسم للزوج ولا بالمكان الذي ذهبت إليه الفتاة.
انقطعت وداد عن الذهاب إلى الميتم، وصارت تقضي وقتها كله في البيت لا تخرج منه. بقيت هكذا ثلاث سنوات، سنة قبل وفاة الزوج، وسنتين بعد وفاته، ثم صارت تتردد على مأوى العجزة وتعمل هناك.
جورج نفاع يعتقد أنها أقامت علاقة مع الخواجة سيرافيم ، وهو صيدلاني عجوز كان يعيش وحيدا مع زوجته ولا أولاد لهما. بعد وفاة الزوجة أغلق صيدليته ، وقرر أن يسكن في غرفة مستقلة داخل المأوى. وداد كانت تزوره في صومعته (هكذا كان يسمي غرفته التي علق على حيطانها الأربعة عشرين أيقونة بيزنطية) وتخدمه مجانا، من ضمن عملها في المأوى. وسرت شائعة أنها صاحبته، جورج لا ينفي هذا الاحتمال ولكنه لم يجرؤ أن يسألها عن الموضوع. وحين مات الخواجة سيرافيم مشت وداد كالرجال خلف النعش، سهرت معه طوال الليل في الكنيسة قبل دفنه، ولكهنا لم تبك.
"من هذه المرأة ؟ " سألتني مريم.
كنا نمشي وسط ذلك الدمار وكأننا نمشي في الفضاء . فضاء الدمار يجعلك تشعر أنك معلق في شرفة مفصولة عن كل شيء.
قالت مريم إن المرأة هي المرأة، وإن وداد كانت تبحث عن اسمها، فلم تجده، ولذلك عادت إلى حيث يجب أن تعود.
سامية لم تعد.
سامية تمضي إلى حيث تمضي، قلت لمريم. قلت لها إن سامية حين أمسكتني من يدي أمام القبر، وصعد إلى عيني ذلك الحب الذي لم يجرؤ أن يتحول إلى كلمات ، كانت تبحث عن فيصل، وهي تشير إلى قبر علي أبو طوق، فعلي قد يكون فيصل، وأما أنا فلا . ولكن لماذا نادتني فيصل، ولماذا جاوبتها حين سمتني باسم آخر؟ هل لأنني مجرد عاشق عابر أم أن العابرين لا يسكنون.
"الحياة زيارة عابرة" قالت وداد لابن زوجها إن المسألة لا تحرز، خود كل شيء يا ابني أنا ما بدي شيء.
يومها قبلها جورج ودمعت عيناه، وصار يزورها مرة في الأسبوع يقضي معها بضع دقائق ويذهب يسألها إذا كانت بحاجة إلى شيء، ودائما لم تكن بحاجة إلى شيء ، في التاسعة من صباح كل سبت كان يأتي ، فتكون ركوة القهوة جاهزة يشرب قهوته ويذهب، وهي تبقى كالظل في مكانها تجلس على طرف الكرسي بشالها الأزرق الذي يغطي شعرها الطويل، ورأسها شبه منحن.
لا شيء تغير .
الحرب بتوحشها وغرابتها لم تغير شيئا في حياة المرأة. مرة واحدة تغير كل شيء . أصيب منزل جورج بقذيفة من عيار 155 ميليمترا، انهدم البيت تقريبا، ولم يصب أحد بأذى ما عدا إسكندر الصغير. عندما أصيب إسكندر كسرت وداد كل التقاليد وذهبت إليه في المستشفى، وبقيت إلى جانبه ستة أشهر لا تتركه ليلا ولا نهارا. تخدمه كأنها ممرضة، ولا تسأل شيئا ولا تتعب وبعد أن خرج من المستشفى مشلولا عادت وداد إلى منزلها، ولم تزره في البيت ولا مرة. كانت تسأل عنه جورج دون أن تسميه تسأل ولا تنتظر الجواب، وجورج لم يكن يجاوب، كان يهز رأسه بينما تسكب له فنجان القهوة، يشربها دون أن تشرب معه.
ثم جاءت النهاية.
مرضت وداد، بدأت تشعر بتثاقل في قدميها ، ثم صارت تفضل البقاء في سريرها. وذات صباح حدث ذلك الشيء الغريب . فجأة نسيت وداد اللغة. وداد الشركسية التي كانت تتكلم اللغة العربية ولا تعرف لغة أخرى، نسيت لغتها.
روى جورج نفاع أن المرأة عاشت في مرضها تجربتين مرعبتين : تجربة الشعر وتجربة اللغة.
شعرها الأبيض المتماوج الذي كان ينحدر على كتفيها بدأ يتناثر ويتساقط، مسالة تساقط الشعر حيرت الجميع. صار شعرها خصلا تتساقط على كتفيها، وكانت تمسح الخصل وترميها على الأرض دون أن يبدو عليها التأثر أو الخوف.
جورج نفاع الذي صار يزورها يومياً في فترة مرضها، كان يتوقع كل صباح أن يجدها صلعاء ولكنه كان يكتشف أن شعرها ما يزال فوق رأسها، وأنها حين كانت ترفع رأسها لترد تحيته يتساقط الشعر الأبيض على كتفيها، فتنفضه وتتابع كلامها، كأن لا شيء .
وماتت اللغة.
رفضت أن تذهب لتعيش في منزل ابن زوجها ، ورفضت الذهاب إلى المستشفى ، ونظرت إلى جورج باحتقار حين اقترح عليها مأوى العجزة، حتى الطبيب نجيب كنعان الذي كان صديقاً حميماً لزوجته ، طردته وقالت إنها لا تريد أحدا.
ثم ماتت.
لا لم تمت.
قبل أن تموت ماتت اللغة ونسيت كل شيء.
جاءها جورج في الصباح كعادته يحمل لها الطعام والثياب النظيفة، فنظرت إليه كالمعتوهة وكأنها لا تعرفه. سألها مرة ثانية ومرة ثانية تكلمت وكانت الكلمات غير الكلمات. لم يفهم جورج وشعر بخوف شديد، واحتار ماذا يفعل.
" شو بك يا أمي".
كانت هذه المرة الأولى التي يسميها فيها أمّه.
الأم كانت تحكي وتحكي، بلغة أخرى، لم يفهم منها جورج كلمة واحدة.
استدعى جورج الدكتور نجيب الذي تلفن إلى المستشفى وجلب سيارة إسعاف، وتم نقل المرأة بالقوة إلى مستشفى " الجعيتاوي". وهناك اكتشفت إحدى الممرضات، وهي تحاول منعها من مغادرة سريرها، أن المرأة قوية كثور، وتتكلم لغة قريبة من التركية.
الممرضة الأرمنية "تالين" تعرف بعض الكلمات التركية من جدتها التي هربت من تركيا في المذبحة الكبرى التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى. قالت " تالين" لجورج إن المرأة كانت تتكلم لغة قريبة من التركية. ولا تحكي سوى في موضوع واحد، الطفولة، حكت عن طفولتها في تلك البلاد البعيدة، قبل أن تخطف وتباع في بيروت، وتتزوج الخواجة إسكندر نفاع.
قبل أن تهرب من المستشفى زارها الدكتور نجيب، وحاول أن يعيد لها لغتها أو أن يجعلها تتذكر حياتها في بيروت، ولكن دون جدوى، قال الدكتور إنها حالة معروفة في طب الكهول، إذ يقوم الدماغ بحجب الحاضر وإلغائه ، واستعادة الماضي، حتى اللغة المكتسبة تذهب، ولا تعود على شاشة الدماغ سوى ذاكرة الطفولة ولغتها.
" نسيت كل شيء، كأنها لم تكن"، قال جورج لزوجته وهو يبكي.
وداد كانت .
في الخامسة من صباح 9 أيار 1976 هربت من المستشفى، في الصباح الباكر ، حين يكون النعاس قد شل قدرة الممرضات على المراقبة، لبست وداد ثيابها وغادرت المستشفى ولم تعد، ووجدت بعد ثلاثة أيام جثة على طريق الشام قرب مدخل حي البرجاوي . مشت وحيدة ثم ماتت. ربما كانت تبحث عن بلادها التي استفاقت من حفرة الذاكرة، فجأة قامت الذاكرة وكأنها انفتحت على قاع بئر وجرفها القبر إلى حيث لا عودة.
إسكندر نفاع، زوجها، لم يكن يعلم أن هذه الشركسية لم تكن شركسية، وأنها خلال حياتها الطويلة في هذه المدينة كانت غريبة وبلا ذاكرة. كان يشعر أنها خلقت من ضلعه وأنها خلال حياتها الطويلة في هذه المدينة كانت غريبة وبلا ذاكرة. كان يشعر أنها خلقت من ضلعه وأنها له وحده. وخلال مرضه الطويل كان يشعر أنه والدها وزوجها. يشعر أنه خلقها من عدم، وحولها إلى سيدة.
وحين نسيت كل شيء، تذكرت كل شيء .
" أين الحقيقة؟" ، سألني إميل.
هل حقيقة وداد البيضاء هي حياتها كما نرويها اليوم، أم هي حياتها التي لم تعشها، أم لا هذه ولا تلك؟
وسقطت المرأة البيضاء وسط أزير الرصاص في بيروت التي كانت تتمزق ذاكرتها وتنثر فوق آلاف البنادق المتواجهة.
والإنسان ينسى كما قالت العرب . لكن لا ، حين ينسى يتذكر. هكذا نحن نتذكر ولا ننسى، ألم تكن هذه الحروب تمارين الذاكرة ؟ يقولون إن الحرب تمرين على النسيان، إذ لولا أننا نسينا هذه المجازر التي خضناها لقتلنا تأنيب الضمير. الضمير أيها السادة مسالة أخرى. وتحتاج إلى تفكير جديد.
وداد التي استفاقت من غفوتها البيروتية الطويلة، ذهبت إلى المكان الوحيد حيث الذاكرة، ذهبت إلى الحرب . وهناك لم تجد قريتها التي لا تعرف اسمها، ولا يعرف أحد اسمها ولم تجد أمها وإخوتها، هناك وجدتنا ونحن نحمل بنادقنا ودمنا. هناك غرقت الشركسية البيضاء في دمها، وانطوت حكايتها كما تطوى حكاية في كتاب.
انطوت وداد كما تنطوي الحكايات، ومعها انطوت ذاكرتها المشوشة بلغات اختلط بعضها ببعض، وتحولت في النهاية إلى حكاية من السكوت كانت وداد تسكت دائماً امرأة يلفها السكوت وتلبسها ، غمامة بيضاء مرسومة فوق عينيها.
أخبرت هذه القصة لسلمان رشدي.
" تصلح مادة لرواية"، قال.
" أعرف "، قلت، لكنني أخاف من كتابتها .
لم يسألني لماذا أخاف. فالكاتب يعرف أن الكتابة هي العلاقة المطلقة بالخوف. صفحة الكتابة هي صفحة الخوف. والخوف ليس على الحكاية بل منها، نخاف أن تبتلعنا الحكاية وتحيلنا إلى هامش فيها، فنمّحي بدل أن نسطع، ونختفي بدل أن نظهر ونتحول إلى جزء من حكاية لا نعلم كيف ستنتهي بنا ولا إلى أين ستقودنا.
أخبرت رشدي هذه الحكاية عندما التقيت به في لندن عام 1988 ، قبل أن يصدر كتابه " آيات شيطانية"، وتتحول الكتابة إلى مسار يجعل من الكلمات أشبه بحبل يتدلى نحو بئر الموت. كنت أريد أن أروي له حكاية طبيب القرية، ولكنني بدلاً من ذلك أخبرته قصة الشركسية البيضاء.
" وأنت ؟ " ، سألته .
" أنا ماذا ؟ " ، قال .
" أنت، ما علاقتك باللغة؟".
ابتسم بدهاء وكأنه، يعرف إلى أي منفى ستقوده كلماته.
سألته عن علاقته بلغته الأصلية " الأوردو"، فروى لي أنه أتى إلى بريطانيا وكان في السادسة عشرة، وأنه يتكلم في مناماته باللغتين الإنكليزية والأوردو، ولكن الإنكليزية طغت على اللغة الأخرى، "
ليس الآن"، قلت.
" متى ؟" سألني".
أخبرته أننا نستطيع أن نكتب رواية عن كاتب هندي جاء إلى لندن عندما كان في السادسة عشرة ، وكتب رواياته بالإنكليزية . وفي عمر معين يصاب بذلك المرض، فينسى الإنكليزية ويعود إلى التكلم بلغته الأصلية، ويصبح عاجزاً عن قراءة كتبه.
" لكنني لم أنس الأوردو كي أتذكرها، كما فعلت بطلتك الشركسية، اخترت الإنكليزية بشكل واع. وحدثني عن علاقته باللغة الإنكليزية وكيف يشعر بالسيطرة عليها.
" اللغة كالأرض " ، قلت له . نستطيع احتلال لغة الآخرين كما نستطيع احتلال أرضهم . لكن المسألة هي من نحن. هل نهرب من أعدائنا إلى أعدائنا؟ هل نقبل أن نروي ، وبدل أن تقرأ حكاياتنا التي نكتبها نتحول نحن إلى حكاية؟
أذكر أن رشدي أهداني يومها مخطوطة كتابه " آيات شيطانية".
كنا نناقش رواية " العار " وكنت أقول له إن ما يخيفني في أدب العالم الثالث هو منحاه الغرائبي الذي يحوله، إلى صفحة من ماضي العالم، ويصنفه في الغرب في باب العجائب التي لا يمكن إيجاد حلول منطقية لمشكلاتها.
لست أذكر جيدا ماذا حكينا، ولكنني أذكر أننا شربنا قليلا من الخمر وتحدثنا في النهاية عن طبيب القرية، وتلك حكاية أخرى روتها لي مريم أو رويتها لها، لم أعد أذكر. كنت كغيري من القراء، مدهوشا بحكاية ثقوب الملاءة، التي كتبها سلمان رشدي في روايته ، أطفال منتصف الليل، في رواية رشدي يقع الطبيب آدم عزيز في غرام مريضته نسيم من خلال ثقب الملاءة. تقول الحكاية إن الفتاة كانت تطلب الطبيب كلما شعرت بألم في جسمها. ويأتي الطبيب لزيارتها تحت نظرات والدها القاسية، ويفحصها دون أن يفحصها، واكتشف الأب طريقة غريبة كي يعرض جسم ابنته على الطبيب. كانت الفتاة تقف خلف ملاءة مثقوبة ، وتعرض من خلال الثقب الجزء المريض من جسدها. تكررت الأمراض وتكررت الزيارات، وانتهى الأمر بالطبيب إلى أن يرى جميع أجزاء نسيم من خلال الثقب. وسط الدكتور آدم في عشق فتاة الثقب وتزوجها كي يضم الثقوب بعضها إلى بعض وتقوم عيناه بتجميع أجزاء الجسد المقطع.
عندما رويت هذه الحكاية لمريم أخبرتني حكاية طبيب القرية . كنت أعرف الحكاية لأنني سمعتها من قريب لنا ما يزال يسكن قرية " المنصف" في شمالي لبنان، نحن في الأصل من تلك القرية، هاجرنا منها منذ ثلاثمائة سنة لأسباب مجهولة ، هكذا أخبرني أبي ، وأنا صدقته لأنني بحاجة إلى أصل قروين فحين تعيش في بيروت تحتاج إلى إثبات فكرة أن بيروت هي خيار لا مدينة انتماء. تختار بيروت لا لأنك بيروتي ، بل لأنك تريد أن تكون بيروتياً. هذا هو سر بيروت الذي يعرفه جميع الذين عاشوا فيها.
في تلك القرية، منذ سنتين سنة أو أكثر ، عاش طبيب متجول كان واحدا من أوائل خريجي معهد الطب الفرنسي في بيروت، وكان يدعى الدكتور لطفي بركات ، أخبار الطبيب الشخصية ، وعلاقاته النسائية المتعددة، وادعاء ابنائه بأن لهم إخوة غير شرعيين في كثير من قرى جبل لبنان، لا تهمنا الآن. ما يهمنا هو كيف كان يفحص النساء ، في تلك الأيام ، نقول الحكاية، لم يكن يحق للطبيب أن يرى جسم المرأة حتى ولو كانت تحتضر، فهذا في عرف سكان جبل لبنان، من مختلف طوائفهم، كان يعتبر انتهاكا للشرف، وطبيبنا الذي كان يركب حماره ويدور بين القرى ، كان يحمل في حقيبته تمثالاً صغيراً لامرأة عارية . طلبت من أبي أن يأخذني إلى " المنصف" كي نبحث عن التمثال في بيوت أبناء الطبيب وأحفاده، ولكن أبي، رغم احترامه للأدب ، كان يعتقد أن على الأديب أن يكون مثل جبران خليل جبران، يؤلف الشعر والقصص من خياله الشخصين ولا يذهب من مكان إلى مكان بحثا عنها، كما أفعل أنا . " الأديب ليس بائعا متجولا"، قال أبي، هو الذي يؤلف ما يقوله الناس، ولا يسرق أفكار الناس، ويقول إنها الأدب". وقال إنه لا يعرف " المنصف" إلا من خلال زيارة قام بها منذ أربعين سنة ، وأن زيارتي إلى تلك القرية البعيدة لن تساعدني في العثور على التمثال أو على القصة.
كان الطبيب يحمل في حقيبته تمثالاً صغيراً لامرأة عارية، ومع التمثال قضيب نحيل قصير من الخيزران. يدخل إلى منزل المريضة، يضع التمثال الصغير على الطاولة تكون هي في السرير تتأوه، يطلب منها أن تهدأ قليلا وتحدد له مكان الوجع. والمريضة، مثل كل المرضى حين يداهمهم الألم، لا تكون قادرة على تحديد المكان الحقيقي لألمها. يطلب منها الطبيب أن تفتح عينيها جيدا، ويشرح لها أنه سيمرر القضيب على جسد التمثال، وأن عليها أن تخبره عندما يمس القضيب مكان الوجع في جسدها، وكان لهذه الطريقة فعل السحر في مريضات الدكتور لطفي بركات.
عندما ترى المريضة القضيب الصغير وهو يمر فوق التمثال العاري، كانت تبدأ في التأوه والصراخ، يسحب القضيب ويطلب من مريضته أن تهدأ قليلاً، لأن المريضة كانت ما إن يمس القضيب أي جزء من
جسد التمثال حتى نبدأ بالصراخ، وهو ما يعطل على الطبيب إمكانية تحديد مكان الوجع بشكل دقيق.
كان الطبيب بعد جولة التأوه والصراخ الأولى، يعطي مريضته كوب ماء، ويطلب منها أن تشربه بتمهل. ثم يجلس على كرسي ويدخن سيجارة كان يمضي وقتا في لفها وتدخينها ويترك مريضته تشعر بالأمان، ولا يطلب من أهلها مغادرة الغرفة، ولكنهم بنظرة منه تخترق بياض دخان لفافته، كانوا يخرجون ويتركونه وحيدا مع مريضته في غرفة مفتوحة الباب.
ومن جديد، يبدأ الطبيب بتمرير القضيب بهدوء فوق أجزاء الجسد العاري الموضوع أمامه على شكل تمثال، وتأخذ المريضة في التأوه بصوت منخفض والقضيب يمر، كان الطبيب في هذه المرحلة ، يمرر القضيب من الرأس حتى القدمين ببطء وهدوء، ويترك مريضته تتأوه ، ثم حين يصل إلى مكان الوجع يرتفع صراخ الالم. كانت المريضة تصرخ كحيوان جريح، والطبيب يشد على المكان بالقضيب الذي يهتز بين أصابعه والصراخ يرتفع . صراخ وأنين وأسنان تصطك ، وكأن المريضة تضع مولودا. ويرفع الطبيب القضيب عن جسد التمثال ، فتسكت المرأة ، ثم ترتجف بالحرارة والعرق، ويطلب من أهلها لفها بالأغطية السميكة، ويترك الغرفة هو والتمثال والقضيب والحقيبة ويصف الدواء. كان الطبيب يعلم أن مريضته شفيت عندما يرى الارتجافة والعرق يجتاحان جسدها. وكان يصف الدواء لأنه ضروري من أجل إيهامها بأن الدواء سيشفيها . ولكنه كان يعرف أن المريضة شفيت وأنه يستطيع أن ينصرف الآن بهدوء.
كنت أريد أن أقول لسلمان رشدي إن الفرق بين حكايته بين الدكتور آدم وحكاية مريم عن الدكتور لطفي بركات هو مجرد فرق لغوي. في روايته هناك امرأة شرقية تروي بلغتها ومن وجهة نظرها، ولذلك غطت نسفها بملاءة مثقوبة ، وتركت الطبيب يسقط في غرامها قطعة قطعة، وأما في حكاية مريم فإن من يروي هو رجل شرقي. قضيب الخيزران هو رمز شبيه برمز الثقب في الملاءة. ولكن ماذا لو التقى الرمزان؟ ماذا لو وضعنا قضيب الدكتور لطفي في يد الدكتور آدم؟ هل كانت القصة ممكنة؟ القصة ممكنة فقط حين يكون أحد الطرفين رمزاً، وإلا تحولت الحكاية إلى واقع مستحيل التصديق، أي إلى ما يشبه أدب العالم الثالث الشائع هذه الأيام.
لست أذكر ماذا كانت ردة فعل سلمان رشدي على حكاية طبيب القرى، كنت مشغولاً بأسئلتي عن اللغة والاحتلال والهجرة، وكنت أراه أمامي كبطل محتمل لحكايته. أراه كما رأيت وداد البيضاء ، ولكن هنا ، ومرة أخرى ، وداد لم تختر حياتها، بل اختارت موتها. وأما نحن الذين ندعي أننا اخترنا حياتنا فمن المؤكد أننا لن نستطيع اختيار موتنا، سوف يأتي الموت ويلفنا ونحن لا ندري، ما هو الخيار الأفضل : أن نختار كيف نعيش، أو أن نختار كيف نموت؟
لن أقول لست أدري ن فلقد قلتها عشرات المرات في هذه الرواية، ما أعرفه أنني قلت لرشدي إن خياره سوف ينتهي به بطلا محتملا في هذا الزمن ، هو الأسوأ بين مصائر كل الأبطال. كان ينتظره خطر الموت وخطر الكتابة وخطر الحرية،
نهض رشدي وأعطاني مخطوطة الآيات الشيطانية . ودعته ومشيت. وبعد ذلك بعام صدرت روايته، وتعرفون بقية الحكاية.
الحكاية إذن هي ماذا نروي.
نجد الحكايات مرمية في شوارع الذاكرة وأزقة المخيلة، كيف نجمعها لنقيم نسقا فوق أرض تتحطم فيها كل الأنساق؟
من نحكي كي نروي؟
ولماذا لم ترو هذه الحكايات أو ما يشبهها من قبل ؟ لماذا لا نجد في كل نصوص مارون عبود حكاية تشبه حكاية الدكتور لطفي بركات؟ والحكاية لم أؤلفها أنا ، مثل رشدي الذي لم يؤلف حكاية الملاءة، ومثل نجيب محفوظ الذي لم يؤلف حكاية السيد أحمد عبد الجواد. الحكاية موجودة ، روتها مريم أو رويتها أنا لا فرق.
لماذا لم نرو حكايتنا قبل هذه الحرب؟
هل لأننا كنا لا نعرف أن نروي، ومارون عبود هو أستاذ المعرفة والحكاية واللغة والسرد، أم لأن سطح الأشياء كان يمحو الحكايات ويدخلها في مملكة النسيان.
مرة أخرى لست أدري.
لكنني أستطيع أن أؤكد لمريم ، وأنا أروي لها ، وهي أمامي وإلى جانبي وحولي، أنني أرى التمثال أمامي. طوله خمسة وعشرون سنتمترا ، أبيض بياضه، مائل قليلا عند الركبة، عيناها صغيرتان كالعيون الصينية، تقف على الطاولة، وتنتظر.
كانت الدمية نائمة في حقيبة الدكتور لطفي بركات إلى جانب قضيب الخيزران القصير الذي ننتظره كي تسمع الصراخ والبكاء.
هل هي مريم النائمة إلى جانبي، أم هو منام طويل؟
في ذلك الزمان، كانت الحكايات لا تشبه الحكايات.
قالت مريم إنها لم تكن تعرف أن كل هذا سيصبر حكاية. المهم أن لا نعرف، قالت، ثم أغفت أخذتها بين يدي، ثم تركتها تنزلق في النوم.
ابتعدت عيناها في إغماضة خجولة، اقتربت من جسدها الأبيض، استرخت كأنها تنتظر أن أتوسدها. أخذتها بين يدي، ارتفع الوهج، واشتعلت حرارة جسدها وكأنها محمومة.
في ذلك الزمان ، عندما توسدت مريم، لم أكن أعرف هل أتوسدها أم أحتضن الشركسية البيضاء. هل هي الحكاية أم هي من روى لي الحكاية؟ وسألتني : هل الحب هو قصة الحب"؟ وطلبت مني أن أروي لها حكاية.
ليلتها تساءلت عن منام فيصل. المنام احتل مخيلتي وأنا أمشي بين الأزقة المهدمة في مخيم شاتيلا. كانت البيوت تنحني على البيوت وكأنها تحتضنها ، وأنا أمشي فوق الوحل والتراب ، أبحث عن سامية وأسأل عن فيصل.
" مات فيصل" قالت سامية، وهي تمسك بي من يدي لتأخذني إلى قبر على أبي طوق.
وفيصل الذي مات ، ماذا رأى في منامه تلك الليلة من أيلول 1982، حين أصبت ونام بين جثث أمه وأخواته وأخوته؟
عندما روى لي كنت في المستشفى ، وكنت أبحث عنه، لا ، لم أكن أبحث عنه، كنت أبحث عن الحكاية وعن أبطالها.
كيف أصفه؟
فتى في الحادية عشرة أسمر مثل الفلسطينيين أو كما نتخيل الفلسطينيين يشبه هؤلاء الفتيان الذين يرمون الحجارة في شوارع غزة، ونابلس، لكنه كان مهدما، هل سبق لكن أن رأيتم فتى مهدما ؟ عادة نستخدم كلمة مهدم لنصف رجلا كهلاً أصيب بكارثة وأما هذا الفتى فكان مهدماً ولم يكن يشبه الكهول، وجه أسمر ناصع، عينان صغيرتان ترقصان في الوجه، أنف مستقيم شفة ممتلئة تتدلى ، وكلام .
حكى فيصل كلاما كثيرا.
حكى واستمعت إليه وكأنني في منام، لست أدري لماذا بدا صوته هكذا، كأنه لم يكن، مثل الأصوات في المنامات ، في المنام لا نسمع الصوت، نتذكره عندما نستيقظ ، وأما حين نسمعه فهذا يعين أن المنام انتهى.
روى كيف تسد الجثث كي لا يموت.
" دخل المسلحون وبدأ إطلاق النار . كان صوت الرشاشات قويا. كان الصوت وبدأت الأجساد تتساقط وتتكوم فوق بعضها . تكدسنا فوق بعضنا . قال فيصل كانت العائلة تتفرج على التلفزيون ، حين بدأت قنابل الإنارة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ثم دخل الكتائبيون وأطلقوا النار.
" لم أر وجوههم ، قال فيصل
لا يذكر فيصل الوجوه ولكنه يذكر الأجساد " كانت الأجساد ثقيلة" قال يذكر ثقل جسد شقيقته الصغيرة، التي كانت في السابعة ، وكيف تيبس وصار كالحطب. وبعد ساعات طويلة، يقول فيصل إنه ربما أغفى خلالها أو أغمى عليه بسبب إصابته هرب. ركض في الشارع الرئيسي حيث الذباب والجثث والرائحة. نام من الواحدة فجرا حتى الخامسة صباحاً ثم بدا يركض ، وعندما رأي الصحافيين الأجانب تكوم على الأرض ، ولم يحك.
هكذا تطلع الحقيقة من المنامات.
عندما حلم فيصل بالرجوع إلى فلسطين رأى بلاده موحشة، ووجد نفسه وحيدا. وعندما توسد أجساد الموتى ركض في شارع الجثث ، وعندما رجع إلى شاتيلا ليقاتل في حرب المخيمات التي دامت ثلاث سنوات ، وليعيش الحصار الطويل في مخيم شاتيلا ، كان يبحث عن طريقة للذهاب إلى فلسطين. فلسطين جاءته عام 1987 على شكل طلقة في الرأس وقبر في جامع.
هل هذه هي الحقيقة؟ سألت إميل آزاييف .
هل أخبرته قصة فيصل، أم اكتفيت بأن أشرح له بأن حكاية جرجي الراهب تستحق أن تكتب، لست متأكدا ولكنني أخبرته عن هجره وديع السخن، شريك إسكندر نفاع، إلى فلسطين عام 1959 . أخبرته كيف باع الرجل كل شيء . وبسرعة من أجل اللحاق بابنه الوحيد موسى أو موشيه كما كانوا ينادونه في البيت. موسى أنهى دراسته الثانوية في مدرسة " الاليانس" في " وادي ابو جميل" في بيروت، وهاجر، اختفى من المنزل، ترك رسالة لوالدة يقول فيها إنه هاجر إلى إسرائيل. يومها انهدم وديع السخن من الداخل، لا لأنه كان ضد الهجرة إلى إسرائيل أو ضد المشروع الصهيوني ، لا ، المسألة مختلفة . فالرجل كان مستقراً في بيروت، لقد وصل إلى نهاية مطاف عمره، وهو مطالب اليوم بأن يهاجر ويبدأ حياته من جديد بعد أن وصل إلى مشارف السبعين.
عندما جاء جورج نفاع ليشتري كل شيء ارتفعت الكراهية، كان وديع السخن يرتجف بالكراهية، وجورج أيضاً. وفجأة لم يعد هناك مكان لأي عاطفة ، سوى ذلك الشعور بالاختناق.
" أنتم " قال وديع السخن ، ولم يستخدم عبارة " يا أبني ، كما كان يفعل في الماضي، أنتم تريدون أن تشتروا كل شيء ببلاش".
كان مستعجلا على البيع وعلى الرحيل.
جورج نفاع الذي اشترى كل شيء، لا ببلاش، كما اتهمه السخن ولكن بأسعار معقولة نتيجة تدهور الحالة الأقتصادية في البلاد بعد الحرب الأهلية التي جرت في لبنان عام 1958 كان هو أيضاً مستعجلاً على الدفع وعلى الخروج من ذلك المنزل.
رحل وديع السخن انقطعت أخباره. حتى ابنته راحيل التي كانت متزوجة من رجل بيروتي مسلم يدعى كامل الأرناؤوط ، لم تعد تعرف عنه شيئا، أو هكذا ادعت ، وفي تل أبيب مات السخن بعد وصوله بثلاث سنوات، وأقامت زوجته في منزل ابنها الذي كان يعمل مهندسا في مدينة حيفا.
" لم يحتمل أن يصبح لا شيء، مجرد إنسان متقاعد، كتبت الأم لابنتها، وراحيل لم ترو لأحد ظروف حياة أهلها في تل أبيب ثم في حيفا، حتى زوجها لم يسألها شيئا عن هذا الموضوع.
حكاية راحيل مختلفة عن حكاية الشركسية البيضاء،
راحيل لا تمتلك حكاية، حتى أصلها اليهودي نسيه الناس، ولم يذكرها به أحد. وأما وداد الشركسية فقد ركضت في شوارع بيروت وكأنها كانت تركض في أزقة ذاكرتها، وعندما قررت العودة إلى بلادها البعيدة، ذهبت إلى خطوط التماس حيث ماتت ولم يعثر على جثتها إلا بعد ثلاثة أيام.
ماذا أكتب؟
لماذا تبدو حكاية وديع السخن غائمة ولا نهاية لها؟ هنا تقع مفارقة النهاية، مشكلة وديع السخن لم تكن مع ابن شريكه الذي تحول إلى شريكه وصديقه ومثل ابنه وأعز، كما كان يقول. مشكلته كانت ابنه موسى. موسى كان يبحث عن البداية. تكلم عن " أرض إسرائيل" بوصفها بداية كل شيء، بداية الحياة وبداية الحرية. الحرية الشخصية ، الحرية مع النساء ، الحرية من بيروت، الحرية من التقاليد اليهودية الصارمة التي كانت سائدة في البيت. والحرية من الأب. وكان الوالد يوافق ابنه على ضرورة "العودة" وعلى كل شيء. ولكنه لم يكن يريد أن يذهب لأنه لم يكن يستطيع. كان كما قال له ابنه مرة ينتظر الموت ولا شيء آخر.
لم يفهم وديع السخن عبارة الهدف من الحياة، التي كان ابنه يستخدمها بشكل دائم، " هدف الحياة أن نعيش، لا يوجد شيء أهم من أن نعيش"، قال لابنه .
ذهب الابن ليعيش في إسرائيل . صار بيت السخن فارغا ترك موشيه رسالة صغيرة وذهب الأب لم يعد يطيق الحياة، باع كل شيء ورحل، ولم يترك في بيروت سوى ابنته راحيل المتزوجة من رجل مسلم.
اختفى وديع السخن واختفت أخباره ولم يعد جورج نفاع يعرف عنه شيئا ، في تموز1975 ، أي بعد ست عشرة سنة، جاءته راحيل، مع بداية الحرب، وقبل أن تسقط القذيفة على منزل جورج نفاع، ويخرب بيته، ويصاب أبنه بالشلل.
جاءت راحيل وطلبت من جورج مالا، كي تستطيع السفر للالتحاق بابنتها أندريه في باريس. قالت إنها لم تعد تحتمل ، وأنها تعيش وحيدة بعد زوجها، وأن الحرب.. لم يسألها جورج إذا كانت ستذهب إلى هناك. سألها عن موسى وعن والديها. دمعت عيناها وهي تأخذ المال الذي وضعه جورج في مغلف صغير ، وأخبرته عن موت الوالد، وكيف أصيب بالفالج وخرس، وبقي سنتين أخرس قبل أن يموت.
أخبرته أنها سافرت إلى قبرص عندما علمت بمرضه، وتلفتت له من هناك، تكلمت مع أمها ومع موسى. وأما وديع فكان عاجزا عن الكلام. وضعوا له سماعة التلفون على أذنه كي يستمع إلى صوت ابنته، ولكنه لم يكن قادرا على أن يجاوب.
مات ساكنا في تل أبيب، كما عاش ساكنا في بيروت. فوديع السخن، القصير القامة ، المستدير الرأس الأسمر، ذو العينين اللتين تلمعان، لم يكن يتكلم بل كان يهمس، يحيط أصدقاءه وزبائنه بالهمسات. كلامه قليل ، يقترب منك كي يحكي، ويجعلك تفهم دون أن تستمع إلى كلماته.
أخذت راحيل المغلف وشكرت جورج بصوت منخفض ، وكأنها تهمس، ودعها جورج وقال لها إنها مثل ابنته، وأنها تستطيع أن تتكل عليه دائما،
وردت هامسة فلم يسمع جورج غير كلمة شكرا.
أين الخلل في هذه الحكاية؟
هل الخلل في المقارنات وأنا لا أقارن؟ الأشياء تتداعى وتتداخل، كي ترسم طوره المرايا التي تغلف هذا البحر الميت الذي وقفنا على شاطئه مريم وأنا، ورأينا الحكايات تغوص داخل أفقه الرصاصي .
كنت أريد أن أسبح كنت أريد أن أمشي على صفحة الماء، ولكنني لم أجرؤ هذه المرة هذه المرة خفت من الغرق، خفت من عيون الجنود المنتشرين على ضفتي البحر، خفت من البحر.
هل خاف السيد على الصليب؟
لماذا ألبسوه ثياب الخروف وتركوه مذبوحا ، وسط الآلهة، في مأدبة الآلهة كان، وكان الدم الذي غطى السماء.
ذهب إلى الثياب البيضاء ولبسها كي يكون آخر المائتين وأول الأحياء ، كي يكون الأول والآخر فصار كلمة.
ماذا قال لإلهه حين صرخ على الصليب ؟
أسأل ، والسيد لا يجيب.
أسأل، والبحر يستكين بين ضفتي الملح، وأضواء المستعمرات الإسرائيلية تخترق اللون الرصاصي الذي يغطي صفحة السماء.
أسأل ، والسيد يتوسد أجساد مريمانه ،ويموت
وأنا وحدي،
أنا وأنت وهو
وحدنا نواجه هنا السد من العيون المنتفخة بالكراهية .
الحكاية هي المسألة،
والحكاية هي أننا نبحث عن حكايتنا ، وندعي أننا نبحث عن الحقيقة ، نجد الحقيقة فتضيع الحكاية ، وتبدأ من جديد.
وديع السخن لم يكن يمتلك حكاية، استبدل بحكايته الغائبة الكراهية يعبئ بها فراغ اللحظات التي قضاها مع ابن شريكه، حين باعه البيت وحصته في المكتب والدكان لم يكن وديع السخن يكره جورج، كان لا يجد أمامه سوى الكراهية، وهو يقتلع من بيروت ليذهب إلى حيث يجب أن يعود .
ما الفرق بينه وبين الروسية التي تزوجها ألبير آزاييف؟
قال إميل إنه هاجر إلى نيويورك عندما رأى العدالة المستحيلة ، هرب من استحالة حصوله على عدالته إلى عدالة الآخرين، المستحيلة، في أميركا،
في إسرائيل خدم في " جيش الدفاع" خلال حرب تشرين 73 ، أو حرب " يوم الغفران " كما سماها. وبعد ذلك انتقل للعمل في قطاع غزة، قال إنه قرر الهجرة حين رأى ذلك الكهل يمشي جاثيا، يمشي على ركبتيه ويديه ويتراجع إلى الخلف ، خوف من أن تطلق النار على ظهره .
عندما تكون هناك عليك أن تختار بين الكهل وبين حامل البندقية ، لاتستطيع أن لا تختار ، أنا البندقية، وهو الكهل ، فماذا أفعل ؟ بعد نهاية خدمته في الجيش اختار إميل الهجرة إلى أمريكا. الخيار بين حقيقتين قاده إلى الحلم الأمريكي أو الكذبة الأمريكية كما كان يسميها.
إميل يقف، ويشرح لي الفيلم.
على الشاشة الصغيرة، برز رجل كهل ، وحوله امرأة صبية تلبس ملاءة بيضاء، وثلاثة أولاد، صبي وبنتان، الكهل يشير بيده إلى الأشجار داخل كندا بارك، المزروعة بالحشيش الأخضر، وتنتشر فيها المراجيح وحدائق الأطفال.
توقف الكهل عن الدوران حول الأشجار، وبدأ يشرح لابنته وأحفاده، لم يكن يشرح له بل يشرح للكاميرا، يكلم الكاميرا وكأنه يتكلم إلى إنسان. انحنى على الأرض، وبدأ يرسم بإصبعه فوق الحشيش الأخضر، خريطة المنزل الذي لم يعد موجودا ، توقف طويلا أمام المطبخ وتحدث عن الغسالة الأوتوماتيكية التي اشتراها قبل هدم البيت بثلاثة أشهر، نهض وقادهم إلى حيث كانت المقبرة، حقل من الحشيش الأخضر، وكل الاسماء ممحوه.
لم يكن هذا الرجل هو سبب هجرة إميل.
الهجرة كانت بسبب غزة، هناك أمام مخيم الشاطئ، تم تجميع كل الذكور، من عمر 14 سنة حتى 70 سنة ، بعد أن وقف ست ساعات تحت شمس آب الحارقة، مع المئات من الرجال، طلب الرجل الكهل إذناً بالذهاب إلى الخلاء كي يقضي حاجته أذن له إميل الذي كان مجندا في العشرين من عمره، خرج الرجل من الصف ، وبدأ يمشي بتلك الطريقة المخيفة، جثا على ركبتيه ، يداه على الأرض، وتحرك إلى الوراء ، مخافة أن يطلقوا عليه النار في ظهره.
لم تسألني سامية كيف أطلقوا النار على نبيلة،
عندما ذهبت إلى مخيم شاتيلا ، لم تسألني سامية إلا عن نبيلة وابنتها الوحيدة، ولكنها لم تسأل كيف قتلت،
كنت أريدها أن تسأل. أعددت نفسي لأسئلتها، وحضرت أجوبتي عن أسئلة من نوع . كيف أطلقوا النار وأين؟ هل أطلقوا عليها من الوراء أم من الأمام؟
وكانت نبيلة.
1962 : ثانوية الراعي الصالح، في الأشرفية كنا في الصف الأول الثانوي الخامس، ونبيلة سلباق تروي لنا عن فلسطين، أهدتني كتابا لنقولا الدر عنوانه : هكذا ضاعت وهكذا تعود، لا أذكر من الكتاب سوى لو غلافه الأحمر ، وحماسة نبيلة وفخرها وهي تخبرني أن مؤلف الكتاب هو صديق والدها، وأنه يزورهم في البيت.
1988 : بحثت في الأشرفية ، التي يسمونها الجبل الصغيرة أيضا عن ثانوية الراعي الصالح فلم أجدها، الأوتوستراد اخترق الأشرفية وغير معالم الشوارع فيها، وأنا، الذي غبت عنها طوال سنوات الحرب الأهلية ، لم أعد أعرف الأمكنة، اكتشفت حواجز ومسلحين ملتحين، اقتربت كنت أمام مدرستي وقد تحولت إلى الثكنة الرئيسية لميلشيات " القوات اللبنانية".
1966 : ذهبت لزيارة نبيلة في منزلها في عين الرمانة، في ضاحية بيروت الشرقية، وكانت المناسبة نجاحنا في شهادة البكالوريا. كانت تكل هي المرة الأولى والأخيرة التي أزور فيها بيتها، وهناك التقيت شقيقتها الصغرى التي سحرني جمال عينيها.
1976 : دخلت الميلشيات الكتائبية المنزل في عين الرمانة، وكان فيه الأب والأم والأخت الصغرى الجميلة العينين، وقتلوهم . وجدت جثة الفتاة الصغيرة مختبئة قرب السرير، وهي مذبوحة بالبلطة.
1986 : بيروت الغربية ، خلال حرب المخيمات التي حاولت فيها ميلشيات حركة " أمل " السيطرة على المخيمات الفلسطينية في بيروت. كانت نبيلة تركب سيارة أجرة عائدة من عملها في " اليونسيف" حيث كانت مسؤولة عن برامج المساعدات الإنسانية والطبية للمخيمات الفلسطينية ، إلى بيتها في محلة " البربور" أوقفوا السيارة وكانوا ثلاثة مسلحين، وأفرغوا فيها بنادقهم الرشاشة من طراز " كلاشينكوف". عندما أنزلت نبيلة من السيارة، فهمت أن المسالة انتهت . عرفت أن المسلحين الثلاثة المقنعين بالأسود. كانوا يحملون موتها. ترجلت من السيارة ومشت. أحد المسلحين حاول أن يسألها شيكا، وكان يقف بمحاذاتها لحظة نزولها من السيارة لم ترد أو تلتفت . رأت سيارة الأجرة تقلع هاربة بركابها المذعورين. مشت، فأطلقت عليها النار. سمعت الطلقة الأولى ربما، ثم بدا جسدها يتمزق وهو ينتشر، على الرصيف كبقع من المياه والدم. المسلحون غادروا المكان بهدوء وكأنهم لم يفعلوا شيئا ، وبقيت نبيلة مرمية وسط الشارع ، قرب مطعم "حمادة" للفراريج المشوية.
أخبرت سامية عن الجنازة في كنيسة القديسين بطرس وبولس في الحمراء، أخبرتها كيف لم يتكلم أحد مع أحد ، وكيف جاء مسلحان ، يشبهان القتلة، ووقفا أمام باب الكنيسة بعيونهم الناعسة الفارغة، وكانت مقاعد الكنيسة تنوح بصمت ، ونحن نجلس وننظر في وجوه بعضنا المستطيلة ولا نتكلم ، وقف الكاهن أمام المذبح وألقى عظة عن المحبة ، توقف عن الكلام وبدأت دموعه تتساقط فوق لحيته البيضاء. ثم قال لها، قال لنا، إنه لا يريد أن يخاطبنا بل يريد أن يخاطب القتيلة، لم يستخدم كلمة شهيدة، قال قتيلة، وتابع أقول لك إنهم قتلوك لأنك فلسطينية، وأجهش في البكاء.
قلت لسامية إننا لم نكن نعمل أنكم هذا في المخيم ، لم تعودوا قادرين على إقامة المآتم ، لأن المساحات ضاقت بكم فألغيتم القبور.
يومها فهمت أم أحمد، أمسكتني من ذراعي وأخذتني إلى المقبرة الجماعية في المخيم، وكانت قد أقيمت لضحايا مذبحة شاتيلا وصبرا عام 1982 . وفهمت كيف كانت سعيدة وهي تقول بأنهم نجحوا في بناء المقبرة وتسويرها، وارتني تلك الأزهار الغريبة التي نبتت فوق سطح المقبرة الجماعية.
ماذا أحكي؟
الحقيقة لا أعرف كيف. لكننا لم نذهب إلى مطعم " لوكولوس" فأنا لم أكن قد سمعت بهذا المطعم الذي كان يقصده أغنياء بيروت ، وكانت أسعاره نارا. وصلت أنا ومريم إلى أسفل المبنى، حيث رأينا لافتة نصف محطمة تحمل اسم المطعم، وقررنا أن نعود بعد أسبوع،ومعنا طعام وشراب، كي نسكر على شرفة الخراب. ولكننا لم نعد دائما هكذا ، نقرر ولا نذهب ، ثم بعد أن يمر الوقت تختلط الأمور في رأسي، فأتذكر الاشياء التي لم تكن وكأنها كانت .
لكن نبيلة كانت.
وعلي أبو طوق
وفيصل أحمد سالم.
والشركسية البيضاء،
أما جرجي الراهب فهو حكاية،
مع جرجي الراهب تبرز المشكلة .
حكايته كما رويتها لمريم ناقصة، أنها مجموعة افتراضات، ولا يقين في أي منها، ماذا علينا أن نفعل حين نواجه بمثل هذا الوضعية، هل ننسى القصة، أم نحاول أن نرويها بأكثر الأشكال احتمالية.
في الماضي، كان هذا النوع من الحكايات ينسى ويترك للزمن، فيقوم الزمن بإعادة صياغتها وتحويلها إلى ما يشبه الأسطورة، أو إلى حكاية شعبية على أقل تقدير. في الأسطورة تتجمع عناصر اللاوعي الفردي والجماعي ، وأما في الحكاية الشعبية فإن هذه العناصر تتحول إلى رموز تخاطب اللاوعي، ومع الزمن تتحول إلى حكايات للأطفال،
غير أننا نعيش اليوم في عصر التدوين ، أي أننا حين ندون الحادثة لحظة وقوعها فإننا نلغي
احتمالات أسطورتها، ولذلك لجأ كتاب أميركا اللاتينية إلى الماضي الشفهي من أجل صياغة أساطيرهم الحديثة، غير أن الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو قد قدم اقتراحا آخر هو تحويل النصوص القديمة إلى نصوص أحتمالية، وقام بإدخال النص المدون في الأسطورة الحديثة، وافتراض إيكو، رغم جماليته ، يبقى افتراضاً ذهنياًن ولا يقدم حلاً أدبياً لمسألة الحكاية، الأسطورة.
مع جرجي الراهب المسألة مختلفة.
نحن أمام خبر صغير في صحيفة النص الخبري لا يقول الكثير، يقول فقط إن الرجل قتل بالرصاص . كما أننا أمام حكاية شفهية روتها امرأة كلها من مخيم المية ومية فماذا نختار؟
احترت في الأمر كثيرا. من المؤكد أن جرجي الراهب لم يكن يقوم بخطف يهودي ليلة الجمعة العظيمة. فمسألة خطف رجل يهودي، في الأربعينات، وفي مدينة القدس، كانت مستحيلة، عمليا. غير أن قصته بقيت في الذاكرة الشعبية بسبب هذا الافتراض . أي أن حياة قصة الراهب اللبناني مرتبطة بحدث لم يقم به . إنه مدين بحياته الحكائية للخيال الشعبي. ولذلك فإن حذف هذه الحادثة من القصة من أجل أن لا يتهمني السيد إميل آزاييف باللاسامية، سوف يبدو غير عادل بالنسبة للحكاية، بينما هو سبب ضروري من أجل الحقيقة. هل أحذف الحكاية بأسرها ، وأتخلى عن محاولة كتابتها، أم أكتبها ناقصة؟
ماذا إذن؟
لست أدري. لكن ما أعرفه من خلال لقاءاتي مع أناس كثيرين من أصول مقدسية ، سمح لي بأن أصوغ هذه الصورة عن الراهب .
بعد هرب جرجي الراهب من دير " مار سابا " تحول إلى زعيم عصابة. جمع حوله بعض الفتيان، وأنشأ عصابة الجليل التي كانت تقوم بنهب قوافل المهربين، وتوزيع الغنائم على فقراء الجليل وجنوبي لبنان. وصارت " عصابة الراهب" ، كما كانت تدعى، مرهوبة الجانب من الجميع، إلى درجة أن أحد زعماء المهربين، وكان يدعى أحمد الخواجة، عقد صفقة مع الراهب صار يدفع بموجبها فدية عن كل قافلة ، كي يأمن شرها، كان الراهب وجماعته يحملون السلاح ، ولكنهم لم يستخدموه مرة واحدة. وكان جرجي بثوبه الرهباني الأسود، وبندقيته الإنكليزية، يرى نفسه على صورة السيد المسيح، حاملاً سوطه، ليطرد التجار من الهيكل.
البندقية هي سوط المسيح ، هكذا كان يعتقد الراهب، وذلك لم يطلق النار إلى في الهواء.
بقيت الحال، هكذا أعواماً قليلة، حتى تعرضت العصابة لكمين أقامته إحدى كوبانيات اليهود" هكذا كانت تسمى المستوطنات الهيودية آنذاك ، في منطقة الجليل. كانت العصابة قادمة بسلاحها إلى ضواحي مدينة الناصرة حين انهمر عليها الرصاص، فقتل أربعة من عناصرها الستة ، ولم ينج سوى الراهب ، ومعه شاب أردني من السلط يدعى عيسى، هرب الراهب وعيسى في الأحراش ، واختبأ ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع عاد عيسى إلى السلط، وذهب الراهب إلى القدس حيث استأجر غرفة في " حي النصارى" .
ويوم الخميس العظيم، حمل الراهب صليبا كبيرا ومشى في شوارع القدس وهو يصرخ بأنه يحمل صليب العمر ، ووصل إلى إطراف الحي اليهودي في المدينة، حيث رجم بالحجارة.
وبعد ثلاثة أيام على هذه الحادثة قتل الراهب، وقيل إنه كان مجنونا، وإنه وإنه..
الخيال الشعبي هو الذي أضاف وأنا أقوم بالحذف وهذا غير عادل ولذلك أقول إن الراهب كان، وكأنكما في الحكاية التي روتها لي المرأة في مخيم المية ومية.
لا اذكر إذ كنت قد أخبرت إميل آزاييف شيئا من هذا. كنت مشغولا بحكاية حب تترنح في نهايتها . هكذا الحب، يترنح قبل أن ينتهي. يوحي بأنه يبدأ حين يكون قد بدء بالاختفاء داخل تلافيف الذاكرة ما هذه الذاكرة التي تجعلنا نعتقد أن الحب عز حين يكون قد انزلق إلى نهايته التي تشبه الذكريات.
لكن الحكاية قد تتخذ شكلا آخر.
فأنا ذهبت إلى مخيم شاتيلا. كان ذلك يوم الاثنين 14 آذار 1987 كان اليوم الأول الذي فك فيه الحصار عن المخيم، بعد ثلاثة سنوات طويلة، وصلنا إلى الحاجز السوري الذي وضع بين المخيم وبين محاربين من حركة " أمل " وبعد أسئلة كثيرة وتفتيش وإلى آخره سمحوا لنا بمتابعة طريقنا إلى داخل المخيم.
كنت ذاهبا لزيارة عبر علي.
كان علي أبو طوق صديقي. سنوات الحرب الأهلية قضيناها معا، في الخنادق والبرد والموت وتحت مطر القذائف. ثم افترقت خطانا، على تحول إلى فدائي في كتيبة ( الجرمق) وأنا صرت ما أنا وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ، غاب على في السفن اليونانية التي نقلت الفدائيين إلى منافيهم الجديد عام 1984 ، بعد انتفاضة 6 شباط ، وانسحاب المارينز الأميركيين، عاد على إلى بيروت، بلحيته القصيرة، وعصاه، ليتحول إلى القائد العسكري لمخيم شاتيلا ، عاد ليصير رجل الحصار، ثلاث سنوات من الحصار والدمار، والمخيم يضيق ببيوته المدمرة، حتى تحول إلى كمشة من البيوت التي يسند دمار واحدها دمار الآخر.
ومات علي.
سمعت الخبر في الراديو.
وفي صباح 14 آذار 1987 ، وهو اليوم الأول الذي فك فيه الحصار عن المخيم، ذهبت إلى هناك. كنت أعلم أن عليا يحب امرأة اسمها سامية ( وهذا بالطبع ليس اسمها الحقيقي ، ولكني أغير أسماء النساء حين أراهن في الحب، لأنني أعتقد أن الحب يغير كل شيء في المرأة حتى اسمها) .
دخلت المخيم وسألت عن مكتب حركة " فتح " كانت طرقات المخيم تضيق وتضيق، ثم تحولت إلى ركام. اختفت الطرق ، الركام هو الطريق، والمياه الآسنة تفرش الأرض برائحة ذلك الموت الذي يتسلل إلى المفاصل. كان الأفق ينحدر إلى البيوت المهدمة، ويدخل في شبابيكها. لم يكن هناك أفق. في شاتيلا اختفت السماء داخل الحطام، وتحول الماء إلى برك داخل الثقوب في الحيطان التي سقطت على الأرض.
كنت أمشي كمن يمشي ، وأتهدا بلحيطان وأنزلق وأمشي. دخلت زقاقا إنه الزقاق الوحيد الذي ما يزال قائما وسط هذا الدمار، وسألت عنها . قادوني إلى مكتب " فتح " ، صعدت الدرجات الأسمنتية الثلاث، ودخلت غرفة شبه معتمة، ورأيت شبانا وفتيان باللباس العسكري يجلسون على الأرائك والكراسي وكأنهم يسترخون بعد توتر طويل. ثم جاءت امرأة بصينية القهوة. البخار يتصاعد والرائحة . قهوة طازجة تفتح القلب. أمسكت فنجان الشفة بين الاثنتين، كان برد آذار يحول بخار الفنجان إلى دوائر بيض في سماء الغرفة. أمسكت الفنجان، وشربت.
ودخلت.
تقدمت مني، احتضنتني وقبلتني على وجنتي كان شعرها الأسود طويلا ومبلولا ويتهدل فوق كتفيها. كانت تلبس سترة صوفية بيضاء، ورائحة العطر الصابوني تغلفها.
" أنت فيصل" قالت.
لست أدري لماذا ناديتني فيصل، فهي تعرف اسمي،
أمسكتني من يدي وخرجنا. لم أسأل إلى أين، فأنا كنت مدهوشاً برائحة سامية الخارجة من الحمام. والصابون يعطرها، وأناقة الدمار مثل هالات حولها.
أمسكتني من يدي، وأخذتني في رحلة بين الأزقة .
سألتني إذا كنت أريد أن أزور قبره.
مشينا باتجاه القبر، لم يكن قبرا. وقفنا أمام نافذة الجامع المهدم.
" كلهم هنا " أشارت إلى أرض الجامع، كلهم ، علي وفيصل والجميع".
كانت أرض الجامع مغطاة بأزهار وأعشاب برية ، وسامية إلى جانبي، وشيء يشبه الحزن. أمسكتني من يدي، التفت صوبها ، كنت أريد أن أقول لها إنني أحبها، التفت واحتضنها ، رأسي أنزلق على كتفها وشممت رائحة السترة الصوفية البيضاء ، كانت رائحة خروف طلع من الشمس.
" هذا هو الجامع " قالت، لقد حولناه إلى مقبرة
" أين الشواهد" سألت.
" لا شواهد، قالت، كلهم هنا ، على وفيصل وأنا وأنت، ألم تأت لزيارتهم؟".
وقفت أمام الجامع الذي تحول إلى مقبرة ، وأمام المقبرة التي لا تشبه الجامع، وكانت يدها في يدي أحسست بيدها طرية وتكاد تنزلق. التفت إليها. عيناها كانتا مفتوحتين ، ولا دموع.
شدتني من يدي كي نتابع جولتنا. لست أدري كيف أصبحنا متواجهين من جديد، ضممتها إلى صدري، وكنت أعلم أنني لا أستطيع أن أبوح لها بحبي.
"إن يوسف
لما شاهد الشمس قد أخفت أشعتها.
وحجاب الهيكل انشق لموت المخلص.
دنا من بيلاطس ، وتضرع إليه قائلا:
أعطني هذا الغريب،
الذي منذ طفولته تغر كغريب،
أعطني هذا الغريب،
الذي أماتوه بغصنا كغريب،
أعطني هذا الغريب،
الذي أستغربه ضيفا على الموت،
أعطني هذا الغريب،
الذي غربه اليهود من العالم حسداً،
أعطني هذا الغريب،
لكي أواريه في لحد،
أعطني هذا الغريب،
فإنه غريب،
لا مكان له يسند إليه رأسه،
أعطني هذا الغريب،
الذي رأته أمه ميتاً
فصرخت يا بني وإلهي،
أعطني هذا الغريب،
بهذه الأقوال، توسل يوسف النقي إلى بيلاطس،
وأخذ جسد المخلص،
ولفه بأكفان وطيوب،
ووضعه في قبر."
بعد سقوط المخيم. رحلت سامية إلى صيدا، ولم ألتق بها بعد ذلك.
أنا الذي رأيت،
أشهد وأقول واصرخ
إن الواقف على شاطئ البحر الميت، حيث المرايا والوجوه النحاسية والأرض التي تنفصل عن الأرض.
قلت لمريم إنني أريد أن أخبرها . أخبرتها عن سامية التي رحلت، وعن هذا العمر الذي نلبسه ككفن.
هل هي مريم ، الجالسة على أطراف غور الأردن، تنتظر الغريب الذي يقتله الغريب؟ أم هي الحكاية؟
هل هذه الأرض التي اسمها فلسطين هي مجرد حكاية تسحرنا بأسرارها وطلاسمها؟
ولماذا حين نستمع إلى هذه الحكاية لا ننام. بل نموت؟



 جديد مواضيع قسم الارشيف
جديد مواضيع قسم الارشيف




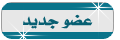








 العرض العادي
العرض العادي



