كاتب الموضوع :
Green Tea
المنتدى :
القصص المكتمله

6
خرجت لينا أخيرا ً، بعد اتصالين ودقائق انتظار، لم يكن مسموحا ً لي فيها استعمال جرس المنزل أو منبه السيارة حتى لا أوقظ والدها العجوز.
وضعت الأواني - التي عادت بها فارغة بعدما كانت متخمة في الصباح - في المقعد الخلفي، ثم ركبت:
- كيف كان يومك ِ؟ - بعدما تجاوزت الشارع المغبر، ورددت على سلامها -.
- آه... ممل، مع كل هؤلاء الأطفال، وكل هذه الضوضاء، وأكداس الأعمال المنزلية التي لم تنجز ووجدتها تنتظرني، أوف... كنت أنتظر اللحظة التي أغادر فيها المنزل.
- وكيف حال أمك؟ - بابتسامة مخبئة -.
- بخير... وتحملني سلاما ً لك.
- سلمك ِ الله وإياها.
- جاءت أختك ِ؟
- نعم... وجاءت ابنة عمي تهاني، بطنها بارز قليلا ً أظنها حامل.
- ألم تسأليها؟
- لا... لن تخبرني، هي من النوع المتكتم جدا ً.
- اها.
* * *
(( وكان ابن دهيش قد نزل البطين، الماء المعروف بالريلية برجال معه، فلما جاء الخبر إلى صالح بن علي، جمع أخوانه وأبناء عمه وخرج إليهم، فحصل بينهم قتال شديد، وقتل فيه ابن دهيش، رماه سليمان بن يحيى، فولوا منهزمين وأخذ سلاحهم وخيولهم))
من أخبار الجد ( صالح بن علي) التي وردت في مخطوط ( عبد الرحمن بن عثمان)
* * *
حللت الرباط عن ملفي إياه بسرعة كادت تنزعه من مكانه، ونثرت أوراقه المتزاحمة على سطح مكتبي فيما عدا خطة العمل التي أبقيتها في يدي، وتأملتها برضا وحنان قبل أن أمزقها إلى قطع صغيرة.
كانت قد استوفت أهدافها أخيرا ً، وصارت تلك الخطة التي بدأت صغيرة وبثلاثة أسطر، غابة من المراحل والسطور المتداخلة والمتفرعة، التي مضيت فيها رغم كل شيء.
والآن وأنا أتأمل الكومة غير المنتظمة من المزق، أستعيد كيف كانت يوما ً ما أهم ورقة في هذا الملف، وكيف توالدت منها كل هذه الأوراق التي تضم نظرية شبه مكتملة للكتابة التاريخية، اضطررت لبنائها ليأتي هذا الكتاب كما أريده أن يكون – كنت قد فكرت أن لا أدع هذا الجهد يتبدد، وذلك بأن أصدر الكتاب بشرح مفصل للنظرية، ولكني تراجعت عن هذا بسرعة، فغير ما قد يوحى هذا به من تعالي وذاتية شديدة في كتاب يفترض به أن يخصص للجد، ستلتهم هذه النظرية ثلث صفحات الكتاب، وستزيد من حجمه، وستمنح بعض الألسن مساحة للغو لا أريدها -، كما تضم أوراقي بضع ملاحظات هامة ومركزة عن الحالة السياسية والاجتماعية والفكرية لذلك العصر – الذي لم تكن القراءة عنه، بكل تلك التفاصيل التي تعج بالمعارك، والدسائس، والأوبئة، سهلة ميسرة -، وأخيرا ً أوراق يغلب بياضها سوادها عن الجد، ما أعرفه عنه حتى الآن سماعا ً، أو قراءة من هنا أو هناك، وهذه الأوراق هي ما سيتصدر الآن الملف، وسيكون جهدي في الأيام القادمة ملئها وتخطيطها بمحطات حياة الجد الأساسية، صفاته، أفعاله، أقواله، قصائده.
في هذه اللحظة ستبدأ رحلتي التي أعددت لها جيدا ً لاكتشاف الجد، سأكون بنظرياتي وأوراقي المخربشة أول ابن من أبنائه يقترب منه إلى هذا الحد منذ تلك الليلة التي خط فيها ( عبد الرحمن بن عثمان) العبارة الختامية لكتابه ( تم بحول الله وقوته في ثلاث ليال بقين من شوال في عام خمس عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة)، واتكئ براحة إلى الجدار الطيني لبيته في الريلية.
تنهدت بعمق عندما تخيلت هذا الاقتراب، وجمعت في يدي أجزاء الورقة الممزقة ورميتها في سلة المهملات، كان هذا يشير إلى عادة أفلحت في التخلص منها مؤخرا ً، عندما فاضت الملفات عندي بأكداس الأوراق التي انتهت حاجتي لها ولكني مازلت أحتفظ بها، ربما لأنه كان لدي وهم أو حلم غريب بأن هناك من سيقلب أوراقي يوما ً ما بعدما أموت، ربما ابن، ابنة، حفيد، أو حتى إنسان غريب لا يعرفني، ولكنه سيعرفني حتما ً بين كل هذه الأوراق، كنت أتخيله بملامح غائمة، وهو يقلب الأوراق المجعدة أو المصفرة، يتتبع الخطوط، يدون ملاحظاته هنا وهناك، يتساءل عني، بم َ كنت أفكر عندما كتبت هذه الورقة أو تلك؟ يضع نظريات يحاول أن يفسر بها ما خفي من سلوكي، وما يختفي وراء حروفي، ولكني تخليت عن هذا الحلم ذات ليلة، وفي الضوء الخافت المتسلل من الرواق، مررت على كل الأوراق الغافية بوداعة وانتزعتها من رقدتها لأكومها بلا تردد في سلة المهملات، عددها الكبير منعني من تمزيقها بقبضتين متقاطعتين، وبدا لي تمزيقها على مجموعات بلا أي إثارة، فاكتفيت بحشرها في السلة الصغيرة، في الصباح بدت لي الملفات التي فقدت انتفاخها إثر هجمة المساء كئيبة الملامح، بل إن بعضها بدت غير معتادة على كل تلك الرشاقة التي جاءت بلا انتظار، فلذا حافظت على انتفاخها الكاذب، ولكن هذا كله لم يجعلني أتراجع عن قراري، فمضت تلك الأوراق إلى مصيرها البائس.
قلبت أوراق الجد – سيكون هذا اسمها من اليوم، أي ورقة تنتظم شيئا ً من سيرته، ستسمى باسمه – وأنا أضع هنا أو هناك ملاحظات عن الكيفية التي سأتعامل فيها مع النصوص التي ستدور منذ اليوم حوله، كيف سأتأكد منها؟ - ففي النهاية لا أرغب بأن يأتي كتابي كمجموعة متنافرة من الأخبار والروايات غير المحققة -، كيف سأرتبها؟ وكيف سأكون من هذا كله مزيجا ً متماسكا ً يصلح كسيرة افتراضية للجد – بما أني سأفترض الكثير لسد الثغرات هنا وهناك -.
* * *
كان لا يزال واقفا ً وسط الجسر، يتأمل بذراعين معقودتين الماء المدوم في النهر.
- مساء الخير – وأنا أقترب -.
- مساء النور، مع أن ضياء الشمس هنا يقول لي أن بيننا وبين المساء أمدا ً بعيدا ً.
- ههههههههههههه، أوه... لا تؤاخذني، أنا أعمل بتوقيتي أنا، وهو مسائي باقتدار.
حط صمت ثقيل بيننا، شتته هو عندما تحرك مبتعدا ً:
- هل فكرت بالموضوع؟
- آ... لا... للأسف، كان يوما ً طويلا ً، لم أحظ فيه بصفاء ذهن يكفي.
- اممممممم.
- اسمع... أنا وعدتك بالتفكير في الموضوع بعمق، فلذا لا تتعجل جوابي، لأنه إن جاء سريعا ً فلن يجيء كما تشتهي.
- أنا فقط أستغرب هذا التردد، ما الذي تخشاه بالضبط؟
- لا شيء محدد، ومن هنا تبدأ المشكلة، أنا لم أصل حتى الآن لفهم وتصور لوضعنا معا ً، هنا، فكيف إذا صرت ترافقني طوال اليوم من لحظته الأولى وحتى نهايته التي لا أدري متى تأتي !!!
- وما الذي تخشاه من مرافقتي لك طوال اليوم؟ ففي النهاية أنا لست إلا جزء ً منك.
- صحيح، ولكنك جزء مخبئ، ومخبئ جيدا ً، حتى أنك انتظرت كل هذه السنوات لتفاجئني وتبرز لي من بين السطور، أنا لا أدري من أنت بالضبط؟ لا أدري أي ( أنا) أنت !!! هل هي ( أنا) أحبها؟ أم ( أنا) أخشاها وأتركها فقط تتسلل بين السطور حتى لا تموت أو تشيخ، فلذا أحتاج إلى أن أفكر، وأن أفكر جيدا ً، عندما أقرر بأن هذه الـ ( أنا) ستكون رفيقتي طيلة اليوم.
- هل يبدو لك هذا مخبئ ً !!! – وهو يفتح يديه باتساعهما -، لقد اختلقت لي جبلا ً وغابة ونهرا ً ووقتا ً نلتقي به، أنا لم أعد مخبئ ً يا صاحبي، أنا موجود، وأنت لا تفعل في يومك شيئا ً سوى إدارة وجهك بعيدا ً عني وتجاهلي، وما أطلبه منك الآن، أن تتوقف عن هذا، وأن تتقبل وجودي.
سكت قليلا ً، ثم أكمل بلهجة أخف:
- اسمع... أنا أعرف أنني لم أكن ومنذ البداية إلا إزعاجا ً وهما ً متواصلا ً لك، وأنك ربما تفكر الآن بهل أخرجه من هنا ليسمم بقية يومي، ولكني أؤكد لك الآن بأنني لست بهذا المزاج النكد دوما ً، وأنني سأكون أفضل بكثير حالما أتخلص من هذا السجن الورقي، وأعيش معك يومك، أحاورك، أفكر معك، ومن يدري ربما أمازحك في الأوقات التي تحتاج فيها إلى الضحك، صدقني يمكن للحديث معي أن يكون ممتعا ً.
- حسنا ً... أعدك بأني سأفكر بهذا جيدا ً الليلة، وسأعود لك بجواب أكيد في المرة القادمة، والآن لنتحدث في أمر آخر، دعني أختبر هذا الحديث الممتع الذي تدعيه.
- حسنا ً... اختر ما شئت – ولوح بيديه بعدم رضا واضح -.
كنا قد وصلنا نهاية الجسر من الجهة الأخرى، وبدا أنه يفكر بالعودة، ولكني استمررت في اتجاهي ونزلت عن الجسر الخشبي إلى الأرض الترابية، حيث كان درب ممتد يخترق الغابة بالتفافة ساحرة – المكان جميل جدا ً، رغم انتقاداته في المرة الماضية -.
- طبيعة بكر... ها !!! كما يقول الكتاب عادة – قال بعدما عبرت إليه فكرتي عن جمال المكان -.
- نعم.
- ههههههههههههه، هذا يدل على أنهم هم فاشلون أيضا ً في الطبيعة، فالطبيعة البكر التي يتغنون بها ترفضهم، كل ما فيها يرفضهم، حشراتها، هوامها، أغصانها النافرة والمليئة بالشوك، حيواناتها التي لم يخضعها الإنسان، ما يستمتعون به عادة، طبيعة مشذبة، طبيعة تم إخضاعها بالمبيدات، بالتنسيق، وبالسياج الذي يبقي كل شيء بعيدا ً، فلذا ( الطبيعة البكر) ليست إلا تعبير مثير، ولا يمكن ملامستها حقا ً إلا بالتخلي عن قرون من المعرفة، ومن الهشاشة.
- هههههههههههههههه.
- ما الذي يضحكك؟
- تبدو لي بحماسك هذا كخطيب جمعة، هههههههههههههه، أتدري؟ ربما كان هذا هو الدور الذي كنت سأعطيك إياه في قصتي التي أفسدتها بثورتك.
- أنت من يجعلني كذلك، بعباراتك المنتقاة، تحدث... ثرثر قليلا ً، لا يمكن للحديث أن يكون ممتعا ً إذا جاء موزونا ً.
- أنا لا أنتقي عباراتي، اممممممممممم، أو لأقل - حتى أكون دقيقا ً - بأني توقفت عن الشعور بذلك، مر زمن طويل منذ كنت أتحدث على سجيتي، منذ كنت أتكلم بلا مسودة في روحي، فتأتي الكلمات طرية، سهلة التشكيل.
- وما الذي تغير؟
- صرت أعرف أكثر، فصار علي أن أسكت أكثر، هل تعرف ما الفارق بين الصمت والسكوت؟ تصمت عندما لا تجد ما تقوله، ولكنك تسكت عندما لا تحب ما يجب أن تقوله.
عادت لحظات الصمت الثقيلة، عندما انشغل فهد بملامسة أوراق عريضة لشجرة عتيقة تكاد تعترض الدرب، وتمنحه انحناءة جميلة:
- هل تعرف ما نوعها؟ – وهو يشير للشجرة برأسه –.
- لا.
- هذه من الأشياء التي تنبهت إلى جهلي بها مؤخرا ً عندما بدأت بكتابة القصص – أكملت عندما عاد لصمته -، وهو مشروع أشكر لك إفساده علي – ابتسم وأفلت الورقة -، يمكنني الحديث عن الكثير من الأفكار والأشياء، ولكن عندما يأتي دور الوصف، أجدني عاجز عن تحديد نوع الأشجار التي تزين طريقا ً شق في حكايتي، أو الأخشاب التي صنع منها مكتب اختلقته، أو الألحان التي يرددها بطلي وهو يسير إلى نهايته، تلك التفاصيل التي تجدها بيسر في مؤلفات الآخرين، فالبطل يمشي في ظلال أشجار الأكاسيا، ويكتب على مكتب من خشب الماهوجني، والبطلة تستمع إلى ياني أو تومي لي، حسنا ً... ماذا عن بطلي أنا؟ أي شجرة ستظله؟ إن اعتمدت على معارفي فلن يحظى إلا بنخل أو أثل، فكرت بأن هذا نقص لابد من تداركه، فبدأت في تجميع أسماء الأشجار، الورود، الأخشاب، المشروبات، المأكولات، فمن المعيب أن يذهب بطلي إلى مطعم ويطلب أوصال لحم أو بيتزا، لابد أن يطلب باستا، أو فيليه، حتى جاء اليوم الذي توقفت فيه، كانت القوائم التي ربت بين يدي مجرد أسماء لأشياء خارج حواسي، أشياء لم أجربها، لم أذقها، لم أستظل يوما ً بشجرة أكاسيا، ولا أدري كيف سيكون ذاك الشعور، لم أذق البلودي ميري، ولم أتناول البيوريه، فلذا عندما أكتب عن هذه الأشياء وأضعها في حكاياتي، هل كنت فقط أستجيب للرغبة بالظهور بمظهر العارف لما يعرفه الآخرون؟ أرعبتني طفولية الفكرة، ثم جرتني إلى سؤال خبيث، هل جرب الكتاب كل ما هو موجود في كتبهم؟ بدا لي هذا مروعا ً، كل الأشياء التي تحدثوا عنها، كل الأشياء التي أوهمونا بأنهم عايشوها، هل هي مجرد خدعة جماعية تواطؤا عليها؟ وهذا لا يشمل فقط أسماء لأشياء أو توصيف لتجارب، وإنما يمكن أن ندرج فيه أيضا ً، أفكارا ً أساسية ومهمة في الحياة، صار هناك تساؤل كبير يؤرقني، الأدب، القصة، الرواية، القصيدة، كلها مبنية على الاختلاق الفني والأدبي، هذا جزء كبير من فتنتها وجمالها، ولكن ما حجم هذا الاختلاق؟!! أين يبدأ؟ أين ينتهي؟ هل يحق للكاتب اختلاق مشاعر لم يعشها حقيقة، كالحب، الألم، الحزن، لنتفق هنا أولا ً... نعم، جزء من عظمة الكاتب أو الشاعر قدرته على الاختلاق، فلذا من حق الأديب أو المبدع أن يختلق أشياء غير حقيقية أو غير موجودة، وأن يوظفها لصالحه، ولصالح فنه، فالأدب ليس علما ً، بالمعنى الحديث لكلمة علم، إذن أين المشكلة؟ المشكلة بنا نحن، عندما لا ندرك هذا، وعندما نسمح لقصة أو قصيدة بأن تشكل حياتنا وقناعاتنا حول الأشياء من حولنا، تلك السهولة التي نتلقف فيها بيتا ً أو مثلا ً ونصيره شعارا ً لنا في الحياة، من دون أن ندرك أن الأدب لا يفترض به أن يمنحنا الأجوبة عن الحياة، بقدر ما يستثير فينا الأسئلة عنها، عندما يقول أبو تمام مثلا ً ( نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول ِ)، يمكننا أن نتذوق كل الأفكار والمشاعر التي يستثيرها بيت رائع كهذا عن الحب، وعن المشاعر الأولى التي لا تزول، ولكننا سنكون مخطئين تماما ً إن تركنا هذا البيت يستولي علينا، ويمنعنا من الحب من جديد، يمنعنا من التساؤل ما الذي يجعل الحب الأول حبا ً غير منسي؟ هل هي الذكريات؟ هل هو الحنين للماضي؟ من هنا يمكننا أن نجد الطريق الذي يجعلنا نشعر بلحظتنا الحالية، ونتخلص من إسار مشاعرنا القديمة، لنبدأ مشاعر جديدة.
- أظن أني ابتعدت عن الفكرة الأساسية – أكملت بعد صمت لحظات -، وهي أنني قررت أن لا أكتب إلا انطلاقا ً من تجاربي أنا، ومعارفي أنا، وهذا يجعل من أبطالي يأكلون مما آكل، ويشربون مما أشرب، ويزورون المدن التي أزورها، وقد سمعت أن أحد الأدباء كتب رواية كاملة، تدور أحداثها في مدينة لم يزرها في حياته، بل إن هناك من الأدباء من يختلقون مدنا ً غير موجودة، يرسمون طرقها وميادينها في خيالهم، ولا يمكن لأحد لومهم، فما يكتبونه رواية، وليس كتابا ً علميا ً، تخضع الحقائق فيه للتمحيص والتدقيق، لم َ إذن اتخذت هذا القرار؟ لأني أرغب بأن أودع نفسي كما هي بين السطور، لا أريد زخرفتها، لا أرغب بتلميعها، أهم قارئ لي هو أنا، ولا أريد أن أفقد اهتمام واحترام هذا القارئ الثمين، أريد أن استمتع بالكتابة، ومن ثم أن استمتع بقراءة ما كتبته من حين إلى حين، وعندما أقرأ أشياء في نصي لا أعرفها، ولم أجربها، أعرف بأن خطرة ساخرة ستمر في كياني، هذه الخطرة هي ما أفر منه، فهي ليست ما يقوم به بعض الكتاب من السخرية من أنفسهم، لا... تلك سخرية ظاهرية، مملوءة بتبجيل داخلي، أنا أخشى السخرية التي لا تبجلني، السخرية التي تقول لي فيها نفسي، ما هذه السخافة التي كتبت؟ يمكنك أن تخدع ألف قارئ، ولكنك لن تخدعني، أذكر أني كتبت ذات يوم – تحت التأثير المباشر لفيلم ( العراب) - قصة قصيرة، عن عائلة سعودية ضخمة، ممتدة، بأب كهل حرصت على أن أحشد له كل تلك القوة والإثارة التي أحاطت بشخصية فيتو كارليون، عندما انتصفت القصة، شعرت بسخافة ما أقوم به، ظهور شخصية بكل تلك المميزات تستدعي ظروفا ً معينة، لم أستطع توفيرها في حكايتي، كان علي حتى أحصل على قوة كبيرة تعمل بقوانينها الخاصة أن أعود بالزمن قرنا ً، وأن أختار للكهل قبيلة أو عشيرة يقودها، ولكن هذا سيفقدني أناقة الشخصية والعصر، لذا ودعت عندها بطلي، وتركته هائما ً في خيالي، نصف حكاية منسية بين أوراقي، كما ترى مصيرك خير من مصيره، وربما... في يوم ما، أتنازل عن نصف مواصفاتي، واستكمل حكايته كما يمكن أن تكون، لا كما أشتهيها أن تكون.
|












 جديد مواضيع قسم القصص المكتمله
جديد مواضيع قسم القصص المكتمله




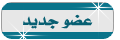








 العرض العادي
العرض العادي



