كاتب الموضوع :
الحكاء
المنتدى :
المنتدى العام للقصص والروايات
 الفصل الأول
الفصل الأول
( 1 )
فريد
جولة جديدة في الصراع بين القدر والصدفة
يقولون أن الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب. ولكني في الواقع أراها غير ذلك. إنها المتاعب بعينها. هذه حقيقة لا يدركها إلا شخص يجري وراء الخبر وهو يشعر بأن الخبر يجري أمامه وبنفس السرعة تقريباً. والغريب أن البعض يظن بأن الواجهة الاجتماعية والمكانة المرموقة التي قد يحصل عليها الصحفي كافية لتعوضه عن مشاق المهنة وآلامها وهو ظن مغلوط تماماً خاصة إذا كنت مثلي مجرد صحفي مغمور بقسم الحوادث في جريدة لا يكاد يقبل على شراءها إلا أفراد أسرتك وربما القليل جداً من أصدقاءك المقربين لا لشيء إلا للتباهي بأنهم يمتون بصلة لصاحب هذا الاسم ذو الحروف الباهتة الصغيرة الذي يحتل ركن بعيد في صفحة ما من جريدة (الكلمة).
كانت ( نيفين ) واحدة من بين هؤلاء القليلين ذوي النزعة النرجسية الذين أعرفهم. لعل أروع ما في هذه الفتاة الخمرية ذات الوجه المستدير هو خيالها الخصب , ولو أن الخيال وحده يكفي لأهلها ذلك لأن تكون أديبة ذات شأن. كانت شديدة الإيمان بي , تثق في قدراتي وتشجعني على المضي قدماً وتقسم لصديقاتها أن خطيبها – هذا الذي يتحدث إليكم الآن – سيصبح ذات يوم قريب صحفيا لامعاً تتخطى شهرته حدود البلاد.
" إنك أسلوبك الرائع يذكرني بأدباء العصر الكلاسيكي. "
“ ولكني افتقد لخيالك الواسع. ”
“ حسنٌ. دعني ألقي أمامك بنتوف خيالي المبعثرة وأتركها لك لتنظمها بهذا الأسلوب البديع في قالب روائي. يالها من فكرة. سنكون ثنائياً مبهراً وسنحظى بشهرة واسعة. هل تعتقد أننا سنكون في شهرة عائلة برونتي ؟ ”
" وربما على نفس الدرجة من بؤسها. ”
“ لست أمزح يا ( فريد ). إنك تحتاج إلى القليل من الوقت والثقة بالنفس لتصبح من رواد الصحافة والأدب في مصر. ”
أحياناً كانت تأخذني نوبة من الضحك لا يمكنني تجنبها , وأحياناً أخرى كانت كلماتها هذه وإيمانها العميق بقدراتي المحدودة يمثل مناخاً مناسباً لعدوى الغرور. في الواقع كان خيالها الخصب الذي أفتقد لمثله هو ما يتملكني إلى حد الأسر. كان لدى كل منا ما يفتقده الآخر وكأننا وجهي عملة متكاملين ومتلاصقين على المستوى الروحي.
كنا قد اتفقنا على أن نلتقي في السابعة مساءاً على شاطئ البحر في ميامي. هناك بالقرب من منطقة بئر مسعود أول شاهد على ميلاد حبنا في الشتاء الماضي , أي منذ عام تقريباً. ومع لهفتي وتحرقي شوقاً لأن أراها , إلا أنني على غير عادتي غرقت في خضم العمل على نحو قذفني خارج حدود الزمان والمكان. هذا لا يعني أنني على قدر من الأهمية والمسئولية في العمل , فكما أخبرتكم سابقاً لست إلا صحفي مغمور في صحيفة أشد غمرة , ولكنها تلك الحادثة الغريبة التي كنت أعكف على تحريرها هي من ابتلعتني حتى تلاشيت تماما في ضبابها الكثيف الغامض.
كانت حادثة غريبة بحق وغامضة على نحو مقلق.
في البداية ظننت أنها جريمة قتل عادية في أحد الشوارع الراقية بحي سان استيفانو. مجرد جريمة كتلك الجرائم التي اعتدت على تحريرها لا أكثر ولا أقل. على الأرجح سيكون الدافع خلف جريمة القتل هذه هو السرقة. ربما سارت على هذا النحو . شاب في مقتبل العمر يائس ومحبط , افقدته سرعة العصر القدرة على ملاحقة أحلامه الجامحة فقرر أن يختصر الطريق إليها فوق جثة أحد الأثرياء. غالباً ما سيكون هذا الشاب عامل بسيط اعتاد التردد على منزل ضحيته لإصلاح عطل عادة ما يكون في نظام المنزل الكهربائي أو في شبكة صرفه. لا يهم , المهم أن الفرصة كانت مواتية لكي يدرس بهدوء وعناية خارطة المنزل ليعرف كيف ومتى يتسلل إليه دون أن يثير أدنى ريبة أو انتباه. لعله ايضاً أنفق الليالي الطويلة في دراسة الموقف بأكمله قبل أن يتغلب على خوفه ويضع خطته النهائية موضع التنفيذ. ثم إنه لم ينسى أن يراقب بدقة شديدة سلوك ضحيته وعاداته فهو أمر مهم لنجاح جريمة قتل ولإثبات مدى ذكاء القاتل.
كان هذا السيناريو هو أقصى ما استطاع أن يحبكه خيالي أثناء انتقالي في الصباح إلى مكان الحادث بصحبة ( حنفي ) زميلي المصور. بدت لي هذه الحبكة منطقية وأقرب إلى الواقع بحكم خبرتي الطويلة بقسم الحوادث , ومع هذا فقد حرصت على أن أبقيه ضمن حدود عقلي فلو أطلع عليه ( حنفي ) لأفقده الضحك السيطرة على نفسه. إنها حبكة درامية رخيصة استهلكتها أفلام السينما كما يستهلك البخيل منديلاً ورقياً , ثم إن حنفي من ذلك النوع من الرجال الذي دائماً ما يحرص مع أقل بادرة على أن يكشف عن أسنانه المتآكلة وصوت ضحكاته الذي لا يختلف في شيء عن اضطراب أمعائه. حتماً كان ( حنفي ) سيسخر بشدة من هذا السيناريو الهزيل على عكس (نيفين) التي أجزم بأنها لو سمعته لأضافت إليه الكثير من الأحداث التي ستزيده تعقيداً وغموضاً بنفس السهولة التي تضيف بها التوابل إلى الطعام , ثم لصفقت بيديها فرحاً وهي تصيح بأنها على وشك الزواج من ديستويفسكي.
راح حنفي يلتقط الصور بحرفيته المعهودة بينما انهمكت في إجراء حوارات طويلة ومرهقة مع بعض رجال الشرطة المتحفظين والقليل من الجيران الأكثر تحفظاً. كان مسرح الجريمة فيلا صغيرة في بقعة هادئة لا تبعد كثيراً عن البحر , وكما توقعت تقريباً كان صاحبها عجوز تتغذى الوحدة والمرض على ما تبقى من سنوات عمره الذي تجاوز الستين. إلى هنا وانتهت علاقة الواقع بالخيال. انهار السيناريو الذي انفقت ساعة كاملة في تخيله كبناية من الورق المقوى في مهب العاصفة. صحيح أن الثري العجوز كان هو الضحية إلا أن الجريمة لم تكن بدافع السرقة. لم يكن هناك أثر للشاب المحطم ذو الأحلام الجامحة , بل لم يكن هناك أثر للقاتل على الإطلاق. لا بصمات ولا خلايا جلدية للقاتل تحت أظافر القتيل جراء المقاومة. كان العجوز الراحل مسجى على فراشه الوثير بدعة وسلام , ولولا تلك الطعنة النافذة في قلبه لظنه الرائي يغط في نوم هادئ وعميق. كان كل شيء في مكانه دون أن يتحرك قيد أنملة تماماً كما وضعه العجوز الراحل بنفسه قبل موته. كان النظام يعم الفيلا على نحو ينم عن نظافة وروتين يدعو للملل. لا أدراج محطمة ولا مقاعد مبعثرة رأساً على عقب ولا أثر لأدنى درجات الفوضى. كانت النوافذ مغلقة والستائر المخملية الثقيلة مسدلة بعناية من يعرف جيداً ليل الشتاء بالقرب من البحر. كان الأمر محيراً بحق وما زاده حيرة وغموضاً أن باب الفيلا كان مغلقاً من الداخل فكيف اقتحم القاتل المكان إن كان باب الفيلا ونوافذها مقفلة على هذا النحو المحكم.
حملت إلى مكتبي كل ما استطعت أن اجمعه من معلومات وما استطاع (حنفي) أن يلتقطه من صور. نثرتها أمامي بلا ترتيب فقد استحوذت هذه الجريمة العجيبة على عقلي. رحت أتأمل الصور واحدة تلو الأخرى. بعضها كان للفيلا من الخارج وبعضها كان للبهو الواسع الممتلئ بالتحف الثمينة. أكثر ما لفت نظري هو مجسم صغير لعازف كمان من الذهب الخالص يحتل رفاً بارزاً من تلك المكتبة الكبيرة في ركن البهو.
لو أن السرقة كانت دافع القاتل فكيف غفل عن هذه القطعة الذهبية التي قد يتجاوز ثمنها مئات الآلاف ؟!.
ولو كان ما يقف خلفها هو الغضب والرغبة في الثأر فكيف تسلل القاتل إلى الفيلا ؟
كيف بلغت به الدقة في التنفيذ حد ألا يترك أي أثر خلفه ؟ أين بحق الله ذهبت بصماته ؟!
أين عظماء الأدب البوليسي ورجال التحقيقات الجنائية الذين صدعوا رؤوسنا باستحالة الجريمة الكاملة ؟!
ثم...
ثم لماذا تحتل هذه الجريمة بالذات كل هذه المساحة الواسعة من عقلي ؟!
كانت الأسئلة تتوالد في ذهني بأسرع مما تفعل الأرانب البرية , إلا أن هذا السؤال الأخير كان أبرزها على الإطلاق. كمحرر صحفي كان عملي يقتصر على اختيار صورة أو اثنتين أرى أنهما الأفضل من بين تلك اللقطات الكثيرة التي التقطها حنفي , ثم أضمها جنباً إلى جنب مع كل المعلومات التي أُتيحت لي بعد أن أكون قد رتبتها وصغتها بأسلوب صحفي مشوق , ولا مانع من أن أُذيل الموضوع بسؤال حول هوية الجاني. باختصار كانت مهمتي هي طرح الأسئلة وليس الإجابة عنها. أو على الأقل هذا ما كنت أفعله على مدار ست سنوات هي كل تاريخي المهني بقسم الحوادث. هذه المرة كان الأمر يسير على نحو مغاير يشبه المسار الحتمي نحو غاية مجهولة.
“ جولة جديدة في الصراع بين القدر والصدفة. ” همست وأنا أغمض عيني طلباً للاسترخاء.
في لحظة ما اختلط الواقع بالخيال. بخفة وهدوء يسلبان الوعي والإرادة تباعدت جدران الغرفة وراح لونها يتبدل تدريجياً من اللون الرمادي إلى الأخضر الداكن. أختفى الباب الخشبي المتهالك الذي طالما عذب منظره البائس ناظري , كما لم تعد هناك نافذة تطل على الشارع بل درج رخامي مفروش ببساط أحمر ناعم الوبر يبدو وكأنه في رحلة أبدية للأعلى. على يساري كانت مكتبة أنيقة قد شرعت في الظهور من العدم وذلك المجسم الصغير لعازف الكمان قابع على رف بارز منها يبهر بريقه بصري كشمس متوهجة عند الطرف البعيد من الكون. لقد تلاشى الواقع تماماً مع تبدل المشهد بهذه الطريقة السنيمائية البطيئة. تلاشت طاولة مكتبي الصغيرة وتلاشى مقعدي الخشبي المرهق.
" بحق الله ماذا يحدث ؟!. كيف جئت إلى هنا؟! ”
كنت أقف في المنتصف من بهو الفيلا أحملق بذهول في الصور والمعلومات التي راحت تطوف بصمت في الفراغ كأجرام صغيرة. حتى جسدي كانت تعتريه خفة عجيبة رغم ميله للسمنة جعلتني أشعر وكأنني بالون يطفو على سطح الماء.
فركت عيني بقوة “ ثمة شيء خاطئ. لا يمكن أن يكون هذا الذي يحدث لي حقيقي ! ”
اقتربت من المجسم الذهبي لعزف الكمان وحملته في راحتي. كان ناعم وبارد كقطعة ثلج. حقيقياً إلى حد لا يمكن أن يرقى إليه الخيال. انتبهت إلى أن خطواتي لم تكن تحدث أي وقع. دققت الأرض بقوة عدة مرات لأتأكد فشعرت بها لينة وطرية مثل سجادة فارسية غزيرة الوبر. تسلل الخوف إلى قلبي مع هذا الصمت الثقيل الذي كان يضغط بقوة على أذني. مع هذا السكون القبري لا يملك الإنسان إلا أن يرهف السمع. إن أقصر موجة صوتية وأقلها انخفاضاً ستكون بمثابة نعمة من السماء لا تقدر بثمن. ستكون دليل كافي على أنك ما زلت حياً , وستشكل نافذة ضيقة تطل منها على المزيد من الغموض والمجهول. قد يقودك هذا الصوت إلى حتفك ولكن يبقي أي شيء أفضل من لا شيء على الإطلاق.
في أعماق هذا الصمت الأبدي شعرت باهتزاز رقيق في شعيرات أذني مثل توتر طفيف على سطح بحيرة ساكنة. ثمة صوت ما. همس ناعم كوسوسة الأشباح. ربما لم أكن أصغي بالشكل الكافي , علىّ أن أرهف السمع أكثر. شيئاً فشيء بدأ الصوت يتضح. لم يكن وسوسة كما ظننت وإنما شيء آخر. نغمات تنبعث من غرفة ما بالطابق الثاني. قطعة موسيقية ساحرة بالرغم من أنها لم تكن تخلو من بعض الصخب. لعلها من أعمال باخ أو موتسارت , لست على يقين. ولكن هذا التناغم المذهل الذي يأسر الروح لا يدع مجالاً للشك في أنها اخترقت حجباً كثيفة من السنين المتراكمة قبل أن تصلني بهذا الصفاء.
ذكرتني هذه الموسيقى بنيفين. كم افتقد هذه الخبيرة البارعة في الموسيقى الكلاسيكية. لو كانت معي الآن لاندفعت تخبرني باسم هذه القطعة الساحرة ومن مؤلفها ومتى قام بتأليفها وربما استرسلت حول حياة ذلك الموسيقار ولألقت على مسامعي ترجمة كاملة عنه قبل أن أتمكن من إيقافها. حتى مع هذه الفجوة المرعبة في الواقع التي ابتلعتني كنت افتقد هذه الحسناء الثرثارة.
أعدت المجسم الذهبي إلى مكانه واتجهت نحو الدرج الرخامي أقتفى مصدر الموسيقى. لماذا ؟. لا أعلم. لم يكن للفضول دور في قراري هذا وإنما هي واحدة من تلك اللحظات المتكررة في حياتي التي افقد فيها السيطرة على كل شيء وأترك الحرية للغريزة تقودوني إلى حيث يجب أن أكون. في موقف كهذا يصبح الخوف هو المسيطر وتصبح الكلمة الوحيدة للغريزة في مواجهة هذا الخوف.
رفعت بصري اتطلع للدرج. كان كنهر صغير ينبع من فراغ أسود ليصب عند قدمي. ارتفع صوت الموسيقى وشكلت نغماتها سلم أخر خفي قادني مرغماً لأعلى. عند الدرجة الثانية عشر تبدد الظلام كاشفاً عن لوحة معلقة فوق الجدار. كانت لوحة كبيرة الحجم وحية الألوان لدرجة لا يمكن تصديق أنها مجرد لوحة زيتية. كانت اللوحة للعجوز الراحل قبل سنوات طويلة ربما قبل ثلاثين عاماً حين كان شاب في الرابعة والثلاثين. كان أبرز ما في ملامحه هي تلك العينان الصارمتان فوق أنف حاد وتحت حاجبين كثين. وجه صارم يصلح لأن تحمله شخصية مثالية في أحدى روايات ديكنز. إلى الجوار من العجوز الشاب كانت امرأة في مثل عمره تقريباً مستندة برأسها على كتفه وعلى شفتيها الرفيعتين ابتسامة مرحة جعلتها أشبه بأميرة إسبانية. في الخلف منهما كان مركب شراعي ينساب عبر النهر بسكون ودعة حاجباً بشراعه الأبيض جزء من الشمس المائلة نحو الغروب. كان مشهداً متقناً لزوجين عاشقين ومع هذا فقد كان ثمة شيء خاطئ يجري في كواليس اللوحة. هناك حقيقة تقول بأن لكل عمل فني رسالة خفية تقع في القلب دون أن تمر بالحواس وهي جزء من نسيجه فيما يمكن أن نطلق عليه روح العمل الفني. كانت الرسالة التي تحملها هذه اللوحة مفادها أن نهاية مأساوية في انتظار هاذان العاشقان.
مرة أخرى ارتفع صوت الموسيقى وكأنه يستعجل صعودي فانحرفت يمينا مع الدرج. افضى بي هذا الصعود المرهق إلى ممر طويل. على اليسار كان سياج منخفض من الرخام يطل على البهو وعلى اليسار كان ثلاث غرف متراصة. اتجهت مباشرة إلى الغرفة الثانية حيث كانت النغمات تصدح مخترقة بعناد بابها المغلق. شعرت بخطواتي تتثاقل وكأن حجراً ثقيلاً معلق بقدمي. من مكان ما انبعثت برودة شديدة راحت تلفح جسدي. لم تكن برودة عادية. كانت من ذلك النوع الذي يلتصق بجسدك ويرفض أن يغادره. برودة تذكرك بالموت.
تضاعف خوفي وراح يضغط بعنف على جدار قلبي المضطرب. مددت يداً مرتعشة إلى رتاج الباب وأدرته ببطء شديد. الآن ومع خطوتي الأولى داخل الغرفة راحت الموسيقى تنساب بحرية داخل أذني. اصطدمت عيني بظلمة حالكة كانت تعم المكان وما أن اعتدت تدريجياً عليها حتى بدأت الأشياء تأخذ أشكالاً محددة. كان العجوز ممدداً فوق الفراش الوثير تماماً كما رأيته في الصباح حين كنت أجري تحقيقاً حول مقتله. لم يمنعني خوفي من التقدم فقد كانت غريزتي تدفعني للأمام بأقوى مما يدفعني الخوف للخلف.
حين أصبحت على بعد خطوة من الفراش دققت النظر للحظات. اتسعت عيني رعباً وندت مني صرخة قوية تلاشت في الفراغ. لا يمكن أن يكون ما أراه حقيقي. مستحيل أن يكون حقيقي.
لم يكن العجوز هو ذلك الممدد أمامي , بل كانت نيفين.
.................................
فتحت عيني مذعوراً فعاد نهر الزمن إلى تدفقه الطبيعي. تلفت حولي ذاهلاً. لقد عادت غرفة المكتب كما كانت قبل أن أغادرها بجدرانها الرمادية الكالحة. تلاشي المشهد الذي كنت اعيشه منذ لحظات ولم يبقى منه سوي تلك البرودة المتغلغلة في نسيج الجسد. كيف يمكن ان يتصبب العرق بهذه الغزارة في شهر كديسمبر ومدينة كالإسكندرية !. كان الصداع يدق في رأسي بقوة متزامناً مع دقات الساعة التي كانت تشير إلى السادسة مساءاً. ساعة واحدة هي ما كانت تفصلني عن لقائي بنيفين.
كيف حدثت هذه النقلة في الزمان والمكان؟!
وماذا يعني تواجد نيفين في فراش ذلك العجوز ؟!.
شعرت بخوف شديد تواطأ مع البرودة في إصابتي برجفة عصفور تحت المطر. لا يمكن أن أسمح لمكروه أن يصيبها حتى لو دفعت حياتي ثمناً لذلك. قررت أن ألتزم معها الصمت حول ما حدث فليس من الحكمة أن تخبر امرأة بأمر كهذا وإلا ستتهمك بالجنون أو ستصيبها الهواجس به.
تنفست بعمق وانتظام لأعيد السيطرة على نفسي. لم يكن بئر مسعود , حيث سأقابل نيفين , يبعد كثيراً عن مقر الجريدة , ربما سيستغرق الوصول إليه ساعة على الأقدام , كما أنني كنت بحاجة ملحة لبعض الهواء الطازج لأتغلب على هذا الصداع الرهيب ولأستعيد رباطة جأشي ولبعض الوقت كي أتفكر في تلك التجربة العجيبة التي مررت بها , لذا فقد قررت أن أذهب للقائها سيراً وأن اترك سيارتي كما هي بجوار مبنى الجريدة على أن أعود لأخذها لاحقاً.
بدا واضحاً من الأبواب المغلقة والصمت الذي يلف المكان أن أغلب العاملين بالجريدة قد انصرفوا لذا لم استغرب أن أحداً لم يصادفني في طريقي إلى الخارج. عند نهاية الدهليز الطويل الذي كان سيفضي بي مباشرة إلى باب الجريدة الرئيسي مررت بالغرفة المظلمة التي كان حنفي يستخدمها في تحميض ما يلتقطه من صور. كان ضوء أحمر باهت يتسلل عبر بابها الموارب ما أصابني بالدهشة. لم تكن عادة حنفي أن يبقى إلى هذا الوقت المتأخر في العمل.
اقتربت من الغرفة والقيت نظرة داخلها. كان حنفي هناك يجلس في وسط الأجهزة والمعدات التي يزدحم بها المكان مديراً ظهره للباب ومن فوق رأسه يتصاعد دخان سيجارته مشكلاً لوحة سريالية غامضة وكئيبة.
" حنفي ؟! "
ساعده مقعده الدوار على أن يلتفت نحوي مجفلاً.
" مرحباً أستاذ فريد ".
" ماذا تفعل هنا في هذا الوقت ؟! "
هز كتفيه بملل " لقد طلب مني رئيس التحرير أن انتهي من بعض الصور الهامة التي سوف تنشر في الجريدة غداً. لذا كان علىَّ أن أبقى. "
" أسمع يا حنفي. هل جربت من قبل الـ .. كيف أصف الأمر " سكت للحظات بحثاً عن الكلمات المناسبة " الانتقال اللحظي. أعني أن تجد نفسك فجأة وقد انتقلت من هذه الغرفة إلى مكان آخر في زمان آخر. "
" تقصد مثل أن يبتلعك ثقب أسود غير مرئي ؟! " قال وهو يرميني بنظرة ريبة.
" حسناً. شيء كهذا. "
انطلقت منه ضحكة مجلجلة لم تجد في أسنانه البنية المتآكلة عائق قوي.
لوحت بيدي في الهواء ندماً " لا عليك. "
شعرت بنظراته الساخرة والمتشككة تتشبث بكتفي من الخلف.
لأيام طويلة قادمة سيبقي حنفي يشكك في قدراتي العقلية. من المؤكد أن هذه كانت اللحظة الأولى التي يرميني فيها بالجنون.
|








 جديد مواضيع قسم المنتدى العام للقصص والروايات
جديد مواضيع قسم المنتدى العام للقصص والروايات




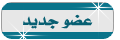






 العرض العادي
العرض العادي



